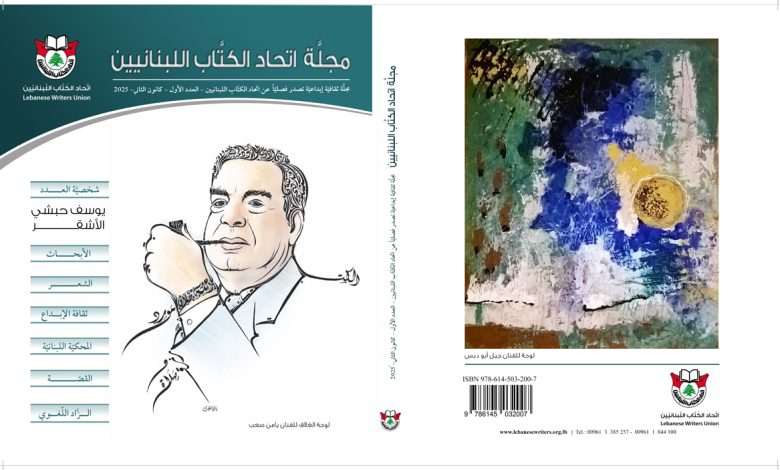
الزَّواج والمُصاهرة بين مُسْلمي الأندلس ومسيحيِّها من لَدُن الفتح العربي الإسلامي حتّى السقوط
أ. د. يوسف علي طويل
قَبْلَ الشُّروع في الحديث عن ظاهرة الزَّواج والمُصاهرة بين المسلمين والنصارى، التي عَرَفَها المجتمعُ الأندلسي على امتداد ثمانيّة قُرُون، بَدْءًا بعصر الوُلاة وانتهاء بسقوط غرناطة (92- 897ه/711- 1492م)، يَجْدُرُ بي أن أُجْمِلَ ما كانت عليه إسبانيا قبل الفتح العربي الإسلامي، من الناحيتين السياسيّة والاجتماعيّة، فأقول: كانت إسبانيا قبل دخول العرب والمسلمين فاتحين، تعاني الكثير من المشاكل السياسيّة والاجتماعيّة، إضافة إلى الضرائب التي كان يَفْرِضُها القُوطيُّون على الإسبان ويُرْهِقون بها المجتمع الإسباني بطبقاته الثلاث: الأرستقراطيّة، والوسطى، والدُّنيا، ما أدّى إلى التفكُّك السياسي وسوء استعمال السلطة من جهة، وإلى النَّقمة الشعبيّة من جهة ثانيّة، الأمر الذي شجَّع العرب على فتح تلك البلاد، بعد أن وصلت جيوشهم في الفتوحات إلى الهند شرقاً، وشواطئ المحيط الأطلسي غرباً.
ومن الطبيعي، بعد الفتح، أن تتصِّل عناصر المجتمع الأندلسي ببعضها بعضاً عن طريق الحرب أو الجوار أو المصاهرة والزواج، فيأخذ كل عنصر من غيره ويُعطيه، ما كان أثره في مزج العقلِيّات المختلفة. فالمجموعات البشريّة غير المتشابهة، وفي مقدِّمتها العربُ العنصرُ الأساسيُّ في المجتمع الجديد، ما لبثت أن انْصَهَرَتْ معاً في هذا المجتمع، فَجَنَتْ ثمار المشرق علما وثقافة وفنوناً ومعرفة، ثم أبدعت وكوَّنت حضارة أندلسيّة رائعة أخذت معالمها تنتقل إلى إسبانيا عن طريق الزواج أو الاختلاط، وعن طريقها انتقلت إلى قلب أوروبا.
إِنَّ مِن أبرز ما يستوقف أي مطَّلعٍ على ظاهرة زواج المسلمين من إسبانيّات، ولا سيَّما في بدايّات الفتح، زواجَ أوّل حاكم أندلسي هو عبد العزيز بن موسى بن نُصَيْر، الذي وُلِّيَ الأندلس بعد أبيه موسى، ثم حَذا حَذْوَهُ عدد لا بأس به من حكّام الأندلس.
إنَّ اختلاط عناصر الأندلس في مجتمع واحد من شأنه أن يَخْلُق جَوَّاً من الألفة، بحيث يأخُذُ كُلّ عنصر من الآخر ويُعطيه، وذلك عن طريق الجِوار والولاء والتَّزاوج والمصاهرة… وكان العرب أكثر هذه العناصر اتِّصالا بالسُّكّان الأصليِّين؛ فتزوّجوا من بناتهم، فنشأ في المجتمع الأندلسي جيل جديد فيه دماء المشارقة وسِمات أهل البلاد(1).
كان زواج المسلمين من إسبانيّات قد فاق بكثير زواج الإسبان من مُسْلمات، وتلك ظاهرةٌ اجتماعيّة تبيَّن مدى التأثير الإسباني في عقول وعواطف عرب الأندلس ومسلميها(2). وقد أقدم الفاتحون على الزواج من إسبانيّات منذ أن وَطِئَتْ أقدامهم تلك البلاد؛ لأنَّهم عندما دخلوها لم تكن معهم نساؤهم، فدخلوها على هيئة جنود، ولم ينتقلوا إليها كأُسَرِ تَصْحُبُهُم زوجاتهم وعيالهم. كذلك فإنّ جمال الإسبانيّات الباهر فتنهم، فجعلهم يكثرون منهن.
وقد تكون الزوج من خارج المجتمع الأندلسي، أي من إحدى الممالك الإسبانيّة المتاخمة للأندلس من جهة الشِّمال، إذ كانت المصاهرة مألوفة على مختلف المستويّات بين الأندلس والممالك الإسبانيّة الشماليّة. ولربمَّا أسهمت هذه المصاهرات إلى حَدٍّ ما في توطيد عَلاقات الجِوار بين الأندلس وحكّام الشمال الإسباني في شبه الجزيرة الإيبيريّة(3). وكان ذلك الزواج أَحْسَنَ صلة لامتزاج الفاتحين بخصومهم، والتحام القرابة بينهم على نحو لا تنفَصِمُ عُراه، وأصبح ذلك الوافد جديراً بأن يُسمّى بين عشيّة وضُحاها صِهْراً ونسيباً(4).
وهكذا أخذ العرب والبربر يرتبطون بعلاقات المصاهرة مع أهل البلاد؛ لأنَّهم كانوا يعتمدون في بقائهم في إسبانيا وترسيخ أقدامهم فيها، على تناسلهم وكثرة التابعين لهم. وقد حَدَّد لنا غوستاف لوبون عدد النِّساء اللواتي تزوّجنَ من عرب في بدايّات الفتح فقال: “إنَّ العرب تزوّجوا في بَدْء الفتح ثلاثين ألف نصرانيّة… إنّ هؤلاء النَّصْرانيّات
كُن من مختلف الأجناس وإنَّه كان يجري في عروقهنَّ الدم الإيبيري واللاتيني واليوناني والقُوطي… إنَّه نشأ من توالد النصارى والبربر والعرب، الذي دأم في بيئة واحدة قروناً كثيرة، عِرقٌ جديد مختلف عن العُرُوق التي فَتَحَتْ إسبانيا”(5).
وقد أنجبت تلك الإسبانيّات لأزواجهنَّ العرب أولاداً اعْتَلَجَ الدم في عُرُوقهم الشرقي والغربي؛ فكانت لهم عاداتٌ وطباعٌ يختلفون فيها عن عرب المشرق، ويقتربون بها من النصارى الإسبان(6). وهكذا نشأت الخُؤولةُ العجميّة في مقابل العُمُومة العربيّة، فكانت نزعة العروبة متأصِّلة في كيان العرب، وهي تزداد تَبَعاً لازدياد درجة الوعي القومي عندهم(7). وكان هؤلاء الأبناء يتكلَّمون لغة أمهاتهم الإسبانيّات، وهي اللغة الرُّومَنثِيّة التي عُرفت بين المؤرِّخين العرب باسم اللَّطِينيّة أو اللاتينيّة، وكان بعض حكّام الأندلس من بني أميّة يعرفونها، وفي مقدمتهم عبد الرحمن الناصر، إذ كان حفيد سيدة نافاريّة(8).
كان العرب بعد الزواج يَعْمِدُون إلى بَثَّ تعاليم الإسلام في نفوس زوجاتهم المَسِيحيّات، فَيُؤثِرُ هؤلاء الدِّين الإسلامي على غيره من الأديان، وتُضْحي العلاقات وثيقة بين العرب والإسبان على أثر الاختلاط والزواج، لذا لم يَبْقَ بين أكثر العرب من لا يجري في عروقه دم إسباني، وهذا التَّزواج قد كَثُرَ في المدن ولا سيَّما زمن الخلافة الأمويّة.
وقد أبدى الأدهمي رأيه في زواج المسلم بغير المسلمة فقال: “إنَّ تزوّج الرجل المسلم بغير المسلمة جائز شرعاً، ولكن ليس كُلُّ ما جاز شَرْعًا وَجَبَ فعله، والمقصود هو بيان الحُكْم لمن ابتلي بمثل ذلك عند الإنجاب وحصول النَّسلْ؛ فالأولاد يتبَعُونَ أمهاتهم في الأخلاق والعادات والطباع(9). وأضاف: “من تزوّج بغير مسلمة اكتسب ثواباً؛ لأنَّ في ذلك وسيلةً لإسلامها، وقد ورد ذلك في الأحاديث النبويّة الشريفة، وأي ثواب أعظم من ثَواب مَنْ سعى في خلاص نفس من عذاب النار الأبدي(10)؟”
بالإضافة إلى ذلك، فإنّ نسبة الجمال، التي وجدها العرب في بلاد الأندلس، لم يجدوا مثلها في أي بلد آخر. لقد كان حَظُّ الأندلس من الجمال البشري كبيراً؛ لحظِّ بيئتها من الجمال الطبيعي، لذا قرروا الزواج طالما ستطول إقامتهم في تلك البلاد، ولسان حالهم يقول(11)(الطويل):
ونحن بنو الدُّنْيا وهُنَّ بَناتُها
وعَيْشُ بَنِيها في لقاء بناتها
ولكنَّ زواج العرب من إسبانيّات لم يقتصر على الجنود، بل تَعَدَّاهم إلى الحكّام، وسوف أقتصر على ذِكر من تزوّج من الحكّام من إسبانيّات، وبعض مَن تزوّج من عِلْيّة القوم منهنَّ؛ لأنّني لو أردت تِعْداد أسماء من تزوّج من هؤلاء من إسبانيّات، وبخاصَّة من قَيْنات، لَطالَ بي المقام، إذ يحتاج ذلك وحْدَهُ إلى دراسة مستقلَّة بذاتها.
إنَّ أوّل من تزوّج من حكّام الأندلس من إسبانيّة، في أواخر القرن الأوّل الهجري/ أوائل القرن الثامن الميلادي، والي الأندلس عبد العزيز بن موسى بن نُصَيْر (95- 97ه/ 713- 715م)؛ إذ نَكَحَ أيْلُه Egilona أرملة رذريق آخِرِ ملوك القُوط في إسبانيا، التي تسَمَّتْ أم عاصم، وسكن معها بالحاضرة إشبيليّة(12) في كنيسة رُبينة أو رُفينة، التي ابتنى على بابها المسجد الذي عُرِفَ بمسجد رُبينة أو رُفينة، المُشرِف على مرج إشبيليّة، والذي قُتِلَ فيه؛ قتله الجُنْدُ عندما رأوه قد وضع على رأسه تاجاً من الجوهر والذهب، فقالوا: قد تَنَصَّرَ، فهجموا عليه وقتلوه، وكان قتْلُه صَدْرَ رجب من سنة 97ه- 715م وقيل: في آخر سنة 98ه/ 716م، ويقال: قتلوه بأمر الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك، الذي نَكَبَ أيضاً والدَه موسى بن نصير(13).
وذهب أحمد أمين إلى أنَّه لا يُعقَلُ أن يكون عبد العزيز قد تنَصَّرَ من أجل امرأة؛ وذلك لكونه والياً كبيراً وابنَ فاتح عظيم من جهة، ومن جهة أخرى؛ لِكَوْنِ المسلمين في الأندلس اشتهروا بعصبيَّتهم لدينهم وصعوبة تحوُّلهم إلى غيره، وهذا في العامة، فضلا عن الخاصَّة(14). وأنا أقول: إذا كان عبد العزيز قد انجرَّ إلى عواطفه، يكون قد طبَّق ما قاله ابن قيِّم الجَوْزِيّة: “وكم من عاشق أتلف في معشوقته ذاته وعِرْضَه ونفسه، وضيّع أهله ومصالح دينه”(15). ثمّ إنّ حكايّة أنّهم قتلوه؛ لأنّه تنَصَّر، لا تصِحُ، وإنّما قتلوه بأمر من سليمان بن عبد الملك، إذا نكَبَ والدَهُ موسى بن نصير؛ لأنّه رفض أوامره عندما كان قادماً من الأندلس إلى الشأم ومعه تيجانُ الذهب(16).
وحذا بعض وجوه العرب حَذْوَ عبد العزيز بن موسى بن نصير؛ فقد روى صاحب “أخبار مجموعة” أنَّ زياد بن نابغة التَّميمي تزوّج إحدى بنات الملوك الإسبان، فدخلتْ على عبد العزيز بن موسى بن نصير، فرأته والتاج على رأسه، فطلبت من زوجها زياد أن يعمل لها تاجاً، أُسْوَةً بوالي الأندلس عبد العزيز بن موسى بن نصير، فأعلمها أنَّ دين الإسلام ليس فيه استحلال لباس التاج، فأخبرته بأنَّ التاج على رأس والي الأندلس عبد العزيز، فأعلم زياد عندئذ حبيب بن أبي عبيدة بن عُقبة بن نافع، ثم تحدَّثا بذلك حتَّى عَلِمَهُ خِيارُ الجُنْد، فهجموا على عبد العزيز وقتلوه في عقب سنة 98هـ/716م(17).
كذلك تزوّج منوزا البربري المسلم، حاكمُ ولايّة البرنيه الغربيّة، في عهد والي الأندلس عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي (112-114هـ/732-730م)، ابنةَ أود Eudes دون أكيتين Aquitaine (جنوب فرنسا) واسمها لمبيجيه Lampégie، إذ كان منوزا على عَلاقات طيِّبة مع الدُّوق، فعقد معه تحالفاً سِرِّيّاً إلى هذا الزواج. وكانت لمبيجيه غايّة في الجمال، إذ كانت توصف بأنَّها أجمل امرأة في عصرها(18).
وتزوّج عيسى بن مزاحم سارةَ القوطيّة بنت ألمند بن غيطشة Olmundo Witiza (غيطشة آخر ملوك القوط)؛ أنْكَحَها إيّاه الخليفة المشرقي هشام بن عبد الملك (105- 125ه/723- 742م) عندما قَصَدَتِ المشرق ووقفتْ بباب الخليفة هشام مُتَظَلِّمَةً من عَمِّها أرطباش بن غيطشة، إذ كان قد بسط يده إلى ضِيَعها بإشبيليّة، فَقَدِمَ معها عيسى الأندلسَ وقبض ضياعها، ووُلِدَ له منها ولدان هما: إبراهيم وإسحاق، وهو جَدُّ المؤرِّخ أبي بكر محمّد بن عمر، المتوفّى سنة 367هـ/977م، صاحب كتاب “تاريخ افتتاح الأندلس”(19).
وبفضل تزاوج العرب من إسبانيّات، أصبح عددهم بعد عشرين سنةً من فتح الأندلس ثلاثمائة ألف(20). ولمّا كان ورود العرب إلى الأندلس قليلاً، نظراً إلى بُعدْ المسافات بين الأندلس وبلاد العرب، أخذ الدم العربي الصريح يتلاشى في بلاد الأندلس، ولم نَعُدْ نجد عند قيام الأمارة الأمويّة عربيّاً صريحاً إلّا في حالات نادرة(21). وبمعنًى آخر، فإن أمراء بني أميّة وخلفاءهم لم يكن منهم من كانت أمه حُرَّة، إذ كانت أمهاتهم من نصارى الشمال الإسباني، أو من رقيق الصَّقْلَب، أو من البربر… وكانت أمهات بعضهم أمهات أولاد، بمعنى أنهنَّ كُنَّ قَيْناتٍ، وعندما يَلِدْن تسقط عَنْهُنَّ صفة “أم ولد”.
وكان بَعْضُ حكّام الشمال الإسباني يَحُثُّ المسيحيّات على الزواج من مسلمين؛ يذكر ليفي- بروفنسال أنّ مورغاتو Mauregato الذي استقلّ ببرافيا Pravia حاضرة جليقيّة Galicia، وتُوفّي سنة 789م/173هـ، كان يُشجِّع بحماسة كبيرة زواج الفتيّات المسيحيّات من مسلمين، ولكن دعوته تلك لم تَلْقَ النجاح المطلوب(22).
ومع الزمن توالت المُصاهرات؛ يروي ابن الدَّلائي أنَّ أهل وِشْقَة Huesca استدعوا مطرّف بن موسى المُوَلَّدي، فدخل وِشْقَة واستقلَّ بها في سنة 258هـ/871م في عهد الأمير محمّد بن عبد الرحمن الثاني، وتزوّج فليشكيطة Velasquita ابنة شانجه Sancho صاحب بنبلونة، واستجلبها إلى وِشْقَة، وابتنى بها، ورأت من أهل وِشْقَة استخفافاً بزوجها وقلّة طاعة له، فَحَثَّته على معاقبتهم، فعمل مطرِّف برأيها، فكايدهم وقتلهم، فشعروا لذلك وتحفظَّوا منه(23).
وقد أشار ابن حيّان إلى هذا الزواج، ولكنَّه اختلف في إشارته عَمّا ذكره ابن الدَّلائي، فذهب إلى أنّ زوج مطرِّف هي بنت غرسيّة بن ونقه Garcia Inigo، صاحب بنبلونه، دون أن يُسمِّيها؛ يروي أنَّ عمروس بن عمرو بن عمروس المُوَلَّدي، كاتَبَ أهْلَ مدينة وِشْقة Huesca، وحثَّهم على مطرِّف بن موسى، وخوَّفهم غَدْره، فاستجابوا له، فدخل عمروس وشقة، وأسر مطرِّفاً وقبض على زوجه بنت غرسيّة بن ونقه، صاحب بنبلونه، فملكها، وملك، مدينة وشقة(24).
وروي أيضاً أنّ الوزير أبا غالب تمّأم بن عامر ابن علقمة، المتوفّى سنة 283هـ/ 896م، وصاحب الأرجوزة المشهورة في ذكر فتح الأندلس، تزوّج أم الوليد بنت خلف بن رومان النصرانيّة، فجاء من نَسْلِها الوزير الكاتب عيسى بن فطيس، فتمّام جَدُّه لأمه(25). وأُعْجِبَ ابن حيّان بجمالها فقال فيها: “وكانت أم الوليد بارعة الجمال، سَبّاءة للألباب، فرآها تمّام، فَعَلِقَها وهام فيها، فانقاد لهواه في نكاحها، فكان أعداؤه يَعِيبونه بها، ومن قوله فيها لما عُذِلَ في نكاحها (الطويل):
“يُكَلِّفُني العُذّالُ صَبْرًا على التي
أبى الصَّبْرُ عنها أن يَحُلُّ مَحَلَّها
إذا ما وَزَعْتُ النَّفْسَ يَوْمًا فَأَبْصَرَتْ
سَبِيلَ الهدى عاد الهوى فأَضَلَّها
وكم مِنْ عَزِيزِ النَّفْسِ لَم يَلْقَ ذِلَّةً
أقاد الهوى مِنْ نَفْسِهِ فَأَذَلَّها
عَجِبْتُ لِمَشْغُوفٍ على الحُبِّ نَفْسَهُ
يُكَلِّفهُ عُذَّالُهُ أَن يَسُلَّها”(26)
وتزوّج الأمير عبد الله بن محمّد (275- 300 هـ/ 888- 912م) إينيغا بنت فرتون غرسيّة Iniga Fortin Garcia، المعروف بالأنقر El Ankar؛ إذ كانت من قَبْلُ متزوّجة من الأمير النافاري أزنار بن شانجه Aznar Sanchez، وأنجبتْ له طودا Toda الوَصِيّة على عرش نافارا Navarra. وفي زواجها الثاني من الأمير عبد الله أنجبت له محمّداً أبا الخليفة عبد الرحمن الناصر، ويكون محمّد المذكور أخا لطودا من جهة الأم، وبالتالي تكون طودا عمّة عبد الرحمن الناصر، حفيد إينيغا النافاريّة(27). وإينيغا، أم محمّد بن عبد الله وجَدَّةُ عبد الرحمن الناصر، هي نفسها “دُرّ” التي ذكرها ابن عِذاري عند حديثه عن أولاد الأمير عبد الله بن محمّد: “مِمَّنْ وُلِدَ له قَبْلَ الخلافة محمّد أبو أمير المؤمنين عبد الرحمن بن محمّد، رحمهما الله، أمه (أي أم محمّد) دُرّ، وأحمد، أمه: تمام…”(28).
وذهبَ عبد الرحمن الحجّي، إلى أنَّ عبد الرحمن الناصر (300- 350ه/ 912- 916م) ابن جارية إسبانيّة تُسميها الروايّة الأندلسيّة “مزنة”، ولعلَّ اسمها في الأصل “ماريا” Maria(29). والروايّة الأندلسيّة التي يشير إليها الحجّي هي روايّة الحُمَيْدي التي يقول فيها في ترجمة عبد الرحمن الناصر: وكان يُكْنى أبا المطرِّف، وأمه أم ولد، اسْمُها مزنة”(30). وهي نفسها روايّة الضَّبّي(31). وقد تكون روايّة ابن عِذاري التي يقول فيها أيضاً في ترجمة عبد الرحمن الناصر: “لقبه: الناصر لدين الله، أمه: أم ولد، تسمّى مزنة”(32).
ويروي ابن حيّان أنَّ عبد الرحمن الناصر تزوّج الجارية مَرْجان، فأنجبت له ولده البِكْرَ الحكم المستنصر، فرقّاها فوق مرتبة نسائه، وسمّاها السَّيِّدة الكبرى دونهنَّ، وذلك عندما اتَّضَعَتْ لديه منزلة حُرَّته القرشيّة فاطمة بنت أخي جدِّه الأمير المنذر بن محمّد، وتفرَّدت مرجانُ بالأَثَرةَ والقيادة بعد فاطمة، وكانت من السُّرِّيّات المُفَضِّلات على نسائه؛ لما أُوتِيتْ منَ الفَطانة والحلاوة وجمال الصورة وعذوبة المنطق وملاحة الإشارة أفضل ما أوتيته أنثى(33). وأغلب الظَّنِّ أنَّ مَرجانَ جارية إسبانيّة، وقد ذكرها الحُمَيْدي في ترجمة الحكم المستنصر، فقال: “يُكنى أبا العاص، أمه أم ولد اسمها مرجان”(34). ومِثْلَه قال الضبّي في ترجمة الحكم المستنصر أيضاً(35). وذكرها ابن عِذاري في ترجمة الحكم المستنصر باسم “مهرجان”، فقال: “كنيته: أبو المطرِّف، أمه: اسمها مَهْرجان“(36) وذكرها المقَّري عندما تحدَّث عن قَصْدِ عبد الرحمن الناصر، باسم “مرجانة” فقال: “… فَذُكِر له أن السَّيِّدة الكبرى مَرْجانة أم ولده وَلِيِّ عهده الحكم المستنصر(37)”.
وتزوّج الحكم المستنصر (350- 366هـ/ 960-976م) الجارية البشكنسيّة Aurora، وهي اسم إسباني يعني “الفجر”، ولذا أسْمَوْها في المصادر العربيّة صبحاً(38). يروي ابن عِذاري أن صُبْحاً هذه كانت أم ولد، وكان سَيِّدُها الحكم المستنصر يُسَمِّيها جَعْفَرَ، وكانت مغنِّيّة حَظِيّة عنده، وقد وَلَدَتْ له هشاماً، وتُوفِّيَتْ في خلافة ابنها هشام(39). وفي ترجمة عبد الرحمن ابن المنصور محمّد بن أبي عامر، يشير ابن عِذاري إلى أنَّ كُلّاً من أم عبد الرحمن وهشام المؤيَّد بَشْكَنْسِيّة: “إذا كانت أماهما بَشَكَنْسِيتَين”(40). وروی ابن الخطيب أن الحكم المستنصر بُشِّر يوماً في خَلْوَته باشتمال جاريته صُبح على حَمْلٍ، وكان الحاجب جعفر بن عثمان المُصْحَفيّ بين يديه، فأنشده بديهة(41): (الوافر)
هنيئًا للإمام ولِلأَنام
كَرِيمٌ يَسْتَفِيدُ على كِرأم
أضاء على كريمته ضِياءَ
فلم تَعْلَمْ بِغاشيّة الظَّلام
ولِمْ لا يُسْتَضاءُ بجانبيها
وبين ضُلُوعها بَدْرُ التَّمام؟
وأضاف: وَلَدَتْ صُبْحٌ من هذا الحَمْل هشام بن الحكم، واتَّفق أن حضر جَعْفَرُ المُصحَفِيُّ عند الحكم ساعة أتاه البشيرُ بولادة هشام، فقال في ذلك(42): (مخلَّع البسيط)
اِطَّلَعَ البَدْرُ مِنْ سَحَابِهِ
وَاطْرَدَ الـسـيـف مـن قــِرابِـِه
وجاءنا وارث المَعالي
لِيُثْبِتَ المُلْكَ في نِصابِهِ
بَشَّرنا سيّدُ البَرايا
بِنِعْمَةِ اللَّهِ فِي كِتَابِهِ
وذكر ابن سعيد صُبحاً في ترجمة هشام المؤيَّد (366-403هـ/ 976-1013م) مكتفيا بالقول: “وكانت أمه صبحٌ هي التي أظهرت المنصور بن أبي عامر، ويقال: إنَّها أَرْضَعَته”(43).
وأدت صُبْحٌ دوراً بارزاً في تاريخ الأندلس، وكانت، كما يقول أحمد أمين: “ذات شخصيّة قويّة، استطاعت أن تَبْسُطَ سلطانها على زوجها الحَكَم، وتتدخل في شؤون الدولة، مع قوَّته وعظمته(44).
وتزوّج المنصور محمّد بن أبي عامر، حاجِبُ الأندلس في عهد الخليفة الصبي هشام ابن الحكم، المعروف بهشام المؤيَّد بالله، من البَشْكَنْسِيّة عبدة بنت شنجه بن غرسیَّة Sancho Garcia، فأنجبت له عبد الرحمن، الملقَّب بشنجول Sanchuelo، تصغیر شانجه Sancho، حسبما يقول ابن عِذاري في ترجمة عبد الرحمن بن المنصور محمّد بن أبي عامر: “عبد الرحمن الملقَّب بشنجول، اسم غَلَبَ عليه من قبل أمه عبدة بنت شنجه النصراني الملك، تذكراً منها لاسم أبيها، فكانت تدعوه في صغره بشنجول، وكان أشبه الناس بجده شانجه(45)…” وعند حديثه عن الفتنة البربريّة التي وقعت بقرطبة سنة 399هـ/ 1008م في عهد الخليفة هشام المؤيَّد، يشير ابن عِذاري، نقلا عن ابن حيّان، إلى أن أم شنجول من البشكنس: “إذ كانت أمـاهـمـا بشكنسيتين(46)… وهذا يعني أنّ أم هشام هي صُبحٌ وأنّ أم شنجول هي عبدة. وفي ترجمة المنصور بن أبي عامر يشير ابن الخطيب إلى هذا الزواج دون أن يذكر اسم عبدة فيقول: “وأَلَحَّ على ملوك قشتالة بالغزو والإضافة… حتّى لقد تقرَّب إليه بعضهم بإهداء ابنته، فقبلها المنصور أحسن قبول، وتزوّجها، وحَسُنَ إسلامها، وكانت من خيرات نسائه دينًا متيناً وحَسَباً أصيلاً. وأوّلد منها ولده عبد الرحمن الملقَّب من أجل ذلك شنجول من أسماء خُؤولته. ولم تزل الأيّام حتّى وَرَدَ أبوها المَلِكُ على بابه زائراً ومستصرخاً، فخرج عبد الرحمن بن المنصور، حفيد الملك الوارد، ابن ابنته، إلى لقائه بالجيوش والأبهة المفخمة، طفلا يرقد في السَّرْجِ، فَنَزَلَ جَدُّه إليه، وَقبَّل رِجْله ویده(47). ويضيف: “ثُمَّ واصل المنصور الغزو بنفسه وولده ورجاله على شانجه ملك النصارى، حتى أذعن لائذاً بعفوه، واستأذنه في القدوم عليه بنفسه، فأذن له، وسُرَّ مجيئه سرورًا ما سُرَّ قط بمثله، فتقدم من الاستعداد له واستحضار طبقات الأوّلياء، فوصل لثلاث خَلَوْنَ من رجب سنة 382. وأَرْكَبَ المنصور الجيوش والمُطوّعة لتلقيه في دخوله إلى قصر الزاهرة، فكان يومه أحد أيّام الدنيا الشهيرة… ولقيه ولد المنصور عبد الرحمن حفيده من ابنته، كما قَدَّمنا ذكره، وقد حَفَّ به وزراء السلطان ووجوه القواد وأكابر أهل الخدمة والمماليك، وفي أحسن زي وأكمل تعبئة. فلما وقعت عينه على الصبي ترجل وباس رجله، وأقبل معه إلى أبيه(48). وكان شانجه، جد شنجول، يقول ابن الخطيب نفسه، يُعرف برِيّ قَرَجُه Rey Abarca(49). وفي ترجمة المنصور محمّد بن أبي عامر، يشير ابن الأبّار إلى هذا الزواج مكتفياً بالقول: “حتى أذعن له ملوك الروم ورغبوا في مصاهرته…(50)“. وتحدث حسين مؤنس عن هذا الزواج، فذكر أن أم عبد الرحمن شنجول، الأميرة بنت ملك نافارا Navarra شانجه الثاني بن غرسيه الأوّل Sancho Garcia بن شانجه الأوّل، الملقَّب بأباركا Abarca، أسلمت بعد زواجها بالمنصور وتسمت عبدة، وأنجبت له عبد الرحمن نحو سنة ٣٧٤هـ / ٩٨٤م، وأطلقت على ابنها تدليلاً شنجول Sanchuelo، وهو مصغر اسم أبيها شانجه Sancho. وأَعْقَبَ هذا الزواج هدنةٌ بين قرطبة والبشكنس، وأقبل شانجه في زيارة رسميّة لصهره المنصور في قرطبة في رجب (382هـ/ أيلول 992م)(51) . وكذلك قال ليفي بروفنسال، ولكن دون أن يذكرها بالاسم: “وسيتزوّج الوَصِيُّ المنصور إحدى بنات ملك نافارا سانشو الثاني، وسيدعها تطلق على ابن علاقتهما الاسم الروماني المتدأوّل سانشويلو Sanchuelo، حفظا لذكرى والدها“(52). وتحدث عبد الرحمن الحجّي عن هذا الزواج، معتمدا في ذلك على ما رواه ابن الخطيب(53). كما أشار السَّيِّد عبد العزيز سالم إلى هذا الزواج، محدداً بنبلونة حاضرة مملكة شنجه: … عبد الرحمن بن المنصور، الملقَّب بشنجول، وشنجول تصغير لشانجه، وقد لُقِّب عبد الرحمن بهذا اللقب بسبب أمه عبدة بنت شانجه النصراني ملك بنبلونة Sancho Garcia Abarca، فقد كان هذا الملك قد أهدى ابنته للمنصور فتزوّجها وحَسَنَ إسلامها(54)…”
وروى ابن خلدون خَبَر زواجٍ آخَرُ للمنصور من ابنة قومس غليسيّة مَسَدٌ Galicia بن عبد شلب فقال: إن مسَدًّا بَعَثَ ابنته للمنصور سنة ثلاث وثمانين (وثلاثمائة) وصَيَّرَها جارية له، فأعتقها وتزوّجها…”(55).
ويبدو أن هناك زواجًا ثالثاً للمنصور ابن أبي عامر، أشار إليه محمّد عبد الله عنان وعبد الرحمن الحجّي وهو أن برمودو الثاني Bermudo II، ملك ليون Leon: قدم ابنته تريسا Teresa إلى المنصور العامريّ عروساً له، عندما طلب برمودو من المنصور أن يعاونه على مقاومة الأشراف الخارجين عليه وتوطيد عرشه(56).
هذه الأمثلة من الزواج المختلط كانت قاصرة على طبقة الحكّام والقادة فقط، ولكن هناك مثيلات في المستويّات الشعبيّة؛ لأن الناس كما يقال، على دین ملوكهم. وقد أورد عبد الواحد المرّاكشي عند حديثه عن المنصور محمّد بن أبي عامر، نصاً يبين مدى انتشار زواج العربي أو المسلم من الإسبانيّة، يقول: “وملأ (أي المنصور محمّد بن أبي عامر) الأندلس غنائم وسبياً من بنات الروم وأولادهم ونسائهم… وفي أيّامه تغالى الناس بالأندلس فيما يُجَهِّزون بناتهم من الثياب والحُليِّ والدُّور؛ وذلك لرخص أثمان بنات الروم، فكان الناس يُرَغِّبون في بناتهم بما يُجَهِّزونهنَّ به ممّا ذكرنا، ولولا ذلك لم يتزوّج أحدٌ حُرَّةً، بلغني أنه نُودي على ابنة عظيم من عظماء الروم بقرطبة وكانت ذات جمال رائع، فلم تساو أكثر من عشرين ديناراً عامريّة (57).
وقد أجرى خوليان ريبيرا إي تراغو تجربة على الأسرة الأمويّة التي حكمت في الأندلس، بدءًا بالأمير عبد الرحمن الأوّل، وانتهاء بالخليفة هشام المؤيَّد، فتوصل إلى نتيجة وهي أن نسبة الدم العربي كانت تتناقص كُلَّما مضى من أمير إلى آخر، وأن نسبة الدم الإسباني كانت بالمقابل تتضاعف(58).
ولكنّ هؤلاء العرب والمسلمين، برأي أحمد هيكل، وإن تزوّجوا من إسبانيّات وأنجبوا جيلًا من الأندلسيِّين امتزجت في عروقهم الدماء العربيّة المسلمة بالدماء الإسبانيّة، يَبْقَوْنَ عَرَباً في عقيدتهم وثقافتهم ولغتهم وفي جوانب حضارتهم، وإذا كانت لهم بعض خصائص الإسبان في الشكل أو في الطبع، فإن لهم جُلَّ خصائص العرب فيما وراء الشكل والطبع، وتراثهم عربيٌّ يأخذ مكانه بين تراث العرب على مرِّ العصور(59).
وفي عصر ملوك الطوائف، استمرت ظاهرة زواج الحكّام من النصرانيّات، ومن ضمنهنّ الجواري الحسناوات، إذ كان بعض الملوك يمتلك منهن العشرات بل المئات؛ يروي ابن يسّأم، نقلا عن ابن حيّان، أن المعتضد بن عبّاد، صاحب إشبيليّة (433- 461ه/ 1041- 1068م)، كان ذا كلف بالنساء، فاستوسع في اتخاذهنَّ، وخلط في أجناسهن، فانتهى في ذلك إلى مدى لم يبلغه أحد. من نظرائه الملوك، فقيل: إنَّه خَلَّف من صنوف السَراريِّ منهن خاصةً نَحْوا من سبعين جارية، إلى جانب حرته المحظيّة لديه بنت مجاهد العامريّ، أُخْتِ علي بن مجاهد العامريّ، أمير دانيّة والجزر الشرقيّة ميُّورقة ومِنُورقة ويابسة بعد أبيه مجاهد، ففشا نَسْلُه لِتَوَسعه في النِّكاح وقوّته عليه، فَذُكر أنّه كان له من ذكور الولد نحو عشرين ومن الإناث مثل ذلك(60).
ويروي ابن الأبّار أنّ المعتمد بن المعتضد بن عبّاد (461- 484هـ/ 1068 – 1091م) خُلِعَ سنة 484هـ عن ثمانمائة امرأة؛ أمهات الأولاد، وجواري المُتْعة، وأماء تصرّف. وكانت وفاته في شهر ربيع الأوّل سنة 488هـ/1095م(61). ويضيف: أكثرهنَّ حُظوَةً عند المعتمد جاريته الغالبة عليه وتسمّى اعتماداً ، وتُكنى أم الربيع، وتُعرف بالسَّيِّدة الكبرى، وقد لقبت بالرُّميكِيّة نسبة إلى مَوْلاها رُمَيْك بن حجّاج، ومنه ابتاعها المعتمد يوم كان بشلب Silves عاملاً لأبيه المعتضد، وكان المعتمد مفرط الميل إليها حتى تلقَّب بـ “المعتمد”؛ لينتظم لقبه حروف اسمها، وقيل: إن المعتضد غاضه ما بلغه من غلبتها على ابنه المعتمد أوّل ما اشتراها، ولما وَلَدَتْ له عبّاداً رقّ له المعتضد، وقد أنجبت له، إضافة إلى سراج الدولة عبّاد أكبر إخوته، الراضي أبا خالد يزيدَ، وأبا نصر المأمون الفتح، والرشيد أبا الحسين عبيد الله، والمُعتدَّ أبا بكر عبد الله، وتاجَ الدولة أبا سليمان الربيع، وزَينَ الدولة أبا هاشم المعلّى، وتوفِيَّت بأغمات قبل المعتمد(62).
وقد روى ابن خَلِّكان هذه الروايّة، أي خَبَرَ اقتناء المعتمد زَوْجَهُ الرُّمَيْكِيّة، وقال: إنَّها تُوُفِّيَتْ بأَغْماتَ قبل المعتمد بأيّام(63). كذلك ذكر ابن الخطيب هذا الخبر، وقال: نُسبت اعتماد الرميكيّة إلى مولاها رميك بن فلان(64).
وإلى جانب اعتماد، كان عنده جَوارِ أُخَرُ كان لَهُنَّ عنده الحُظْوَةُ نَفسُها، وهُنَّ سِحْر، وجوهرة، وأم عبيدة، وقمر، ووداد. وكُنَّ هؤلاء جميعاً ميدان حُبّه وغرامه، وقد تغزّل بهن بشعر رقيق يكاد يخلو من اللوعة والحرمان؛ لأنهن قريباتٌ منه؛ فَهَجْرُهُنّ دلالٌ ينتهي بوصلٍ، وخِصام يَعْقُبُهُ صُلحٌ في الحال(65).
وتزوّج أبو الجيش مجاهد العامريّ، صاحِبُ دانيّة والجزائر الشرقيّة (400- 436ه/1009- 1044م) نصرانيّة اسمها “جود”، وهي أم ولده إقبال الدولة علي بن مجاهد العامريّ، الذي وَلِي الحُكْمَ بَعْدَ أبيه مجاهد(66).
كذلك عَرَفَ عَصْرُ السيطرة المغربيّة، عَصْرُ المرابطين والموحِّدين، تلك المصاهرات؛ يروي ابن عِذاري أن الأمير علي بن يوسف بن تاشفين المرابطيّ (500- 537هـ/ 1106- 1143م) تزوّج جارية اسمها “قمر”، فأنجبت له ابنه سِير بن علي بن يوسف بن تاشفين(67). ويضيف: لما مات سير فاوضت أمه “قمر” أباه فيمن يوليه عهده دون تاشفين بن علي بن يوسف بن تاشفين، مفضّلةً أخا تاشفين، وهو إسحاق بن علي؛ لأنها رَبَّته بعد موت أمه، فكان لها كابنها(68).
وأغلب الظَّنّ أنَّ قَمَراً هذه هي جارية إسبانيّةٌ، وقد استندنا في رأينا هذا على قول ابن عِذاري: “وكان علي بن يوسف… وهو أوّل من استعمل الروم وأركبهم في المغرب وجعلهم يَحْقِدُون على المسلمين في مغامرتهم…(69)“.
وفي ترجمة علي بن يوسف بن تاشفين، يروي صاحب الحُلَل المُوشِيّة” أنَّ عَلِيًّا هذا تزوّج روميّة تسمّى: فاضَ الحُسْنُ: “… تميم الذي ثار على ابن أخيه إبراهيم وهو أصغرهم سنّاً، أمه روميّة تسمّى: فاض الحسن”(70).
وتزوّج أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن الموحِّدي (558- 580ه/ 1162-1184م) امرأة روميّة اسمها ساحر. وقد ذكر ذلك عبد الواحد المرّاكشي عند حديثه عن ولايّة المنصور أبي يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن، فقال: “أمه أم ولد، روميّة اسمها ساحر(71)“. وتزوّج الخليفة الموحِّدي المنصور أبو يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن (580- 595ه/ 1184- 1198م) امرأة روميّة اسمها “زهر”. وقد أوضح ذلك عبد الواحد المراكشي في ذكر ولايّة الناصر أبي عبد الله محمّد بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن، فقال: “أمه أم ولد اسمها زهر، روميّة(72). وتزوّج الخليفة الموحِّدي الناصر أبو عبد الله محمّد بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن (595- 610ه/ 1198- 1213م) امرأة روميّة اسمها “قمر”، وتلقَّب حكيمة. وقد تحدَّث عن ذلك عبد الواحد المراكشي في ذكر ولايّة أبي يعقوب يوسف بن محمّد بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن (610- 610ه/ 1213- 1213م)، فقال: “أمه أم ولد، روميّة، اسمها قمر، تُلَقَّبُ حكيمة”(73).
وتزوّج الخليفة الموحِّدي المأمون أبو العلاء إدريس بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن (624- 629ه/ 1226- 1231م) غير امرأة روميّة، وقد ورد ذلك في حديث ابن الخطيب عن بنات إدريس المذكور، فقال: “بناته: ابنة العزيز، وصفيّة، ونجمة، وعائشة، وفتحونة، وأمهات الجميع روميّات وسَرِيّات مغربيّات(74)“. وروى ابن أبي زرع أن المأمون تزوّج سبيّة إسبانيّة اسمها حباب(75). وقال ابن عِذاري: إن المأمون تزوّج حبابة الروميّة، وهي أم ولد، وتكنى أم الرشيد، وهي التي سَعَتْ، بعد موت زوجها المأمون وبمعاونة قواد الروم، إلى أن يتولى ابنها الرشيد مقاليد الحكم سنة 630ه/ 1232م(76).
ولم يكن اقتران بعض سلاطين بني نصر بغرناطة من أمهات نصرانيّات بِدْعَةً؛ لأنه تقليد قديم في قصور الأندلس؛ فسلطان غرناطة أبو عبد الله محمّد ابن إسماعيل بن فرج بن نصر (725- 733ه/ 1324-1322م) أمه روميّة اسمها “علوة”، وكانت أحظى لدّآتها عند أبيه وأم بكره(77).
كذلك تزوّج سلطان غرناطة أبو الحسن الغالب بالله علي بن سعد النّصْري (890ه/ 1485م) ابنة عمِّه أبي عبد الله الأيسر، المسماة عائشة الحرة، ووَلَدَتْ منه ولدين؛ أكبرهما أبو عبد الله محمّد الذي سقطت الأندلس في عهده سنة 897ه/ 1492م، والثاني أبو الحجّاج يوسف. ثم تزوّج، وهو في سنِّ الشيخوخة، فتاة روميّة جميلة تدعى “ثريا” واسمها الإسباني إيزابيلا Isabella، وهي ابنة القائد سانشو خيمينث دي سوليس Sancho Jimenez De Solis، كانت أُخِذَتْ أسيرةً في بعض المعارك، واُلْحِقَتْ وصيفةً بقصر الحمراء، فاعتنقت الإسلام، وتَسَمَّتْ “ثريّا”، ولم يلبث أن تزوّجها السلطان أبو الحسن، واصطفاها على زوجه العجوز الأميرة عائشة، وأنجبت منه ولدين هما سعد ونصر، وكانت ترجو أن يكون المُلْكُ لأحدهما، وقد بذلت استطاعت من صنوف الدَّس لإبعاد محمّد ويوسف، ولدي الأميرة عائشة من أيِّ حق في الملك(78).
وقد أدّت هؤلاء الزوجات اللواتي هنَّ جوار مسيحيّات إسبانيّات أو غير إسبانيّات، دوراً كبيراً في الحياة الاجتماعيّة والسياسيّة في الأندلس، فَكُنَّ يَنقُلْنَ أفكار مسلمي الأندلس إلى نصارى الشمال الإسباني، ومن تعلَّمت العربيّة منهنّ نقلت الأفكار والأقاصيص الإسبانيّة والأوروبيّة إلى اللغة العربيّة.
وانقسمت البيوتات العربيّة قسمين: قسم من أولاد السّراري، وقسم من أولاد الحرائر، والأولاد تبعاً لأمهاتهم ينقسمون بدورهم إلى قسمين: قسم يتعصَّب لأمه السَّريّة، وقسم يتعصب لأمه الحُرَّة، وكثيرا ما وقع القتال في الحاضرة ودبرت المؤامرات بسبب تعصب كل فرد. وعلى الرغم مما كانت النساء يتظاهرن به من حب العروبة والإسلام، فإنَّهُنَّ في الحقيقة لم ينسين نصرانيتهن ولا إسبانيتهنَّ، فكان بعضُهُنَّ جواسيس على الحكّام، ينقل لقومهن الأمور، ويوقعن المسلمين في أشد أنواع الحرج(79).
ولم يقتصر الأمر على الزواج من بنات الأسر الحاكمة في الشمال الإسباني، فقد كان التسرّي بالإسبانيّات اللواتي كُن يَقُعْنَ في السبي عادةً مألوفة في بيوت حكّام الأندلس الإسلاميّة(80). وكان بعض الأمراء والخلفاء الأمويين يشترطون أن تحتوي الجزيّة على بعض الفتيّات الغاليسيّات الشقراوات، نسبة إلى مدينة غاليسيّة الإسبانيّة. وكان الطلب على هذا النوع من الفتيّات عظيما، وقد أدى ذلك عندهم إلى وجود العيون الزرق والشَّعر الأحمر والبشرة البيضاء. ولا يزال يُرى في قصر إشبيليّة ردهة تُدعى ردهة الصبايا، كان المعتمد بن عبّاد يستقبل فيه الفتيّات اللائي كان على نصارى الشمال أن يقدموا مائة منهنّ إلى بعض ملوك العرب في كُلِّ سنة كجزية(81).
لقد تأثر الإسبان بالمسلمين من حيث تعدد الزوجات؛ فكان بعض ملوك ليون وقشتالة، يحتفظ، بالإضافة إلى زوجه الشرعيّة، بسرب من الخطايا. ومع أن هؤلاء لم يَبْلُغْنَ من الكثرة مبلغهنَّ عند الأمراء المسلمين، فقد كُنّ يُعاملن معاملة الزوجات تقريباً، وكان أولادهن، على الرغم من حرمانهم من الإرث الشرعي، يرثون أحياناً بعض الأراضي(82).
إن عدداً قليلاً من المسلمات تزوّجنَ من غير دينهن، وقد يكون ذلك تحت تأثير المجاورة أو تحت ضغوطات ماديّة ومعنويّة. يروي ابن حزم أنَّ موسى بن موسى بن فُرْتون بن قَسِيّ المُوَلَّدي(83)، زفّ ابنته أوريّة إلى غرسيّة Garcia ملك البشاكسة، وتزوّجها، ووَلَدَتْ له موسى بن غرسيّة(84). ويضيف أن موسى نفسه زوج بنات أخيه لب بن موسى بن موسى بن فرتون بن قسي، لأولاد ونقة بن شانجه Inigo Sanchez، ملك البشاكسة(85) ولما توفي موسى ابن موسى بن فرتون بن قَسِيّ، أقدمت أرملته على التزوّج من الأمير النافاري ونقه بن أرستا Inigo Arista(86).
ويذكر ابن الدّلائي أن ينقه بن ونقه هو أخو موسى بن موسى بن فُرْتون ابن قَسِيّ لأمه، ومعنى ذلك أن أم موسى كانت إسبانيّة(87).
بالنسبة إلى الضغوطات الماديّة، فقد زوّج المعتمد بن عبّاد ابنته زائدة من ألفونسو السادس صاحب قشتالة، بعد أن فقد سلطانه بإشبيليّة وزج في سجن أغمات، ودعيت باسم “ماريا”، ووَلَدَتْ له ذكراً اسمه سانشو، وكان ألفونسو يُحِبُّه حُبّاً جَمّاً حتى إنَّه اختاره لولايّة عهده لما بدا من نجابته وشجاعته(88). وتُوفيت زائدة عند وضعها سانشو، وحين بلغ الابن ما يقرب من تسع سنوات، أرسله أبوه ليشترك مع جيوشه في حملة وَجهَها ضد المرابطين، فلقي مصرعه في موقعة “إقليش”، وعندما بلغ ألفونسو نبأ مصرعه لم يهمله الحزن، فتوفي بعد وفاة ابنه بعام واحد(89).
وتعدَّدت الآراء حول هذا الزواج، فكانت أقرب إلى الخيال منها إلى الحقيقة، يذكر أشباخ أنّ المعتمد قدمها زَوْجاً لألفونسو إثر محالفة تمت بينهما سنة 484ه/ 1091م؛ لكي يوثق روابط التحالف المعقود بينهما(90). ويضيف أن هذا الزواج يفيضُ بالروح القصصيّة، ولا يتفق إطلاقاً مع التقاليد الإسلاميّة في البلاد، فلا يمكن أن يكون الأمر متعلِّقاً بزواج شرعي، بل بمجرد اتخاذها عشيقةً، أو بالأحرى حَظِيّة له، وقد تشبَّه بالتقاليد الإسلاميّة التي كانت منتشرة بين أمراء إسبانيا النصرانيّة، بالرغم مما كانت تثيره الكنيسة الإسلاميّة ضده من شديد الاحتجاج(91).
ونحن نقول: من المستبعد أن يَهِبَ المعتمد على ما في ذلك من ذلة، إحدى بناته لملك نصراني كان عدوّه اللدود، يفرض عليه جزيّة سنويّة فادحة. ولو سلمنا جدلاً بأن ملك إشبيليّة استطاع أن يسلك هذا المسلك غير الطبيعي، لكان ذلك ضرباً من الجنون.
هذه الحادثة تَحْمِلُ سمات الانحراف أو البطلان، وإذا لم يكن من المعقول أن يرضى أمير مسلم عظيم كالمعتمد أن يزوج ابنته من نصراني، فإنَّه مما لا يقبله العقل مطلقاً أن يرتضي أن تكون ابنته خليلةً غير شرعيّة لمثل هذا الأمير. وإذا لم يكن المعتمد يقيم لمثل هذا التصرف الشائن وزنا للاعتبارات الدينيّة والشرعيّة، وهو في حد ذاته مما لا يعقل، فمن المستحيل عليه ألا يحسب أعظم حساب لنتائجه السياسيّة، وأقلها أن يضطرم شعبه المسلم بالثورة عليه، وأن يَسْحَقَهُ وَيَسْحَقَ أَسْرَتَه. أما التفسير الحقيقي لهذه ا القصة، فهو ما كشفت عنه البحوث الحديثة، وهو أن زائدة هذه هي جارية مسلمة اعتنقت النصرانيّة، وقد رآها ألفونسو وهمّ بها، وكانت قبل تنصّرها زوجة للمأمون ولد المعتمد(92).
إن هذا الزواج، وإنْ دَلَّ على شيء، فإنَّما يَدلُّ على التداخل الذي كان قائما بين الشعبين المسلم والمسيحي على أرض شبه الجزيرة الإيبيريّة؛ فلم تكن حروب الاسترداد مستمرة ومتصلة، ولم يكن الناس يقدرون على ذلك كثيرا، بل كانت هناك أوقات أو سنوات ربَّما تَطول أو تَقْصُرُ، بِحَسَب الأوضاع الداخليّة لكل من البلدين، تهدأ فيها الحروب ويسود السلام، وتمثل انصهاراً في النواحي الثقافيّة والاجتماعيّة بين الجانبين المسيحي والإسلامي، اللذين كانا يعيشان في وقت واحد حياة الحرب والحب معا، برغم التناقض الموجود بينهما. فالحرب تمثلها تلك الغزوات والهجمات التي لا تنتهي بين الجانبين، والحُبُّ يُمثله هذا الزواج المختلط، وتلك القرابة والمصاهرة الدائبة، والجوار والتعايش الذي لا ينتهي أبداً(93).
وفي النهايّة نقول: إنَّ عدداً كبيراً من حكّام الأندلس، إذا لم نقل الأغلبيّة الساحقة منهم تزوّجوا إسبانيّات، وهو زواج سياسي أكثر منه عادياً، كان يهدف إلى إرساء كلمة العرب والإسلام بين أهل البلاد، وقليل منه كان ثمرة الانتصارات العسكريّة التي شهدتها شبه جزيرة إيبيريّة.
وعن طريق هذا الزواج حصل تمازج، وكان التأثير والتأثر في غير ميدان من ميادين الثقافة والعلوم، فتوطدت العلاقات بين المسلمين والنصارى، وقوي الاتصال بين الطرفين عدة قرون. وقد أسهمت تلك المصاهرات إلى حدٍّ ما في توطيد علاقات الجوار بين حكّام الأندلس وحكّام الشمال الإسباني. وفي النتيجة العامة نقول: إذا كان العرب والمسلمون قد أثروا في النصارى، فجعلوهم يَلْبَسُون زيَّهم ويمارسون عاداتهم وتقاليدهم كختن صغارهم والامتناع عن أكل لحم الخنزير، ويتعلمون لغتهم ويُقبلون على قراءة شعرهم، فإن الإسبان أثروا بدورهم في عقول وعواطف عرب الأندلس ومسلميها، فانتشرت لغتهم الرومنثيّة بينهم، فتحدثوا بها في مجالسهم الأدبيّة ومحاكماتهم القضائيّة، واستعملوها في بعض موشحاتهم.
وإذا أردنا الإسهاب في هذا المجال، فإنَّ الحديث يطول ويستغرق مجلَّدات. ونعتبر ما ذكرناه ليس إلّا إشاراتٍ سريعة غايتها تسليط الضوء على هذا الجانب الاجتماعي الهام من حياة الشعبين الأندلسي والإسباني. وبالتالي يمكن إفراد بحثٍ خاص عن هذا الموضوع، والسّير معه، منذ ولادته في عصر الولاة حتى نهايته في عصر سلاطين بني الأحمر.
حواشي البحث:
1 العبّادي: في التاريخ العبّاسي والأندلسي، دار النهضة العربيّة، بيروت، 1971، ص 354-355، وحميد: قضايا أندلسيّة، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأوّلى، 1964، ص45.
2 العبّادي: الإسلام في أرض الأندلس، مجلّة عالم الفكر، المجلّد العاشر، العدد الثاني، 1979، ص62-64.
3 الحجّي: أندلسيّات، دار الإرشاد، بغداد، 1969، ص85، والمصاهرات بين الأندلس وإسبانيا، مجلّة الأقلام، الجزء السادس، السنة الثالثة، وزارة الثقافة والإرشاد، بغداد، 1967، ص135، وقاسم: مملكة ألمريّة في عهد المعتصم بن صمادح، مكتبة الوحدة العربيّة بالدار البيضاء، دار الكتب العلميّة، بيروت، 1994 ص63.
4 مورينو جوميث: الفنّ الإسلامي في إسبانيا، نقله إلى العربيّة الدكتور لطفي عبد البديع والدكتور السَّيِّد محمود عبد العزيز سالم، الدار المصريّة للتأليف والترجمة، بدون تاريخ ص6، وكرد علي: غابر الأندلس وحاضرها، المطبعة الرحمانيّة، القاهرة، الطبعة الأوّلى، 1934، ص39.
5 لوبون: حضارة العرب، نقله إلى العربيّة الأستاذ عادل زعيتر، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثالثة، 1979، ص332.
6 البستاني: أدباء العرب في الأندلس وعصر الانبعاث، مكتبة صادر، بيروت، 1937، ص168.
7 ليفي- بروفنسال: الإسلام في المغرب والأندلس، نقله إلى العربيّة الأساتذة محمّد عبد العزيز سالم وصلاح الدين حلمي ولطفي عبد البديع، مكتبة نهضة مصر، 1958، ص24-25.
8 الرِّكابي: في الأدب الأندلسي، دار المعارف بمصر، 1966، ص43.
9 الأدهمي: مرآة النساء، فيمن حَسُنَ منهنّ وساء. المطبعة المحموديّة التجاريّة، القاهرة، 1934، ص175.
10 المرجع نفسه والصفحة نفسها.
11 المرجع نفسه، ص10.
12 موسى بن نصير هو الذي أسكن ابنه عبد العزيز مدينة إشبيليّة، بعد أن خَلَفَهُ على الأندلس سنة 95ه/713م، فأراد أن تكون إشبيليّة باب الأندلس وحاضرتها، ولمّا وُلّيَ أيّوب بن حبيب اللخمي الأندلس حوّل أهل الأندلس السلطان إلى قرطبة في أوّل عام 99ه/715م. مجهول: أخبار مجموعة، تحقيق الأستاذ إبراهيم الأبياري، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1981، ص27-28.
13 ابن القُوطيّة: تاريخ افتتاح الأندلس، تحقيق الأستاذ إبراهيم الأبياري، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1982، ص36-37، ومجهول: أخبار مجموعة، ص27-28، وابن عِذاري: البيان المُغْرِب، تحقيق الأستاذين ج.س. كولان وإ. ليفي- بروفنسال والدكتور إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، (ج2 ص 23-24) والمقّري: نفح الطيب، شرحه وضبطه الدكتور يوسف طويل والدكتورة مريم قاسم، دار الكتب العلميّة، بيروت، 1995، (ج1، ص269-270). وانظر أيضاً: الحجّي: أندلسيّات ص76-77 والمصاهرات بين الأندلس وإسبانيا ص131، وليفي بروفنسال: حضارة العرب في الأندلس، نقله إلى العربيّة الأستاذ ذوقان قرقوط، دار مكتبة الحياة، بدون تاريخ، ص73، وحلّاق: دراسات في تاريخ الحضارة الإسلاميّة، دار النهضة العربيّة، بيروت، الطبعة الثانيّة، 1999، ص272.
14 أمين: ظهر الإسلام. دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الخامسة، 1969، (ج3 ص31).
15 ابن قيّم الجوزيّة: روضة المُحِبِّين. تحقيق الأستاذ أحمد عبيد، مطبعة السعادة، القاهرة، 1956، ص184.
16 راجع الحاشيّة 13.
17 مجهول: أخبار مجموعة، ص28. وانظر أيضاً: ابن عِذاري: البيان المُغْرِب (ج2 ص23-24).
18 الحجّي: أندلسيّات ص77-78، والمصاهرات بين الأندلس وإسبانيا ص131، وعنان: أندلسيّات، سلسلة فصليّة تصدرها مجلة العربي بعنوان: كتاب العربي (الكتاب العشرون) 1988، ص18-19، وسالم: تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس، دار النهضة العربيّة، بيروت، 1988 ص141، وليفي- بروفنسال: حضارة العرب في الأندلس، ص 73.
19 ابن القُوطيّة: تاريخ افتتاح الأندلس ص30-32.
20 مؤنس: فجر الأندلس، القاهرة، 1959، ص335.
21 المرجع نفسه ص377.
22 Levi- Provencal: Histoire de L Espagne Musulmane, Paris, Leiden, 1950, 1953, (T.1, pp.117).
وانظر أيضاً: الحجّي: أندلسيّات ص81، والمصاهرات بين الأندلس وإسبانيا ص132، وعنان: دولة الإسلام في الأندلس، القاهرة، 1960، ج1 ص216.
23 ابن الدّلائي: نصوص عن الأندلس، تحقيق الدكتور عبد العزيز الأهواني، مطبعة معهد الدراسات الإسلاميّة بمدريد، 1965، ص62.
24 ابن حيّان: المقتبس من أنباء أهل الأندلس، تحقيق الدكتور محمود علي مكّي، دار الكتاب العربي، بيروت، 1973، ص331.
25 المصدر نفسه ص182.
26 المصدر نفسه ص182-183، وقد وردت الأبيّات الأربعة أيضاً في الحُلّة السِّيَراء لابن الأبّار، تحقيق الدكتور حسين مؤنس، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، الطبعة الأوّلى، 1963، ج1 ص144، ببعض الاختلاف عمّا هنا. وقوله: سبّاءة للألباب، أي تسبي الألباب (القلوب).
27 Oliver y Hurtado: Discursos, N.2. Real Acade,ia de la historia, Madrid, 1866 (V. III, PP.107); Levi- Provencal: La Civilisation arabe en Espagne, Paris,1961, (pp.109-110).
ليفي- بروفنسال: حضارة العرب في الأندلس، ص73، والحجّي: أندلسيّات ص 83-84، وحلّاق: دراسات في تاريخ الحضارة الإسلاميّة ص273.
28 ابن عِذاري: البيان المغرب، ج2 ص151.
29 الحجّي: أندلسيّات ص83، والمصاهرات بين الأندلس وإسبانيا ص133.
30 الحُمَيْدي: جَذْوَة المُقْتَبس، الدار المصريّة للتأليف والترجمة، القاهرة، 1966، ص13.
31 الضّبي: بغيّة الملتمس، دار الكتاب العربي، القاهرة، 1967، ص17.
32 ابن عِذاري: البيان المغرب ج2 ص156.
33 ابن حيّان: المقتبس، تحقيق الأساتذة ب. شالميتا، وف. كورينطي، ومحمود صبح. المعهد الإسباني العربي للثقافة، مدريد، كلِّيّة الآداب بالرباط، 1979، ج5 ص 7-9.
34 الحُمَيْدي: جذوة المقتبس، ص13.
35 الضّبي: بغيّة الملتمس، ص18.
36 ابن عِذاري: البيان المغرب، ج2 ص233.
37 المقّري: نفح الطيب، ج1، ص346-347، وأزهار الرياض، تحقيق الأساتذة مصطفى السقّا، وإبراهيم الأبياري، وعبد الحفيظ شلبي. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 1940، ج2 ص265.
38 الحجّي: أندلسيّات ص 78، والمصاهرات بين الأندلس وإسبانيا ص132.
39 ابن عِذاري: البيان المغرب، ج2 ص253.
40 المصدر نفسه ج3 ص42.
41 ابن الخطيب: أعمال الأعلام- القسم الثاني، تحقيق الأستاذ ليفي- بروفنسال، دار المكشوف، بيروت، 1956، ص42-43.
42 المصدر نفسه ص43.
43 ابن سعيد: المُغْرِب، في حلى المَغْرِب تحقيق الدكتور شوقي ضيف. دار المعارف بمصر، 1964، ج1 ص195.
44 أمين: ظهر الإسلام، ج3 ص126.
45 ابن عِذاري: البيان المغرب ج3 ص 38.
46 المصدر نفسه ص42.
47 ابن الخطيب: أعمال الأعلام (القسم الثاني ص66).
48 المصدر نفسه، ص73-74.
49 المصدر نفسه، ص63.
50 ابن الأبّار: الحُلّة السيراء ج1 ص269.
51 المصدر نفسه ص272، حاشيّة رقم 1.
52 ليفي- بروفنسال: حضارة العرب في الأندلس، ص73.
53 الحجّي: أندلسيّات ص79-80، والمصاهرات بين الأندلس وإسبانيا، ص132.
54 سالم: تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس، ص343.
55 ابن خلدون: كتاب العبر، وديوان المبتدإ والخبر، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1981، (م4 ص389).
56 عنان: الدولة العامريّة، وسقوط الخلافة الأندلسيّة، القاهرة، 1958 ص93، والحجّي: أندلسيّات، ص79، والمصاهرات بين الأندلس وإسبانيا، ص132.
57 عبد الواحد المرّاكشي: المُعْجِب، في تلخيص أخبار المغرب، تحقيق الأستاذ محمّد سعيد العريان، القاهرة، 1963، ص83-84.
58 Ribera Y Tarrago: Disertaciones Y Opusculos, Madrid, 1928 (v. 1. pp.14).
59 هيكل: الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة، دار المعارف بمصر، 1979، ص36-37.
60 ابن يسّأم: الذخيرة، في محاسن أهل الجزيرة، تحقيق الدكتور إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، 1978-1979 (ق 2 ص29). وانظر أيضاً: ابن خلِّكان: وَفَيّات الأعيان، تحقيق الدكتور يوسف طويل والدكتورة مريم قاسم. دار الكتب العلميّة، بيروت، 1998، ج4 ص276 وابن عِذاري: البيان المغرب ج3 ص207- 208.
61 ابن الأبّار: الحلة السيراء (ج2 ص55).
62 المصدر نفسه، ص (62، 70- 71). وانظر أيضاً: خالص: إشبيليّة في القرن الخامس الهجري، دار الثقافة، بيروت، 1981، ص97.
63 ابن خلِّكان: وفيّات الأعيان (ج4 ص159).
64 ابن الخطيب: أعمال الأعلام (القسم الثاني ص159).
65 راجع: المعتمد بن عبّاد: ديوان المعتمد بن عبّاد، تحقيق الأستاذين أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد، المطبعة الأميريّة بالقاهرة، 1951 (مقدمة المحققين، والصفحات التاليّة: 2، 3، 7، 8، 9، 14، 15، 18، 19، 20، 23، 114).
66 ابن الخطيب: أعمال الأعلام، القسم الثاني ص219. وانظر أيضاً: أشباخ: تاريخ الأندلس في عهد المُرابطين والموحِّدين، نقله إلى العربيّة الأستاذ محمّد عبد الله عنان، مؤسسة الخانجي، القاهرة، الطبعة الثانيّة، 1958، ص190.
67 ابن عِذاري: البيان المغرب، ج4، ص78.
68 المصدر نفسه، ج4 ص97.
69 المصدر نفسه (ج4، ص102). وانظر أيضاً: مجهول: الحُلل الموشيّة، مطبعة التقدم الإسلاميّة بتونس، 1329ه ص61.
70 مجهول: الحلل الموشيّة، ص61.
71 عبد الواحد المراكشي: المعجب ص336.
72 المصدر نفسه، ص386.
73 المصدر نفسه، ص404. وانظر أيضاً: الناصري: الاستقصاء، لأخبار دول المغرب الأقصى. تحقيق الأستاذين جعفر الناصري ومحمّد الناصري، دار الكتاب، الدار البيضاء، 1954، ج2 ص226.
74 ابن الخطيب: الإحاطة، في أخبار غرناطة، تحقيق الدكتور يوسف علي طويل، الطبعة الأوّلى، دار الكتب العلميّة، بيروت، 1424ه/2003م، ج1 ص227.
75 ابن أبي رَرع: الأنيس المطرب ص216، 225، 254. وانظر أيضاً: الناصري: الاستقصاء، ج2 ص241.
76 ابن عِذاري: البيان المغرب- قسم الموحِّدين، تحقيق الأساتذة محمّد إبراهيم الكتاني ومحمّد بن تاويت ومحمّد زنيبر وعبد القادر زمامة. دار الغرب الإسلامي ببيروت، دار الثقافة، الدار البيضاء، 1985، ص298، 299.
77 ابن الخطيب: الإحاطة، ج1 ص311.
78 المقّري: نفح الطيب، ج6 ص268. وانظر أيضاً: عنان: نهايّة الأندلس وتاريخ العرب المتنصِّرين، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر. القاهرة، الطبعة الثالثة، 1966، ص197- 200؛ أمين: ظهر الإسلام: ج3 ص46 والزّركلي: الأعلام، دار العلم للملايين، بيروت، 1980، ج4 ص290.
79 أمين: ظهر الإسلام (ج3 ص303)؛ عبد الحليم: العلاقات بين الأندلس الإسلاميّة وإسبانيا النصرانيّة. دار الكتاب اللبناني، بيروت، بدون تاريخ، ص 421-423.
80 Ribera Y Tarrago: Disertaciones Y Opusculos, 1928 (v. 1. pp.14).
81 لوبون: حضارة العرب، ص 332 وعبد الحليم: العلاقات بين الأندلس الإسلاميّة وإسبانيا النصرانيّة ص 421-422.
82 أشباخ: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحِّدين ص133.
83 كان قسي قومس الثغر في أيّام القوط، فلمّا افتتح المسلمون الأندلس لحق بالشأم وأسلم على يدي الخليفة الوليد بن عبد الملك، فولد فرتون وأبا ثور وأبا سلامة ويونس ويحيى. ابن حزم: جمهرة أنساب العرب، تحقيق الأستاذ عبد السلام محمّد هارون، دار المعارف بمصر، 1962 ص502. وقد استقلّ بنو قَسِيّ أو بنو موسى المولّدون في عهد الأمير محمّد بن عبد الرحمن الثاني (238-273ه/ 852-886م) بمنطقة سَرَقُسْطَةَ أو الثغر الأعلى، التي كانت ثغراً على أراجون Aragon وقطالونيا Cataluna في شمال شرق إسبانيا. العبّادي: في التاريخ العبّاسي والأندلسي ص376.
84 ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص502.
85 المصدر نفسه والصفحة نفسها. وانظر أيضاً: الحجّي: أندلسيّات ص 81، والمصاهرات بين الأندلس وإسبانيا، ص133.
86 أندلسيّات ص81، والمصاهرات بين الأندلس وإسبانيا ص 132.
87 ابن الدّلائي: نصوص عن الأندلس ص 29-30.
88 أشباخ: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحِّدين، ص134.
89 ليفي- بروفنسال: الإسلام في المغرب والأندلس ص156 وعنان: دول الطوائف، ص390.
90 أشباخ: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحِّدين، ص55.
91 المرجع نفسه والصفحة نفسها.
92 راجع المرجع نفسه (ص56، حاشيّة رقم1)، وعنان: دول الطوائف، ص 335.
93 عبد الحليم: العلاقات بين الأندلس الإسلاميّة وإسبانيا النصرانيّة (ص 423-424).

