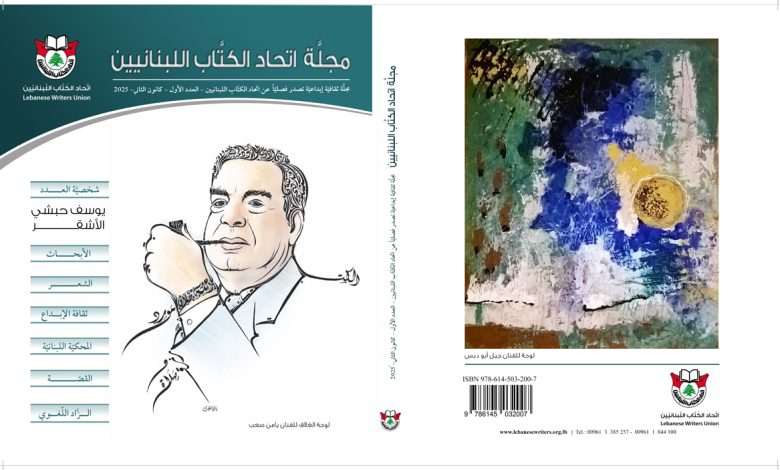
أقانيم الحبّ والحزن والطبيعة والقلق الوجودي
قراءة في ديوان “وطنٌ تنهّدَ من ثقوب الناي” لعلي نسر
الأستاذ باسم عبّاس
يقول كولردج: “… وسرُّ العبقريّة في الفنون إنّما يظهر في إحلال هذه الصور محلّها، مجتمعةً مقيّدةً بحدود الفكر الإنساني، كي يستطاع استنتاج الأفكار العقليّة من الصور التي تمتُّ إليها بصلة، أو إضافةِ هذه الأفكار إليها، وبذا تصيرُ الصور الخارجيّة أفكاراً ذاتيّةً، وتصير الأفكار الداخليّة صوراً خارجيّةً، فتصبحُ الطبيعةُ فكرةً، والفكرةُ طبيعةً”.
حضر هذا القول في ذهني بقوّةٍ وأنا أقرأُ المجموعةَ الشعريّةَ: “وطنٌ تنهّدَ من ثقوبِ النّاي”، للشاعر والروائي والنّاقد الدكتور علي نسر، الصادرة عن دار البنان للطباعة والنشر والتسجيل والتوزيع، بتأنٍّ وشغفٍ قرأتُ هذه المجموعة، ليتبيّن أنّ ثمّةَ خمسة فضاءاتٍ يحملكَ إليها الشّاعر على جَناحي لغةٍ غنيّةٍ بالرموز والاستعارات والدلالات.
لغةٌ يحرصُ علي نسر ألّا تكونَ عاديّةً، وأن يرافقها عصبٌ حدسيٌّ قادرٌ على شحنِ الصّورةِ الشعريّةِ بطاقةٍ انفعاليّةٍ نفسيّةٍ تسهم في نموّ القصيدةِ وترابطها.
يقول إيليا حاوي: “إنّ القصيدة لا يمكن أن تنمو نموّاً عضويّاً حيّاً إلّا إذا كان لدى الشّاعر عصبٌ حدسيٌّ يوقّع الصور ويضبطها ويمدّها بما يبقي على وحدة القصيدة وانسجامها وتآلفها”.
أمّا الفضاءات الخمسة التي يحملك إليها الشاعر فهي:
– الفضاء الأوّل: نراه في القصائد: “الركض خلف صمتِ المواعيد”- “حين تشتكي النايات”- “وطنٌ تنهّد من ثقوب الناي”- “مجمرة القصائد”.
فالحزنُ سمةٌ بارزةٌ في هذا الفضاء، حيث نجد قلب الشاعر “كالجدول المهجور”، وجسده حقول الريح، ونرى انتشاراً كثيفاً لمفردات: الخريف- المطر الحزين- ورقٌ تمزّقَ- نشتعل- الأغلال- زنابق منسيّة الأحواض- ينكسر الندى- جيبها المثقوب- منهكة- الخرساء- تبكي- ترحال- تهدّم- تجاعيد- بعثرت- صراخ- تناثر- تخلّع- التعبى- تستبيح- مهمّشة… إلخ.
الشعور بالحزن والانكسار جعل الشّاعر يرى للعواصف تجاعيد، فراح يصرخُ: “لملم صراخي من ثقوبِ النّاي” ص: 14، لكأنّ صراخَه باتَ مبعثراً هنا وهناك، فراحَ يتسرّبُ عبرَ ثقوبِ نايٍ لطالما حمل الدموعَ والأشواقَ والبكاء والآهاتِ، إلّا أنّ صراخَه هذا لا يمنعُهُ من أن يداعبَ الدفلى في يدي حبيبته، إذ تحضر الأصابعُ التي تباعده نحو أطلالٍ بلا ذكرى، وهو، حين ينظرُ إلى الجياد والأيّامِ والصّولاتِ والغزواتِ وفارسها، يكحّل عينيه برؤيةِ نساءٍ “يغسلنَ التأوّهَ في دِلاءٍ من حنينٍ”. ص: 14.
ولشدّةِ حالاتِ التمزّقِ والانكسار، بدا علي نسر كأنّه يسيرُ صوبَ جنازتِهِ: “يحصي الشامتين أمام جرحٍ سرمديٍّ”. ص: 15.
وفي مسيره هذا، يبوحُ بما يؤرّقُ ليله السهران: “متّكئاً على سُحُبٍ مهشّمةِ المساندِ/ والمقاعد توقد النيران في رئتي الحبيسة”. ص: 16.
ويؤلمه التاريخ الحامل أشواكاً وأدياناً، المليءُ أمواتاً وأحزاناً، حيثُ الأقداحُ تدمع، والجرحُ يُنكَأ ويستمرّ الشاعر في صبرهِ وانتظارِه، “لكنّ موعد العشّاقِ منكسر الزوايا”، “تنزوي الأشواقُ في حضن المرايا”. ص: 17.
إنّ فضاء الحزن والانكسار، كشف لنا أنّ الشاعر متعبٌ من ولادتِهِ في وطنٍ تحاصره الأعاصيرُ، “فيجثو الغمام على ركبةِ المغرب الشتويّ”. ص: 45.
وطنٌ تنزوي فيه نرجسةٌ، و”تهرب سنبلةٌ من حصار البيادر”. ص: 46.
وطنٌ يغدو فيه الشّاعرُ وحيداً، شريداً، طريداً، وحين يرى أنّ جوادَه مريضٌ، يطلبُ من المرأةِ أن تشرّعُ له منافيها ليرتاحَ من إنهاكِ المسافاتِ له، الشاعر/ الملك يعانده سيفه، يتخلّى عنه جنودُه، لكنّه رغمَ ذلك يستمرُّ في انتمائه إلى الفقراء والمقهورين الذين “أحبّوا بلادهم خلسةً أو بعيداً من السلطات”، ص: 47.
وربّما كان صراع الشّاعر مع الحكّام واحداً من الأسباب المولّدة للشعور بالغربة والقلق والخوفِ أحياناً: “دمي في القصورِ يصيرُ وساماً/ لكرسيّه، لعروشِ الجماجم”. ص: 48.
“ليتَ دمائي تصيرُ حساماً/ وليتَ جناحي المهيض المصاب بروقٌ/ وليتَ صراخي الحزين رعودٌ”. ص: 49.
في هذا الصراع المحتدم، حيث “إناء الحليب استحال بعيداً كغيمة صيف”. ص: 50، وحيثُ الغدير يغادر ينبوعه مرغماً، يتسرّبُ القلقُ والخوفُ إلى روحِ الشّاعرِ: “أنا المتفلّتُ من جسدي/ أنكرُ الظلّ خطوي وأنكرني”. ص: 51.
إلّا أنّ القلقَ والخوف لا يحولانِ دون إمكانيّة بزوغ فجرٍ جديدٍ: “من يصادقني كي تصيح الديوك/ ويطلع فجرٌ جديدٌ على الأنبياء”. ص: 51.
هذا التأرجح بين القلق والخوف والأمل بفجرٍ جديدٍ، يُبقي على وتيرة الصراع الذي يغدو في أوجّه، ولا يوصِل إلى برِّ الأمان، إذ تنهمرُ الصورُ الشعريّةُ المعبّرةُ عن حزنِ الشاعر ويأسه وتململِه، حيث نرى السنين تودّعه، السّفن غير هادئة، و”لم يبقَ ليومه سوى جرعةٍ من حكايا/ مبعثرةٍ كمواويلِ نايٍ يتيم”. ص: 53.
وفي السّياقِ نفسه، يشعرُ أنّه سيموتُ وحيداً، ويرحلُ سرّاً بلا كفنٍ.
إنّ علي نسر على عادته، وهو في ذروة اليأس، وحينَ يرى للغروبِ دموعاً، يعود إلى طبيعتِه الأولى، إلى بثّ الأمل حيث يرى في الغسَقِ سريراً من المستحيل، وسادتُه الشّمس، هناك “يغفو كطفلٍ يخاف على لعبته أن تضيع”. ص: 54، مطلقاً سؤاله الموجِع:
“فأينَ الذي يدفعُ الشرّ عنّي؟/ وأينَ الذي عن بقائي يزود؟” ص: 54.
تتلاحقُ الصورُ والانفعالاتُ والدلالاتُ في هذا الفضاء (الأوّل)، حيث نرى بين صمت السّواقي، وارتعاش الجفن والكأسِ المشظّاةِ، وبين الحزنِ واليُتم، نرى علي نسر يتنقّلُ منتظراً مجيء طيورٍ مهاجرةٍ تحاول أن ترشفَ بعض الخمرةِ من أبوابٍ “أتعبها صريرُ العمر في قلقي”. ص: 58. وبين يوسف المنزوي في عتمة ممحوّةٍ، وقميصٍ مزّقته أصابعُ امرأةٍ يُخاطبها قائلاً: “اتركي ما قد تبقّى من حبوبٍ للعصافير/ التي سئمت من الأقفاص والجدرانِ في جسدي”. ص: 85.
“دعي الأحلامَ تحملني على خشبٍ من الأمواجِ/ تتركني لعشقِ النّورسِ المذبوحِ شرياناً بلا عنقِ”. ص: 86.
يتألّم على نسر الذي لم تستطع يده ردّ التحيّة فوق أرصفةِ الشوارع، ولحاف عشقه غيمةٌ، ووسادتهُ حجرٌ، وله قيلولة الفلّاح، فيعلن: “روحي كمرآةٍ محدّبةٍ ووجهي ملعبٌ للريح/ حين تفرّ من أيدي الخريف/ وجبهتي أنشودةُ السّفر/ المعتّق بالحقائب والعويل”. ص: 87.
وحين يرى أنّ للمساء حبراً غدا تميمة بين النخيل، لا يجدُ مفرّاً من السّيرِ نحو مقابر الأحياء، مفتّشاً عن “نبيٍّ، عن جروح الخلّ في رئةِ الرسول”. ص: 88.
رحلةُ الشّاعر شاقّة، منسيّة، فرحه قليلٌ، أتخمت المراثي قلمه، مستمرٌّ هو في قلقه وأغلالِه إلى أن يلتقي نهران في جسده المشظّى، ويصل إلى ذروة الشّعور بالانسحاقِ حين يرى: “قافلةً تجيء من الحروب/ سيوفها ملويّةٌ/ أغمادها مثقوبةٌ/ إبلٌ يشتّتها الدليل/ وأنا البلاد توارثت خبز الهزيمة”. ص: 90.
خلاصة الفضاء الأوّل أنّ علي نسر يواجه الحزن، والوحدة، والغربة، والفقر، والسّلطة، مواجهةً قاسيةً، تضافرت فيها الصّور الشعريّة حاملةً تجربةً نفسيّةً غنيّةً، وهذا ما عبّر عنه فرويد بقوله: “إنّ شعراءنا هم أساتذتنا في معرفة النّفس، ذلك أنّهم يصدرون عن منابعَ عصيّةٍ لا يتيسّرُ إخضاعهم للعلم، فمن طريقهم نستطيع أن نحلّ الإنسان محلّه الحقّ في هذا العالم”.
– الفضاء الثاني: نراه في القصائد: السّفر بين أقواس القزح- خمر الرحيل- حين تسرج البلاد جياد الرحيل- أصابعك شتيت السنابل- وجع من الأسرار- للحب موعدٌ لا ينكسر- شفة من النسيان- دمى الأطفال- عاشقٌ يبحث عن وطن.
في هذا الفضاء يلجأ الشّاعر إلى حبيبته حيث موج يديها يزنّر خصره، هنا تأخذ الحبيبةُ شكلَ الوطن، إذ نرى أنّ بين أصابع الشّاعر “مدناً مغادرةً بيارقها”، ص: 9.
ويختلط الحبّ بالرحيل، بالمنفى، تتسلّل إلى أعماق الشّاعر نسيماتٌ سقيمةٌ، فيلوذُ مجدّداً بحبيبته: “فلتفتحي ما قد تبقّى من ثياب النوم/ عند مواسم العتم الضرير”. ص: 9.
هنا تتراءى للشّاعر نجوم “تلملم الأضواء في أحشائها رحم عقيمة”. ص: 10.
ولا يكون مفعول السّفر سوى الإشارةِ إلى تلال طفولة ممحوّةٍ، “أطلالُها دمعٌ غزيرٌ”. ص: 10.
ودائماً الملاذ الأهم عينا حبيبته اللتان تسرق منهما الشمس ارتحال الوقت. هي الحبيبة التي يطلبُ منها الشّاعر أن تمدّ يديها على جبينه كي يصير نخيلاً، في هذا الفضاء الكثير من التشابيه والتجسيد والتشخيص.
وعددٌ كبيرٌ من أفعال الأمر، لأنّ الشّاعر يطلب الكثير الكثير… وهذا سبب حضور الأفعال: مدّي- لِتمزّقي- فكّي- عرّي- فلترسلي- ولتُعتِقي… أعدّي- روّي- لملمي- غطّي- ضعي- شدّي- عودي- انثري…
لكأنّ الشاعرَ يعرفُ أنّ ثمّةَ في سواقي الأنثى أسراراً، ولذا يطلبُ منها فكّ زرّ هذه الأسرار، علّ “النحلة السّكرى تغنّي على أزهارِ خمرتِها”. ص: 11.
علي نسر الذي يرغبُ أن يصيرَ نخيلاً بفضل يدي حبيبته، ويهوى الرحيل في عينيها، ويريد الدخول إلى عالمِ أسرارِها، ويسعى كي يغفوَ طويلاً على أسوارِ خصرها المترنّحة، يرى نفسَه وبشكلٍ مفاجئٍ “كفراشةٍ عمياءَ” ص: 11. يجيءُ إليها حاملاً موتَهُ المحتومَ.
إنّ ذوبانَ الشّاعرِ في حبيبته يجعله محبّاً للموت، ويعشقُ القنديل رغم معرفته المسبقة بأنّ هذا القنديلَ سيكونُ سبباً لاحتراقِه. إنّ اندفاعة الشّاعر نحو حبيبته لا تحدّها حدود: “سأزيحُ رعشةَ ثوبِكِ الشفّاف/ أنفضُ ما تبقّى من نعاسِ الليلِ/ من أزهارِ صدرِكِ كي تقلّمه خيوط الشّمس/ في شفتي”. ص: 12.
وفي اندفاعته هذه يطلب من المرأة أن تعدَّ له الليل كي يستعيرَ انهمارَ النّعاسِ، وحين تكثرُ المراراتُ في حياةِ الشّاعرِ، وتقسو الغربةُ، ويشتدُّ الوجعُ، وتزدادُ أعداد المعذّبين والمسحوقين، يلجأُ إلى صدرِ المرأةِ، والشعور بالضياع يدفع بالشاعرِ إلى السّير “وعكّازة الغيم تكسرُهُ”، ص: 19. هو يسير، ولكن بلا أيّ أفق، ومن دون أمل، كأنّه فقدَ خُطاهُ، لكنّه من جديدٍ يلوذُ بالمرأةِ، فيطلبُ منها أن تلملم أضلعَه المبعثرةَ.
وابتداءً من اللاجهات، وسكرة البحر، وصولاً إلى مخاصمةِ الليل له، يستغيثُ بالحبيبةِ آمِلاً أن تجمّع في يديه شتيت الحقول، وفي مقلتيه ضفاف السّهول، طالباً منها أن تقمّطه وتشدّ عليه قميصَ اللجام “بحبلِ الورود/ فحبلُ الوريد/ محطّ السّهام”. ص: 41.
كم هو جميلٌ استخدام الجناس (الورود الوريد) للوصول إلى معنى جميل أيضاً حيث الوريد محطّ السّهام.
وفي هذا الفضاء، يحلّق الشوق، خفقان قلب الشّاعر إيقاع أحاسيس لا تهدأ، وردُهُ يئنُّ، دموعُه تسيل، متيّمٌ هو، قمحُهُ تشتّتهُ الريح، يهجمُ عليه المنجل، كأسُهُ محطّمة على شفتيه، وحيدٌ هو، ليس سوى العتم في عينيه، يتوق إلى زورقٍ يحمله نحو الآفاقِ، متمرّدٌ هو على الأسيادِ القابعين في جسدِه، يسعى حثيثاً لينفض الرقّ، ولا يجدُ سوى الحبّ قادراً على بثّ النور في وجه الليل، فهو وحده الكفيل بإرجاع الموعد المهجور.
وأيّاً تكن المواعيد المهجورة، فثمّةَ عاشقان يرسمان ما تيسّر من قلوب، تندفعُ وردةٌ منسيّةُ الأنفاسِ لتحفرَ مقعدهما، فيستعير الشّاعرُ جناحاً من “نورسِ العشقِ المعتّقِ بالسّفر”. ص: 61. ويستعير “ترويض المطر”. ص:61.
كلّ ما في يوميّاتِ الشّاعر مُتعَبٌ مُتعِبٌ: أوجاعُ النّاي، الترحال… لذا يعود إلى المرأةِ طالباً منها أن ترمي يديها على سرير الليل لانتشال الصباح المُستباحِ. وفي رحلتنا في هذا الفضاء تتراءى لنا بيادرُ سنابل الأفراحِ مرهّلة، بيارقها مهدّلة. “فتلك الضحكةُ الحيرى ممزّقةٌ على شفةٍ من النسيان”، ص: 63.
كلّ ذلك يبدو طبيعيّاً ومألوفاً في عُرفِ الشّاعرِ، إذ: “جراحُ الحبّ لا تشفى بغير صليب”. ص: 64.
ويبدو علي نسر محدّقاً مليّاً في عيونٍ تلملم بقايا “الفرح المنزوي في حقائب وادٍ مجهّزٍ للرحيل”. ص: 69. فيروح يناشدُ المرأة التي تنسج الصراخ رداءً لطفل العراء، قائلاً: “لملمي عن بقاياه برواز صورته/ علّ كفّيه تلتقيان على بيدرٍ من عصافيرَ/ فرّت من الموتِ نحو الحقولِ”. ص:70.
وإذ يُصابُ بطلقةٍ عمياءَ يظلُّ موعوداً بأن تنقذَهُ “حبيبةٌ مصلوبةٌ عند المرايا/ لم تزل موعودةً بضفيرة/ بيضاءَ ما ملّت من المرآة”. ص: 81.
إلّا أنّ الشعور القاتل هو قوله: “سفنٌ ممزّقةٌ على أسوار أندلسٍ/ وترميني إلى وطنٍ بلا وطنٍ”. ص: 81.
غير أنّ الملاذ الحقيقي عينا حبيبته حيث يسكن في بحارهما وبرّهما بعيداً من صراخ الطوائف، ساعياً إلى نبذ العصبيّات الدينيّة التي لا تُنتِجُ سوى الدمار والتشرذم والصراعات التي لا تنتهي.
خلاصة الفصل الثاني، أنّ حضور المرأة كان قويّاً ولافتاً مع استخدامِ الكثير من الإيحاءات والرموز والاستعارات، وأفعال الأمر، وأنّ الحبّ وحده الكفيل بإعادة الحياة إلى الحياة.
– الفضاء الثالث هو عالمُ الطبيعة، فبعد أن لاذَ الشّاعرُ بالمرأةِ طويلاً وسيستمرُّ، يلوذُ بالطّبيعةِ، فها نحنُ على إيقاعِ الرّبى، نرى بقايا الشّمسِ والحبق تنزرعُ في شرايينه، وحين تعرى أيّامه فإنّ ثيابَ اللوزةِ العذراءِ تسترها، وحين تغدو مراكب عشقه ممزّقةً، تبرعُ الأوجاع نحتاً في يده الكلمى: “كأنّ يراعةً نزفت قُبيلَ الطّلق/ من أصوات حُرقتِها يجول الحبرُ في الوَرَقِ”. ص: 68.
في هذا النزف، يستحضرُ الشّاعرُ طفولتَهُ، يذوبُ كشمعةٍ في مكتبٍ، يتذكّر روابي كان يجوبها، نحلةً كان يراقصها، عصفوراً كان يحضنه بعد عناءٍ طويلٍ، زعتراً كان يلثمه في المنحنى، يستحضرُ سراجَ الليل، اقتفاء أثر النجوم، هو المتّكئ زمناً على أكتافِ الحساسين، يقطفُ وردةً منسيّةً، ولأنّه مثقلٌ بالشوقِ والوجعِ، توّاقٌ للغزو ولو بِقُبَل قليلة، يرى الأوقات تتثاءبُ في شعرٍ، يغفو على خصرٍ، وحين يشعرُ بالطمأنينةِ، تخرجُ ضحكته ممزوجةً بالبرتقالِ، ويسيرُ الشّاعر بين تجاعيدَ “متّكئاً على عصا الأزمان” ص: 77. فتنكسر به الطرق، لكنّه يلتجئ إلى الندى علّه بذلك، ينعش روحه، فيخرج من يباسٍ ما إلى اخضرارِ الفكرةِ والمسير.
ونبقى في الفضاء الثالث، حيث الحضور الهائل للألفاظ: نبع- ورد- الليل- زهر- حديقة- أرجوحة- ألحان- أشجار- نهر- سنبلة- سحب- بحر- بئر- بستان- ريح- صفصاف… إلخ.
هنا، ومع حضور الطبيعة القوي، تحضر الرومانسيّة لغةً وصوراً، ونصل إلى بيتٍ يشكّلُ ذروة التشكيل المكاني: “أخفيتُ في صدركِ البستانَ مؤتمِناً ما أخفت الريحُ في الصفصافِ من سرِّ”. ص: 84.
في هذا الفضاء، يعمد الشّاعر إلى استخدام الكثير من الصور الشعريّة للتعبير عن أفكارِه، وهو يتقن فنّ التصويرِ: “متصفّحاً في دفترِ الطرقات/ ألتقط الحصى من جيبِ وادٍ/ أهمل الرعيان ضحكته/ تهدّل فيه نايٌ مُتعب الأنفاسِ/ منكسراً يتيم”. ص: 91.
ومع تعبِ النّاي، وأنين الورد، وانحنائه متعثّراً بالآه، يبقى لدى الشاعر ذاك الصوت الحرّ:
“صوتي تنهُّدُ نسمةٍ في صيفِ قافيةٍ/ وأوردتي أراجيحٌ لمن عصر التأوّه/ في خوابٍ من خريف”. ص: 92.
صورٌ تلاحقُ الشّاعر إلى مثواه، قلبه رزنامةٌ للدمع، ضلوعُه تعبى، المناديلُ تلوّحُ، لكنّ الأشرعةَ بلا مستقبلين، رغم كلّ ذلك، لا يملك الشّاعر إلّا أن يواجه مدوّناً ما تبقّى من سماتِه، معلناً: “امتدّ أغنيةً كميناءٍ تثاءب فيه/ موجٌ أو رصيفٌ”. ص: 93.
إلّا أنّ شجر العمر المثقل بالمتاعبِ والأحزانِ، وبالشعور بالغربةِ، لم يُبقِ من لحنٍ عليه “سوى تنهيدةِ الأغصانِ أشعلها الحفيف”. ص: 93.
يؤكّد عزّ الدين إسماعيل أنّ التشكيل المكاني في القصيدة كالتكشيل الزماني، معناه إخضاع الطبيعة لحركة النّفس وحاجتها، عندئذٍ يأخذ الشّاعر كلّ الحقّ في تشكيل الطبيعة والتلاعب بمفرداتِها، وبصورها، وفقاً لتصوّراته الخاصّة، وقد قيل في هذا المعنى: “إنّ الفنّان يلوّن الأشياءَ بدمه”.
– الفضاءُ الرّابعُ هو الحنين إلى الطفولة وعالم الأحلامِ، في بحرٍ أتعبتهُ سطوةُ الأملاح، يجثو علي نسر عاشقاً بين المسافةِ والصّهيل، وإذ يتصدّعُ الموعدُ، ويبقى الشبقُ يناورُ داليةً تشقّقَ جلدُها، تلاحقه الريح، تداهمه السّيول، يقلقه شتات الأفكار، تخيفه مناجلُ تستبيح رؤوسَ قمحِه، فلا يجدُ مغيثاً له سوى دمعةِ الأقلامِ تنسكبُ منهُ أغنيةُ الطفولةِ، إلّا أنّ حيرةً وتوتّراً يصيبانه فيصرخُ: “هل واقفٌ أنا في الزمن/ أم واقفٌ زمني؟” ص: 27.
رغم تعثّر الشّاعر بشهيقِ عشقه عند أسوارِ الأساطير البعيدة، ورغم أنّه يغفو على وجعٍ من الأسرار، ورغم سقوط الصباحِ على رصيف الليل، وانكسار عصا موسى قبيل النار في جسده، يبقى لديه سؤالٌ يستطيع أن يخضّ به وجدان الوجود: “أمّي لِمَ التأخيرُ يا أمّي؟” ص: 57.
أعيدي مقلتيكِ فذا طريقي معتمٌ”. ص: 57.
إنّ تناحرَ الأفكار يقلق الشّاعر، ولأنّ الفكر نقيضُ الجهل، فقد أتعبَه، فراحَ يلحُّ على أمّه أن تعيدَه إلى تلكَ الفطرة الأولى. ويتمنّى لو يعود طفلاً “لم تزل تغريه أثداءُ الغمام”. ص: 78.
– الفضاء الخامس هو الأنا العاشقة والمواجِهة.
تتحرّكُ الأنا بين أجفانِ فجرٍ مُصابٍ بنعاسٍ، وأزهارٍ تتوضّأُ، محاولةً العبور من شبابيكِ الغيومِ إلى عالمٍ مليءٍ بالثنائيّات الضدّيّة، وبحسّهِ الإنسانيّ يتمكّن الشّاعر من الخروج من الأنا الفرديّة، ليصبحَ وطناً بكامِلِه، لكنّه الوطنُ المتعثّرُ بالموت، حيث البلادُ من الملح، والمرايا المهشّمةُ تشيرُ إلى اللاجهات، “بلادٌ يشتريها جرادٌ غفير”. ص: 23.
يرى الشّاعرُ كلّ ذلك، لكنّما “عيناه وادٍ سحيقٌ كسرٍّ دفينٍ”. ص: 24.
عبر هذه الأنا، يرثي الشّاعر مسرّاتِه، تضيعُ مرساتُه، تبكي المسافةُ، تغدو ذاكرته في غسقٍ مذبوحٍ، جرحه مملحةٌ، ويصل إلى مكانٍ يرى نفسه فيه ماشياً على الأشواكِ من دون أيّ أملٍ في الوصول إلى الهدف المنشود: “غدوتُ أمشي على الأشواكِ مرتقباً جفن النعاسِ وما حنّت وساداتي”. ص: 32.
الشاعر الذي يسرجُ من لعب الأطفال أحصنةً تتلاشى أحلامُه: “وجدتُ كأسي على ثغري محطّمةً كأنّما محت الأحلامَ ممحاتي”. ص: 32.
هذه “الأنا” تجعل الشاعر يستمرّ في شعوره بالعشق، بالضوء المنبلج في الأسحار، حيث يغدو مبعثراً بين الربى، وحين ينامُ تحرسه الأطيار، وإذ يكمل اشتعاله “تنحني النجماتُ فوق يدي/ كيوسفَ/ مزّقت قمصانه/ امرأةٌ وفي يدها/ نواجذُ ذئبةٍ/ والثغر بركانٌ تفجّرهُ النيوب”. ص: 80.
ورغم تعكير الجبّ العميق وسامته، وانهمار السياط على جبينه في محاولةٍ لإجباره على التوبة، إلّا أنّ الشّاعر لا يتوب: “فهل يتوبُ النورسُ المجروحُ/ من عشقِ البحار”. هنا يحضر “الإنسان الجديد” الذي يدعو إليه أدونيس والتموزيّون، هو الإنسان المتألّه كإنسان جبران خليل جبران. يُلغي الترهيب والترغيب بينه وبين الله، يتّحدُ النّاسوتُ باللّاهوتِ، فُتُلغى العفّةُ والتوبة، وهذا ما رفضته التموزيّة من جعل الإنسان عبداً لله.
ومن تجلّيات الأنا هذه، انتقالٌ مفاجئٌ من مخاطبةِ المذكّرِ إلى مخاطبةِ المؤنّثِ “يا حادي التنهيد”، “على كفّيكَ حين تراقص النّار انهمار الثلج منهكة”، “فمن شفتيكِ مندلقٌ هسيس الجمر، تندلعُ ابتسامة كستناء”.
هذا الانتقال المفاجئ يحمل في طيّاتِه نارَ الشوق الذي جعله غير قادرٍ على الانتظار، ليعودَ فينتقل من مخاطبةِ المرأةِ مستغيثاً، إلى طرحِ قضيّةٍ حسّاسةٍ، ولكن معظم بني البشر الذين يمتلكون نسبةً من الوعي والثقافةِ والمعرفةِ، يُعانون من مخاطرها، وهي لجوء عددٍ كبيرٍ من النّاس إلى ممارسةِ طقوسٍ دينيّةٍ خاويةٍ خاليةٍ من أي ملمحٍ إيمانيٍّ حقيقيٍّ: “بشرٌ لا يريدون من دفتر الله/ غير فتاتٍ من الكلمات”. ص: 42.
والشّاعر هنا يطرحُ هذه الإشكاليّةَ بجرأةٍ ووعيٍ، هادفاً إلى إصلاحٍ لا إلى تهجّمٍ عشوائيٍّ:
“فيا ربِّ أطلق رؤاكَ عليَّ تجلَّ/ لعلَّ السّماءَ ستُهدي خطايَ لعلَّ”. ص: 43.
هكذا نلاحظ التكامل بين “أنا” العاشقة، و”أنا” المُواجِهة.
إشارة إلى أنّ ضمائرَ المتكلّمِ “أنا- التاء- والياء”، والأفعال العائدة إليه وردت (597) خمسمائة وسبعاً وتسعين مرّةً، وهذا رقمٌ كبيرٌ قياساً بحجمِ المجموعةِ الشعريّةِ.
يأخذك علي نسر إلى فضاءاته على أجنحة الصورة، والفكرة، والليل، والرّيح، والوديان، والعشقُ، والترحال، حاملاً مفاجآتِه مرّةً بقافية، ومرّاتٍ بإيقاعاتٍ داخليّةٍ آسرةٍ. فالقصيدة عنده تدفّقٌ لا يهدأ، حتّى إنّك تشعرُ بالحاجةِ إلى أخذِ قليلٍ من النّفَسِ، قصائدهُ مُهندسةٌ بحرفيّةٍ عاليةٍ.
تبقى الإشارة إلى أنّ المفردات التي كان لها طغيانٌ في القصائد هي: الليل (44 مرّة)- الرّيح (36 مرّة)- الغيوم (35 مرّة)- العشقُ والحبُّ (35 مرّة)- الترحال (24 مرّة)- الموتُ (21 مرّة)- الوديان (13 مرّة)- الحزن (12 مرّة)- الطفولةُ (10 مرّاتٍ)- المهجور (9 مرّاتٍ)- المنفى (7 مرّاتٍ)، بالإضافةِ إلى حضورٍ لا بأس به لمفردات: الشّوق- القلق- النجوم- الخريف..
في الظاهر، يستخدمُ الشاعر مفرداتٍ متداولةً، إلّا أنّه كان ماهراً في إقامةِ علائق بينها غير متداولة، وهذا ما أعطاها قيمتها الشعريّة، كما تقولُ الدراساتُ الأسلوبيّةُ. أمّا على صعيد الوزن والإيقاع، فقد جاءت القصائد على الشّكل الآتي:
– إحدى عشرة قصيدةً على تفعيلة “متفاعلن وجوازاتها.
– أربعُ قصائد على تفعيلة “فعولن وجوازاتها”.
– قصيدة واحدة على تفعيلة “مفاعلتن وجوازاتها”.
– ثلاث قصائدَ عاموديّة على وزن “البسيط”.
رغم أنّ الشّاعر لم يتوسّع في تنويع الأوزان، إلّا أنّ ذلك لم يقف عائقاً أمام قدرتِهِ على استخدامِ إيقاعاتٍ داخليّةٍ، حيثُ نجدُ أنّ موسيقيّة النصّ موظّفةٌ توظيفاً متقناً، إنّها موسيقى وجدان الشّاعر وحالاتِه وانفعالاتِه، وهذه سمةٌ أساسيّةٌ من سمات النصّ الشعريّ الحديث. في “وطنٌ تنهّدَ من ثقوبِ الناي”، ينفر علي نسر من السلطات السياسيّة والدينيّة، لكنّه ينحازُ إلى عناصرِ الطبيعةِ، وهو في جميعِ محطّاتِه المفصليّةِ، في متاعِبِهِ، وأوجاعِهِ، في خوفِهِ وقلقِهِ، وفي حزنِهِ الملازم له، لا يجدُ سوى المرأة منقذاً وملاذاً.
ولقد رأينا الشّاعر في هذه المجموعة رومنسيّاً حيناً، ورمزيّاً حيناً آخر، ثمّ سورياليّاً في بعض القصائد، وهذا ما يتركُ انطباعاً عن حرصِ الشّاعرِ على أن لا يكونَ أسيرَ مدرسةٍ أدبيّةٍ بعينها، أمّا القلق الفكريُّ، والقلقُ الوجوديُّ اللذان رافقاه في معظم نصوصِه، فقد شكّلا النّار الإبداعيّة، “إذا تجرّدَ الشّاعر من قلقه، أو شفي منه، يقضي على أعظمِ مصادر إبداعه”، كما يقول الأب الدكتور ميخائيل قنبر في حديثه عن القلق عند الشّاعر الرّاحل جوزف حرب.
