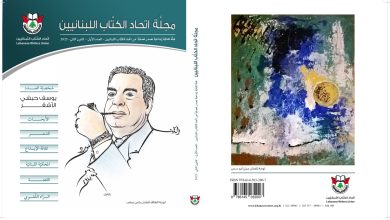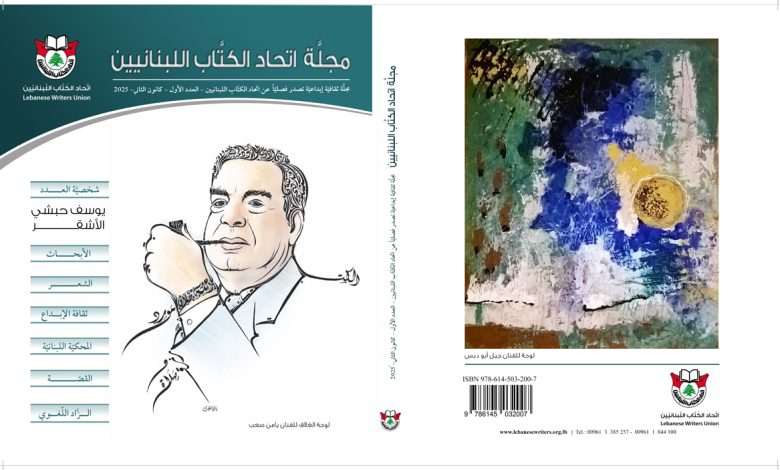
لوتشيا…
جهاد شاهين
قلتُ لكِ وأنت تقترين مني وتشاركينني تأمُّلي للَّوحة: المرأة شجرة الحياة.
قلتِ أنتِ بلكنتك العربية المكسَّرة: بل المرأة قصيدة الحياة -قلتِها هكذا “كسيدة” وأنتِ تحدقين في وجهي ملياً وعلى ثغرك ابتسامة مختبئة.
في المركز الثقافي الروسي كنا، وكنتُ ممن دعوا إلى مشاهدة معرض رسم. كان الرسَّامون والعارضون من مختلف الجنسيات، ومن بينهم صديقتي اللبنانية التي دعتني.. وكنتِ أنتِ. حين اقتربتِ مني كنتُ واقفاً أمام لوحة رسم فيها خمس نساء عاريات الصدور بخفر، رافعات أيديهنَّ صوب السماء، متَّخذة شكل أغصان الأشجار فيما أجسادهن متخذة أشكال الجذوع. استوقفتني اللوحة دون سائر اللوحات المعروضة، وجدتني أغوص فيها متأملاً ألوانها النارية ووجوه النسوة المختلفة التعابير وتلك الأيدي الأغصان المرفوعة. – أعجبتكَ لوحتي؟
ـ آ.. أنتِ من رسمها إذاً! أعجبتني جداً، أنا أقول إنَّ كل جمالٍ في الأرض نابع من المرأة، نحن الرجال المثقفون يا سيدتي نفتخر مدَّعين بأننا ككتّاب أو شعراء، أو موسيقيين، ما نصدره إنما نابع منا.. لكن هذا فيه مواربة وتضليل كبيران، ففي الحقيقة إنَّ ما نصدره إنما هو نابع من امرأة تسكن فينا.. إمرأة أصبحت بعيدة، لكنها أقوى الحضور.. هي موجودة في كل قصيدة أو قصة، أو مقطوعة موسيقية، أو رسم أو نحت.. هناك امرأة مرت بحياة كلﱟ منا.. سمّيه حبًّا أوَّلاً إن شئتِ.
- إذاً صحيح ما قلته أنا من أنَّ المرأة قصيدة الحياة. أتعلم؟ كتبتُ قصيدة بهذا المعنى، لكنها قصيدة فقيرة أمام ما تقوله.. ها أنتَ أوحيت إليَّ بقصيدة رائعة.. سأعيد كتابتها.
قلتِ جملتك الأخيرة وأنتِ تلتهمين وجهي بنظراتك الفرحة. هكذا، بكلﱢ بساطة قلبتِ الأدوار، جعلتِ من نفسكِ الكاتبة والشاعرة، وقلبتِني من كاتب وشاعر إلى رسام!
كنتِ تنظرين إليَّ وأنت تتحدثين بعربيتك المكسَّرة وكأنك تسكبين الكلمات سكباً. فجأة، ابتسمتِ بمكرٍ نسائيﱟ ظريف ومُحبَّب، ثم فتحت هاتفك الجوال وطلبتِ أن نتصور سوية إلى جانب لوحتك. اقتربتُ منكِ بقدر ما سمح لي ارتباكي، التقطتِ الصورة ثم أرسلتِها إلى هاتفي بعد أن طلبتِ رقمه. مددتِ يدك مصافِحةً وأنت تقولين كما لو كنتِ تسكبين الكلمات سكباً: اسمي لوتشيا غابريليان. قلتُ لكِ اسمي وأردفتُ وأنا أتأمل وجهك: أسعدني الحديث الشجيُّ معك، وأسعدتني الصورة.
ابتدأ توزيع مجسّمات التكريم، ورحت سعيدا أراقب الوجوه الباسمة الراضية المتلألئة تحت الأضواء ومن انكسار نور الشمس المائل المتسلل من النوافذ. وعن غير قصد كنت أعود إلى وجهك وأنتِ واقفة سعيدة إلى جانب لوحتك.. أرسم في كياني ملامح ابتسامتك الباكية، وعينيكِ الغارقتين كما في حلم.
انفضَّ المعرض.. كنت طوال طريق العودة صامتاً برفقة من دعتني، كأنما شيء ما لجمني عن الكلام، واكتفيت ب “جيّدة” عندما سألَتني عن رأيي…
في العشية كنت أشاهد أنا وزوجتي الحلقة ربما السادسة من مسلسل “لحن البحر” بطولة الرائع يوسف الحداد، وبالاشتراك مع عمار شلق.. وبصراحة أنا لست ممن يواظبون على مشاهدة التلفزيون، لكن “الكراكتير” الذي كان يؤدﱢيه يوسف الحداد شدَّني إلى المتابعة، وقلت ذلك لزوجتي..
– وعمار شلق؟ قالت زوجتي محتجة..
– عمار يفتعل الأداء.. أمَّا يوسف، فيؤدﱢي على سجيته، لاحظي حتى عندما يغضب يبدو حقيقياً.
فجأة عادت صورة وجهكِ وأنتِ تحدثينني عن لوحتك وعن قصيدتك المزعومة بقوة، انتفضت واقفا والتفتُّ إلى زوجتي.. سألتها – ورعدة تسري بجسمي وكل عرق فيَّ ينبض- عن مكان صناديق الصور الفوتوغرافية القديمة.
- ما بك؟.. ماذا جرى لك؟
أتى صوتها مختلطاً مع الأصوات الصادرة من التلفزيون..
– أين وضعت صناديق الصور؟؟ أعدت السؤال بصوت أكثر توتراً..
– في السدَّة (التتخيتة).
توجهتُ من فوري بحركة هائجة.. وضعت السلَّم، وتسلقت بيدي الوحيدة إلى السدَّة دون أن أخاف السقوط. رميت صندوقيْ الصُّور من علٍ، هبطت السلَّم وجلست إلى الأرض إلى جانب الصندوقين -اللذين تهشَّما وخرجت مئات الصور منهما- وأنا ألهث كجرذ خائف.
كانت الصور تتوالى.. ذكريات أبهتت بهجتها السنين.. الألوان مائلة إلى الخفوت، والوجوه صارت غير الوجوه. كنت أبحث عن صورة بعينها… الصور تتوالى، والأحداث بلحظة تُسْتَعاد، تفرد لها زماناً في الزمان الضائع.. الصور تتوالى، ويدي ما تفتأ في صعود ونزول.. تفتح وتقلب صوراً.. فجأة تتجمد يدي على الصورة.. كنت فيها شاباً لم يتجاوز إثنين وعشرين عاماً، وفتاة في الرابعة عشر من عمرها، نقف فيها ضاحكين ومتجانبين في غرفة في مستشفى في مدينة موسكو، ممسكين معا بلوحة لي. ويعود تاريخ الصورة إلى تشرين من العام ١٩٨١. كانت ضحكة أول الحياة ووهج الابتسام، والأسنان الناصعة والشعر الأسود الكثيف وبريق النظرات.
رحت شيئاً فشيئاً أغوص في الصورة وأعود بالذاكرة إلى الطائرة التي أقلَّتني إلى الاتحاد السوفياتي آنذاك.. إلى موسكو، وإلى الأصدقاء والرفاق.. إلى صالح عبود الطيّب الذي اهتمَّ بكلﱢ حاجياتي والذي رافقني حتى سلَّم الطائرة.. إلى باسل وطارق والدكتور خليل هارون (أبو الخل) ومحمد شعيب (عُمَر)… أتأمل الصورة والذاكرة تطفو وتتدفق مع الدمع: على مدرج الطائرة، صالح الذي أشرف على سفري يغمرني غمرة وداع.. الطائرة ارتفعت عن الأرض وتوقف الدمع، وانتابني إحساس باللامكان واللازمان.
ليلاً هبطت الطائرة بنا أنا والأربعين جريحاً في مطار موسكو. فتح ربَّان الطائرة الأبواب.. عند الباب تنشقتُ هواء المدينة.. كان هواءً غير الهواء.. تنسمت فيه رائحة البارود والورد والقوة والفخر، أنا الآتي من الوطن المحارب المقاوم الحالم.
كانت سيارات الإسعاف تنتظرنا لتقلَّنا في ليل مشعﱟ كلٌّ إلى وجهته.. كلٌّ إلى مستشفاه.
نمتُ الليل بعد استحمام كما في حلم لأستيقظ صباحاً على صوتٍ أنثوي موسكوفي رقيق يردد: “دوبري أوترا” (صباح الخير)، فتحت عينيَّ ببطءٍ كما الخارج من غياب.. نظرت من حولي، تأملت الغرفة والشبابيك المطلة على مساحة خضراء وعلى السماء الرمادية، تأملتُ الستائر السميكة ووجه صاحبة الصوت الرقيق الأبيض الممتلئ حيوية وابتساماً. رفعت رأسي لأجد طاولة قد وُضِعَت عليها أطباق تحوي أصنافاً عديدة من طعام الإفطار.. ولأجدني مرتدياً بيجاما كحلية سميكة. نهضت ونزلت عن السرير لأجدني في غرفة واسعة فيها سريران آخران وشخصان آخران التقيتهما حين كنَّا بانتظار الصعود إلى الطائرة. محمد عبيد -وكان قصير القامة- ومحمد وهبي، وكان فاره الطول. كُنيا في ما بعد بمحمد المالنكي أي الصغير ومحمد البولشوي أي الكبير.
وتوالت الأيام…
كانت الفتاة ابنة الرابعة عشر في الغرفة المجاورة لغرفتنا، التقيتُ بها خلال نزهة بعد الظهر في حديقة المستشفى -كنت أنا ومحمد المالنكي- وتعارفنا، كانت تمشي على عكاز.. بعد التعارف تأملت وجهي ملياً، ثم قالت لي بغتة وكأنها انتبهت لشيء: “أريد أن أرسمك”. قالتها بلغتها الروسية التي لم أكن أعرفها جيداً. نظرتُ إلى محمد الذي يفهم اللغة الروسية وسألته مستفسراً:
– هي تريد أن ترسمك.
– تريد أن ترسمني؟! وهل تعرف أن ترسم هذه الصغيرة؟ سألته مستغرباً ومستهجناً من خلال رجولتي العبوسة، نقل لها محمد ما قلته، أطلقتْ ضحكة طفولية وهي تنطق بكلمات روسية سريعة.
– ماذا تقول الآن؟ سألته نافذ الصبر.
– قالت ليجرﱢب وسيرى، وقالت أن نأتي إلى غرفتها مساءً.
مساءً، ذهبتُ برفقة محمد إلى غرفتها. استقبلتني بضحكتها الطفولية الباكية قائلةً: “لادنا” وأجلستني قبالتها – لم أفهم وقتها ماذا عنت ب”لادنا” – ثم أخرجت من جارور طاولة ورقة سميكة بيضاء وقلم رصاص.. وشرعت تخربش… كانت تنظر إلى وجهي، تطيل النظر إلى حاجبيْ ضاحكة، ثم تغور في عيني، تبتسم، تومئ برأسها وهي تقيس في الفراغ بيدها المسافة بين عينيْ وأنفي وفمي. ثم تعود لتنكبَّ على الورقة من جديد. كانت أثناء ذلك تتفوه بكلمات متباعدة وقصيرة، وكان محمد ينقل إليَّ ما تقول: “جميل.. حسن.. صحيح.. أحسنتِ”… وكان مأخوذاً بما يجري.
بعد لأيٍ رَمَتْ بالقلم على الطاولة كمن انتهى من إنجاز ما عليه قائلة بتنهيدة: “خاروشي” حسناً. نهضت عن كرسيّها، اتّكأت على عكازها بيد ورفعت الورقة باليد الأخرى وقالت فرِحةً: “سماتري” (أنظرا).. يا للدهشة! كان وجهي تماماً.. بحاجبيَّ الكثين وشاربيَّ الكبيرين والمرتبين.. لقد كان وجهي رسمته ابنة الأربعة عشر عاماً تلك…
كان شعوراً بالفرح والدهشة يخامرني، فيما محمد اتسعت عيناه وهو ينقّل بصره بين وجهي الحقيقي والوجه المرسوم على الورقة، ولم تصدر منه سوى كلمة واحدة كرَّرها مرتين وهو ينهض عن كرسيّه:
– يا لله.. يا الله!!
– ألا تريد أن تصورنا؟ سألته
-أكيد أكيد. وخرج مسرعاً ليأتي بالكاميرا…
الصورة في يدي، وأنا أُبْحر مجدداً في ذلك الزمان.. هذه الفتاة، أيُعقَل أنها أنتِ؟ ذات العينين الواسعتين الغارقتين وجفن عينكِ اليسرى الهابط قليلاً إياه.. ذات الخدين الأملسين المنسابين، وذات الضحكة الباكية… فقط.. فقط الفارق الوحيد هو أنكِ مع توالي السنين ازددتِ جمالاً واتَّسعت التكاوين.. يا إلهي لو تكونين أنتِ. ثم إنَّ اسمك لوتشيا غابريليان وكانوا آنذاك ينادونها بلولو وأحياناً غولا..
أيعقل.. أيعقل أنها أنتِ؟؟
الصورة في يدي وهاتفي مثبَّت على رقمكِ، كالأبله أنقّل بصري بين الصورة الورقية العتيقة وبين صورتنا معاً أمام لوحتك.. كما صرخ أرخميدس صرخته المشهورة: “وجدتها” صرخت: أنتِ.. هي أنتِ. ورحت أغوص في تكاوينكِ الآن وتكاوين تلك الفتاة الصغيرة غولا التي هي أنتِ، صرت أبعّد الصورة وأقرّبها، ليس لأجد الفرق، بل لأنفي كل ما يبعث على الشك.
حملت هاتفي وقلبي يخفق بتسارع واضطراب.. وبأصابع مرتعشة كتبت لك الرسالة التالية: “هل كنتِ في مدينة موسكو عام ١٩٨١؟” أرسلتها وانتظرت نصف دقيقة.. دقيقة كاملة حسبتها دهراً. لم تجيبي رغم أنك قرأتِها، الخطين الأزرقين وشيا بأنك قرأتِها.. أعدت إرسال الرسالة مرة ثانية وانتظرت.. لا جواب.. بقي هاتفكِ غارقاً في صمت بهيمي.. وكلما طال الصمت والوقت تعاظم إصراري والحاحي. قرَّبت الصورة الفوتوغرافية الورقية، صورتها على هاتفي وأرسلتها لك. أإستفزَّتك الصورة؟ أم أنَّ إصراري أتعبك؟ لست أدري! إذ فور تلقيك الصورة أرسلت لي الرسالة التالية: – مرحبا .. لا، أنا كنت في أرمينيا ما بين عامي ١٩٩١ و٢٠٠٠.
أتى جوابك كأنَّ إبريق ماء صبَّ على رأسي، خمَدتْ مشاعري وغرقتُ في همود وخيبة وسرحان. بقيتُ أتأمل الصورتين بضياع وبدون تركيز كأنَّ شاشة من القماش وضعت بين ناظريَّ وبين الصورتين. تركت الهاتف والصورة، بل رميتهما رمياً. رحت أفكر بصوت عالٍ: لكنه الوجه ذاته.. الملامح ذاتها.. ذات الشفتين والخدين والعينين.. ثم ولون البشرة والجفن الهابط ذاته. وإذا ما قورنت الأعمار بمرور عدد السنين فالأعمار متطابقة أيضاً، هل كلُّ هذا مجرَّد تشابه؟.. لا.. لا يا غولا، هذه أنتِ، ولكن، لأي سبب تسرقين مني أربعين سنة من الجمال ووهج الحياة وكانت ضائعةً وقد وجدتها مجدداً؟
أنتِ تكذبين يا غولا، إذ لم تستطيعي أن تنفي سفرك، بل غيَّرتِ هوية المدينة مواربة، وتلاعبتِ بالتواريخ ! لمَ يا لوتشيا؟! لو قلتِ “أنا هي”، ما الضير في ذلك؟ أما كانت لوحة للحياة رائعة أهديتني إياها؟ لا، أنت تكذبين.. ربما تلك الفتاة ليست أنتِ، أو هي أنتِ لكن السنين اختلفت بالنسبة لك.. العمر اختلف.. واختلفت طرق الحياة فواربتِ.. ربما هي كذبة زمن.. لا يهمُّ الآن إن كنتِ هي أم لا.. فقد انقطع خيط الزمان بنا. وبكلﱢ الأحوال يكفي أنكِ قد أعدتني ولو بالحنين إلى روسيا وثلجها الدافئ وتلك الأمسية.. إلى شوارع موسكو النقية.. إلى تلك المستشفى وتلك الفتاة ابنة الرابعة عشر، أقف قبالتها من جديد.. ترسم وجهي.. تخربش على الورق، تنظر إليَّ، تومئ برأسها وضحكتها الباكية لا تغادر وجهها…