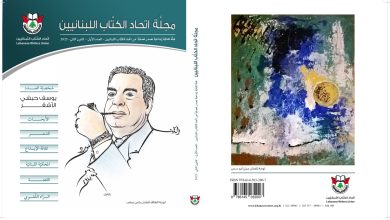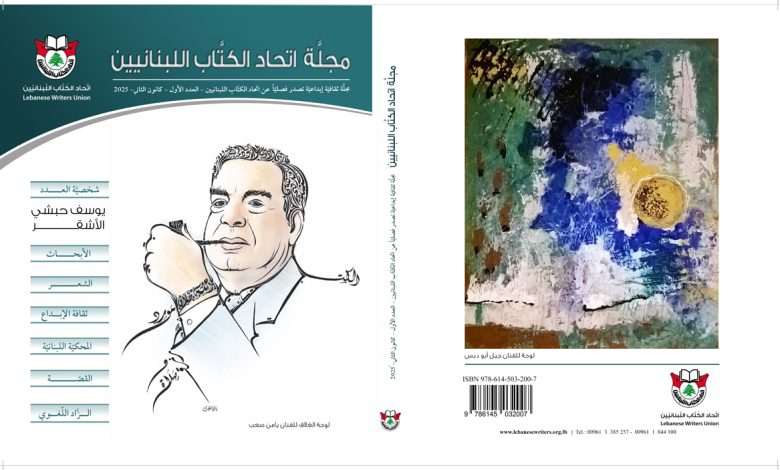
أمُّ ماجد وقمصان الورد الجوري… ملحمة العشق الذي لا ينتهي
أ. د. علي حجازي
لم يكن صباح الحادي والعشرين من شهر أيَّار صباحاً عاديّاً. الأناشيد الثورويَّة تنساب إلى روحه مثل ماء بارد في صحراء يروي عطش روحه الظمأى إلى نصر.. نصرٍ واحد مشتهى منذ زمن، وتحقَّق لهذه الأمَّة الآن.
وقف في منتصف الغرفة. انتصب مثل رمح منتشياً بوقع تلك الأخبار التي تبثُّها تلك القناة احتفاءً بهذا الحدث الكبير والعظيم.
“الآن تحرَّرت البلدات والقرى.. وصلها الأبناء الأعزاء بعدما طهَّر ترابها أولئك الأبطال المنذورون للدفاع عنها وعن أهلها الذين تمَّ إبعادهم بعد ذلك الاجتياح الكبير في حزيران ١٩٨٢” (قال المذيع).
خلع قميصه ورماه على الكنبة المجاورة لتلك التي تجلس عليها أمُّه المُقعدة والضَّريرة في آن. نظر إليها باستهجان كبير؛ فعيناها -اللتان فقدتا البصر منذ ذلك الزمن الذي احتلوا فيه أرضنا- تذرفان دمعاً يتلألأ على خدَّين رسم فيهما الحزن والهمُّ، ومغادرة الأرض والبيت والورود الجوريّة -التي غرستها بيديها، وسقتها ورعتها قبل ذلك الإبعاد الأخير- خطوطًا كثيرة تحتاج إلى قارئ ماهر لاكتشاف ما تحمله من رموز .
أسرع يطبع على خدَّيها ويديها ورأسها قبلات عديدة، وسألها:
– أتبكين الآن يا أمّي؟ وهذه اللحظات تبعث السعادة في قلوبنا نحن العشاق، عشاق الأرض والنصر والأبناء الأوفياء أسخياء البذل، بذل الأرواح والدماء؟
هزَّت رأسها وأجابت:
– إنَّها دموع الفرح يا حبيبي، لا عليك. تعال إلى حضني يا ماجد.
أحسَّ وهو يجلس قربها، ويضع خدَّه على ركبتها أنَّه عادَ ذلك الطفل الذي كان يأنس بوقع أناملها وهي تتلو عليه المعوّذتين، مع أنّه يقارب الخمسين.
أدنت رأسه من حضنها، وأخذت تمسّده بلطف، وشرعت تقصُّ عليه:
– أنت تعرف يا ماجد أنني والمرحوم والدك “مشينا حتى حفينا” كما يقولون، من أجل بناء البيت، ليكون ستراً وغطاءً لنا جميعاً. فأنا كنت أنقل الباطون على رأسي، ووالدك ينقل الحجارة في عزﱢ (الشوب) والحرارة المرتفعة، وكنَّا نعمل من “الفجر للنجر” في زراعة التبغ التي أتعبتنا جميعاً من دون أن تسدَّ طموحنا إلى حياة كريمة. ثمَّ غرس والدك التين والزيتون، والرمَّان والليمون، وزرع العدس والحمص والفول والبطاطا والبصل والذرة الصفراء، والذرة البيضاء التي كنَّا نطحنها لتنوب عن القمح المفقود. وكنَّا نزرع شتلات البندورة وكلَّ ما يلزمنا لتأمين المونة. وأنا كنت مهتمة بزراعة الأزهار والورود، ومساكب الملوخية. كلُّ هذا التعب (راح ضيعان) عندما اجتاحتنا إسرائيل مرَّتين قبل اجتياحها الكبير سنة (التنين وتمانين)، ففي سنة (التنين وسبعين) وسنة (التمانية وسبعين) وسنة (التنين وتمانين) ذقنا المرَّ، وتهجَّرنا من دون أن نحمل من أثاث البيت والمونة شيئاً. أنا بكيت طويلاً لفقد كلﱢ ما ذكرت، وطبيب العيون نصحني بعدم مواصلة البكاء. ولكن الدموع وحرقة قلبي المتأتية من استضعافنا من قبل اليهود، جعلاني أفقد السيطرة على مشاعري، وأزدادُ بكاءً.. دموعي، حارة وباردة ، كانت تنحدر على وجهي رغماً عنّي؛ فالقهر صعب والاحتلال أصعب.
نعم، فدموع الحزن ذرفتها حارَّةً؛ أمَّا دموعي الباردة التي كانت تنهمر أيضاً فمردُّها استعادة الروح التي بدأت تعود بفضل بشائر المقاومة.
نعم، فعندما كان “الشباب” يهاجمون موقعاً أو دوريَّةً، وكنت أسمع صراخ اليهود وعويلهم، وأراهم مشلوحين على الطرقات. أنت تذكر ما حلَّ بالدورية التي كان أفرادها يبكون على إسفلت ثكنة مرجعيون، أو ينتشرون أشلاء جرَّاء عمليَّة بطوليَّة استشهادية. كنت أضحك حتى البكاء. يا الله ما أجمل سماع عويل المفتري والمجرم والظالم يا حبيبي!
هؤلاء المجرمون كم شابّاً علَّقوا على عمود التعذيب في معتقل الخيام؟ وكم صبيَّة قصُّوا شعرها، وحجزوها في زنزانة ضيقة؟ وكم بيتاً هدموا في الجنوب والبقاع الغربي والبقاع وبيروت وفي غير مكان من هذا الوطن؟ لقد ذكرت لك ما يعنيه البيت لنا، ولم يكتفوا بذلك، فعندما وصلوا إلى بيروت محتلّين ساقوا الشباب والصبايا الرجال والنساء إلى المعتقلات، ولن ننسى عذابات هؤلاء الأحبَّة في أنصار والريجي في النبطية – كفر رمَّان والخيام في لبنان وفي سجن عتليت وغيره في داخل فلسطين المحتلَّة أيضاً.
أنا وغيري لن ننسى ما فعله عملاؤهم الذين كان اليهود يسمُّونهم “الكلاب” وكم تحمَّل الأهالي منهم العذابات والإهانات. لن أعدَّ لك أسماءهم؛ فاللائحة طويلة يا ماجد. ولكنَّني أذكّرك بما كانوا يفعلونه بالمعتقلين. كانوا يحضرون أخت المعتقل أو أمَّه أو زوجه ويهددون بالاعتداء على الواحدة منهنَّ إن لم يعترف. أنت لم تر ذلك المشهد القاسي الذي يفتت القلوب والأكباد ويعمي العيو ، مشهد ذلك الشاب الذي سحلوه. ربطوا قدميه بحبلين موصولين إلى سيارتين سارت كلُّ واحدة منهما باتجاه. يا حزني عليه… كلُّ هذا مع مشاهد أخرى صعبة وقاسية في آن تعرفها، جعلنا نبكي بدل الدموع دماً. وقبل أن أتوقَّف هناك سؤال ردَّدته كثيراً سأعيده الآن، وهو:
لماذا يُقوم الظالمون باحتلال أرض غيرهم، ثم يعمدون إلى قتل الشباب وسوقهم الى المعتقلات، ويطردون الناس من مدنهم وبلداتهم والقرى؟ أيُّ شريعة تحلّل هذا الاغتصاب وتشرﱢعه؟
هذه المشاهدات القاسية التي عرضتها الوالدة والمتناغمة مع ذلك مع أناشيد التحرير وألحانها الثورويَّة دفعت به إلى منتصف الغرفة حيث أدام النظر إليها غير مصدﱢق. كانت تضغط بيديها على جنبي الكنبة تحاول الوقوف…
– يا الله ما أجمل هذه المحاولة! لقد عاد نسغ الحياة يسري في جسد أمّي الآن.
قالها ودمعت عيناه. بسط كفَّه وشرع يشكر الله على كلﱢ ما تحقَّق.
أقواس النصر، وزغردات العائدات، وعناق الواصلين مع مشاهد العزﱢ والفرح والفخار، التي لا تزال تُبثُّ من شاشة التلفاز تلك تحفّز عينيه على ذرف دموع الفرح البارد الذي باحث به أمَّه قبل لحظات .
– حبيبي ماجد:
متى نطلع إلى البلدة؟ فأنا لم أعد أملك الصبر على البقاء هنا بعيدة عن البيت والورود والشجرات.
– إنَّنا ننتظر اكتمال التحرير وحضور الفرق الهندسيّة التي تعمل على تنظيف الأرض من الألغام والقنابل العنقودية والشظايا، وننتظر انتهاء عمليات تطهير الأرض من اليهود و”كلابهم”.
– لا شكَّ في أنَّ الشظايا قد مزَّقت الوردات والشجرات. أليس كذلك يا حبيبي؟
– الوردات وأغصان الشجر تتجدَّد كلَّ عام يا أمّي، لا تحملي همّاً.
– ومن يسقيها؟ فالورد عاشق الماء..
– لا تنسي، فقطرات الندى تكفيها. قال ذلك وأطرق يفكّر في أسئلة أمّه التي راحت تترجَّع في ذهنه، فأخذ يهمس:
“صحيح، ما الذي أصاب البيت والشجرات والورود، والأثاث والشبابيك والأبواب؟”
لحظات من التفكير في البلدة والبيت مرَّت. لاحظ بعدها ارتعاشاَ في رجليه، حدَّق إليهما، فإذا بهما تندفعان مثل رِجلي راكبِ دراجة.. هبَّ واقفاً.
– أمّي، أغادر قليلاً وأعود.
– رافقتك السلامة يا حبيبي.
في الطريق إلى البلدة، كانت مظاهر العزﱢ تنعش روحه وبصره في آن؛ فدبابات الميركافا -“عربات الربﱢ”- مشلوحة إلى جانبي الطرقات، والأطفال يلهون بها ويدوسون أعلامها المنكسرة.
بعد أقلَّ من ساعة وصل إلى حارتهم التي رفعت راحتيها تشكو إليه ما حلَّ بها من إهمال متطاول. وقف أمام البيت غير مصدﱢق ما يسمع ويرى في أرض خلعت توّاً عن جلدها ثوب الاحتلال المقيت. الزغاريد التي تُطلقها الصَّبايا العائدات تنسرب إلى سمعه مثل لحن فريد منتقى وتسري في دمه سعادةً مذابةً، وزخَّات الرصاص التي تطهّر الأرض تعزف في سمعه أجمل لحن يعزفه عشاق استثنائيُّون في هذا الزمن، إنَّهم فتيّة آمنوا بربّهم” “فأعاروا الله جماجمهم، ووتدوا في الأرض أقدامهم”، فانبلج النصر بهيّاً من بين فروج أصابعهم الضاغطة على الزناد أبداً.
عرك وجهه وأخذ يهمس :
– ليتني اصطحبت أمّي إلى البلدة ليتني؛ ولكن الحذر واجب في ظلﱢ اشتباكات لم تنته بعد.
نظر إلى الأرض التي سيبني عليها البيت الجديد الذي سيضمُّه وأفراد أسرته وشرع يتصّوَّره منجزاً. كانت رغبته في مصافحة أطباق الجوري شديدةً، ولكن كيف يصل إليها؟ فالأشواك تغطّي وجه الأرض، والخوف من القنابل العنقوديَّة يشغل باله..
ألقى نظرةً إلى العريشة التي احتضنت عناقيدها وماتت متأثرة بأنفاس أولئك الأنجاس، وببارود قذائفهم القاتل. زاغ بصره الذي تعانق مع أغصان شجرات الزيتون والليمون والرمان التي مزَّقتها الشظايا.
أشاح بصره عنها ومسح دمعتين، واستدار ناحية أطباق الجوري التي كانت ترنو إليه بحنوﱟ كبير غيرَ مصدﱢقة رؤيته هذه الساعة، فشرَّع يديه وأسرع لاحتضانها غير عابئ بالأشواك وبمسامير القنابل المسماريَّة التي لا تزال عالقةً في الأبواب والشبابيك.. بسرعة وصل، وكان العناق الحميم المشتهى بينهما .
أخذ يشمُّ أطباق الورد الجوري الأصيلة التي لم تصلها أيدي المتلاعبين في جيناتها بعد.. هذه الرائحة “تشقُّ القلب” كما يقولون.. أخذ يقطف من مساكب الجوري أطباقاً ويتصوَّر ذلك اللقاء الجميل بينها وبين أمّه وسط زقزقات تلك الدَّواري التي شاقها غيابه، فراحت تمارس رقصتها المفضَّلة إعلانًا عن ترحيبها به.
في بيروت، أسرع إلى أمّه، فوضع أطباق الجوريّ في حضنها.. ولمَّا عبقت رائحتها الأخَّاذة، راحت تمرﱢر كفَّيها على خدوده ببطء، وسرعان ما التحم وجهها بوجوه تلك البتلات العطشى؛ والتي أسرعت ترتوي من دموع أمﱟ غرستها، وحنت عليها طويلًا.
أجل. بكت الحاجَّة أمُّ ماجد.. ثمَّ قالت بصوتٍ عالٍ:
– هذه من بلدتنا يا حبيبي. لماذا لم تصحبني معك، لماذا؟ أتخاف عليَّ يا قلبي ولا تخاف على نفسك؟ هذه من ورداتنا، من مساكب جوريَّاتنا، أنا أعرفها. شكراً لك يا الله، والشكر لأولادنا الذين طردوا الأنجاس وكلابهم وأعادونا أعزَّةً إلى أرضنا.
رفع ماجد كفَّيه إلى السماء وراح يدعو:
– يا الله يا عظيم، يا رادَّ يوسف على يعقوب ردَّ بصر أمّي عاشقة الأرض والبيت والشجر، والورد الجوري، والأرض التي استفاقت سعيدةً وهي تأنس بكفوف الأبطال الميامين الذين مسحوا عن وجهها آثار الأقدام الهمجيَّة الموغلة في الدم وشهوة القتل.
أرجوك يا الله أرجوك يا قدير…
عند انتهائه من الدعاء كانت المفاجأة كبيرة حيث قالت أمُّه:
– أنا الآن أرى يا ماجد، أرى وجهك الممتلئ فرحاً مرَّتين هذا اليوم. أتعتقد أنني لم أعلم بذهابك إلى البلدة؟ بعدما أحسست بكل نفس من أنفاسك وهو يدفع بك إلى هناك، أتظنُّ أنَّني لم أبصر قدميك اللتين اهتزَّت الكنبة من اندفاعتهما؟ أنا أبصرت عناق الواصلين، وسمعت زغردات الصَّبايا.
أمَّا اليهود، فأراهم يفرُّون مثل الكلاب. عويلهم يصل إلى مسمعي الآن، بل أشاهدهم منبطحين يربضون أمام بوابة فاطمة والبوابات الأخرى مثل كلاب الحراسة المطرودة التي أضحت تستعطي عطف اليهودي الذي استعان بها على الأهل الطيبين. وفي مثل هؤلاء الضالين ضُرِب المثل:
“كلُّ الكلاب أحسن من قطّوش”. وقطَّوش هذا كلبٌ تآمر مع الذئب لسرقة الدجاج. ولمَّا افتُضِحَ أمرُهُ نال نصيبه العادل، أسرع صاحبُ البيتِ وقطش أذنيه.
الآن أرجو الله أن يسعدني برؤية آذانهم مقطوشة ومعاملتهم بمثل ما تعاملوا به مع أبنائنا وأخواتنا؛ فهؤلاء لا يستحقون الشفقة ولا الرحمة يا حبيبي. قالت ذلك وطلبت إلى ماجد أن يساعدها على الوقوف وسط دهشته الكبيرة وسعادته الغامرة.