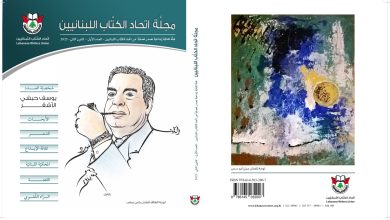الله، والحبّ، والحرب: علاقات قلقة في “ثلاثيّة يوسف حبشي الأشقر” الروائيّة – د. سُميّة عزّام
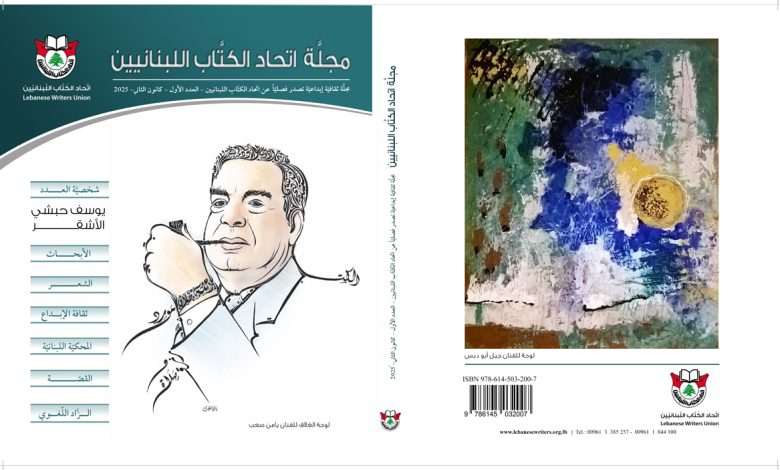
الله، والحبّ، والحرب:
علاقات قلقة في “ثلاثيّة يوسف حبشي الأشقر” الروائيّة
د. سُميّة عزّام
قد تظلُم بعض الأعمال الأدبيّة -في سطوعها- عناوينَ أخرى من إبداع الكاتب نفسه، فتحجُبها، كما هي الحال مع ثلاثيّة يوسف حبشي الأشقر(1929-1992) الروائيّة؛ إذ نكاد لا نذكر اسمه إلا مقترنًا بثلاثيّته، متجاهلين مجموعاتِه القصصيّة، على غرار “الأرض القديمة” (1962) و”المظلّة والملك وهاجس الموت” (1980) و”آخر القدماء” وغيرها.
وحين نقرأ الثلاثية، بدءًا بروايته “أربعة أفراس حُمر”(1)، نستأنس بما يذهب إليه المفكّر اللبناني كمال الحاج بأنّ “الروح الفلسفيّة تبني حكاية النفس من جديد، من دون أن تشكو مَللاً. والأدب الخالد هو أدب المُعضِل. والأديب الخالد هو الذي تحرقه الـ”لماذا” النقّاقة”(2). والمُعضِل هنا يتمظهر في مأزومية العلاقات التي تخفي صراعًا عَقَديًّا داخليًّا بين ثابت ومتحوّل، مقدّس ودنيوي، غَيبي وواقعي عَينيّ.
فقد تناول الأشقر مبكّراً قضية من أعقد القضايا في المستويين النفس-وجودي والاجتماعي، وذات حساسيّة في العالم العربي. هي قضيّة متشعّبة ومتعدّدة الوجوه للحبّ والعلاقات العاطفيّة والأُسريّة. ففي الجزء الأول “أربعة أفراس حمر”، يضعنا أمام مأزوميّة أبطاله باتّخاذها وجوهًا ثلاثة: في الحبّ الغَيريّ، والمساكنة (خارج مؤسسة الزواج الكَنَسي)، وفي المثليّة الجنسيّة، وفي ازدواجية الانجذاب الجنسي. ليستمرّ بالتطرّق إلى التوجّه الرابع -وفق تصنيف الميول العاطفيّة والجنسيّة- في الجزء الثاني “لا تنبت جذور في السماء”(3)، ألا وهو الحبّ المجرّد اللاجسدي، أو الأدقّ أن نقول إنّه الامتناع القصدي عن ممارسة النشاط الجنسيّ في الحبّ نشدانًا للمطلق. وأبرز المنظور الروائي أيضًا في هذا الجزء الشخصية الدونجوانية بصيغتيها الذكريّة والأنثويّة. ويتابع في الجزء الثالث “الظل والصدى”(4) مع علاقة المساكنة من جديد، ومن ثَمّ التشيّؤ(5) والتهرّؤ في العلاقات الأسريّة، بالتوازي مع صعود خطاب العنف وظهور النموذج الأوديبي (نسبة إلى عقدة أوديب) في العلاقة.
في الإشكاليّة والمنحى المنهجي المتّبع
تنطلق هذه الورقة البحثيّة، من باب العلاقات الخاصّة بين الشخصيّات؛ وهي شخصيّات إشكاليّة بمعظمها. وإذا كانت الانطلاقة على هذا النحو، فلأنها باب ينفتح على الكَون الروائيّ بتنوّع خطاباته المنجدلة مع خطاب الحبّ، وبخاصة خطابا الإيمان والحرب. هذا الاختيار أوحت به النماذج المختلفة للعلاقات الحميمة، حتى يكاد الروائي لا يغفل أيّ نموذج منها. فتتحرّى اغتراب(6) الشخصيّات، وتتقصّى مآزقها في موضع بَينيّ قلِق، في محاولة لفهم أسباب قلقها وتعليل نتائجه؛ ذلك من طريق تأويله(7). وبحكم أنّ الرواية شكل تعبيري عن اغتراب شخصيّاتها الإشكاليّة، وانقسامها بين عالمي الداخل والخارج، فهي تبحث في مآزق الإنسان الوجوديّة، وفي بحثه عن حقيقة غائبة. والوضع البَينيّ، أو “المابين” هو مقام التوسّط للذات المتسائلة عن كينونتها؛ فينكشف في الرواية وصفًا لحالة الشخصيّة المتأرجحة في تضاعيف توتّراتها(8).
الصراعات إذًا، صراعات داخليّة أوّلاً، ليتراجع الصراع مع الآخر إلى المنزلة الثانية، (يبرز الصراع مع الآخر بوضوح في الجزء الأخير). وقد لاحظ الفيلسوف الفرنسي ميرلوبونتي Merleau-Ponty(1908-1961) أن الأدب في القرن العشرين غدا فلسفيًّا أكثر ممّا كانه في أيّ فترة سابقة. وإن كانت أفكار الفرنسيَّين الوجودي جان بول سارتر J. Sarte (1980-1905)، والعبثي وألبير كامو A. Camus (1913-1960)، متمثّلة بوضوح في الثلاثية، لجهة التساؤل عن معاني الحياة، وحرية الاختيار، والالتزام، والمسؤولية، والموت، ومفاهيم القلق والحبّ والفقد؛ فمفاهيم أخرى من القاموس الديني المسيحي مكرّسة أيضًا، من قبيل: الخطيئة والكفارة والاعتراف والقربانة وغيرِها. هذه الإشارات تنحو بالثلاثيّة الروائيّة لكي تكون وجوديّة(9) بامتياز، وتعيدنا من جديد إلى قول كمال الحاج في أنّ “أدب لا يتفلسف، وفلسفة لا تتأدّب يبقيان بدون بقاء، لأنّ كلًّا منهما واجب الوجود للآخر”(10).
من جيل الستينات إلى جيل الحرب
إذ نتابع حكايات أجيال ثلاثة تتعاقب، نرصد بدقة أكبر وتأكيد أعلى من سواه، تحوّلات جيل واحد ومآزق شخصيّات تنتمي إليه، فيستمرّ بعضها بالحضور من جزء إلى ما يليه، ويتوارى بعضها الآخر؛ وعلى الأغلب الأعمّ يواريه الموت أو أنّه يخفت حضوره مع الهجرة. ومن خلال نموذج الثلاثية نسجّل أنّ الموت والهجرة في الرواية اللبنانيّة -بعامّة- ثيمتان تعلّلهما الحروب والفقر والمجاعة بالدرجة الأولى، وتنتجان الشعور بالفقد والخسران.
سنُجمل في عجالة مسار الشخصيّات وعلاقاتها في الثلاثيّة. تتناول “أربعة أفراس حمر” جيل ما بعد الحرب العالميّة الثانية وأحداث 1958، يمثّله يوسف الخرّوبي القلِق والباحث عن الغفران والرافض له في آن، وهو المأزوم في علاقته بأمّه، وبالله، وبالكنيسة، وبالحبيبة. إلى جانب يوسف تظهر شخصيّة صديقه اسكندر الحمّاني الطامح إلى البرجَزة (الاصطلاح مشتق من البرجوازيّة)، فيحصل على مطامحه الماديّة في الجزء الثاني “لا تنبت جذور في السماء”، وتستمر هذه الشخصية في الحضور لتغدو الشخصية المحوريّة في “الظل والصدى”.
ومن الشخصيّات الأنثويّة تظهر مها، حبيبة يوسف وعشيرة جانين، في علاقة مِثليّة تجمعها بها، ولتصبح (مها) في الجزء الثاني حبيبة اسكندر بُعيد موت يوسف. كما تبرز شخصية ميرا البرجوازية المتحرّرة ودونجوانية النزوع في علاقاتها المتعدّدة. من جيل الآباء يتمحور الحكي في “أربعة أفراس حمر” على ميليا، والدة يوسف، التي تساكن الخواجة سمير. ومع الجزء الثاني تسطع شخصية أنسي الهزّال الباحث عن المعنى في المطلق: تارة في الله والإيمان، وتارة أخرى في العقيدة الشيوعيّة، ومن ثَمّ في الحبّ؛ إلا أنّه لم يعثر على المطلق في مساعيه جميعها.
ذلك إلى جانب الحضور الأنثويّ لكل من مونا حبيبة أنسي، وميرا عاشقة الرجل أيًّا كان، وبالأخص أنسي الذي يعصى عليها، فضلًا عن الفرنسية مارت التي رافقت اسكندر إلى لبنان لتعيش معه في علاقة مساكنة، ويستمرّ حضورها إلى جانبه في الجزء الثالث. وكما كان يوسفُ الخرّوبي الشخصيّة المحوريّة في الجزء الأوّل، فإنّ يوسف ابن خليل الذي وُلد يوم موت الأوّل، وسُمّي باسمه تيمّنًا، كان شخصيّة بارزة في الجزء الأخير، ممثلًا جيل الحرب.
جيل الستينات، أهو جيل اللامبالاة أم جيل الرفض لأبطال بغير بطولة؟
تكبر بعضُ الشخصيات يوسفَ ومها بعقدٍ من الزمن، في علاقة تتعدّى كونها علاقة تجاوُر إلى صداقة. وتُجادل في شأن الجيل، مستفهمة عمّا إذا كان هذا الجيل (جيل يوسف ومها) جيل الرفض أم جيل القبول، وبأقلّ بكثير ممّا كانت تقبل به هي نفسها: “هؤلاء يقبلون ما رفضناه نحن ويرفضون ما كنّا نفتّش عنه.. طريقة التعبير انتقلت عندهم من التفكير إلى التجسيد.. يقال إنهم وجوديّون، يؤمنون بالإقبال على الحياة” (أربعة أفراس حمر، ص 76).
ركائز ثلاث تشكّل مثلث الرفض لدى شخصيات هذا الجيل، بتطلّعها ربما إلى السيطرة على “زمن سائل” (والتعبير لعالم الاجتماع زيغمونت باومن (1925-2017) Zygmunt Bauman)(11) وإدارة مخاوفها. وهي تعرّف الزمن بأنّ حدوده الموت. وفي أعماق كلّ منها محاولة لتجميد الزمن إن بالحبّ، أو بالمال، أو بالعبادة، وبالكتابة أحيانًا. تطالعنا إذًا ثلاث شخصيّات إشكاليّة متقاربة: يوسف الخروبي وأنسي الهزّال واسكندر الحمّاني؛ فأزماتها الوجوديّة متماثلة، نخصّص لها حيّزًا في محاولة فهمها؛ حيث تضعنا وجهًا لوجه أمام السؤال الفلسفي القديم:
هل القدر يحدّد شخصيّة الإنسان، أم أنّ شخصيته هي من يصوغ قدره؟(12)
يوسف وأنسي واسكندر: ثلاث شخصيّات مغتربة
في الواقع، فإنّ يوسف يشعر بالتخلّي، وبأنه الخيار الثاني وليس الأول بالنسبة إلى أمّه وإلى مها على حدّ سواء. وليس بإمكانه أن يفصل علاقته بمها عن أزمته مع أمه. وذلك حين يفصح الراوي عن دخيلة يوسف في أنّ حياته هذا النسيج من “اللّو” المتكرّرة. ومن يوسف بشخصيّته القلِقة اللامساوِمة، وموقفه “المتعنّت” إزاء الحب، ومأزقيته في عدم قدرته على المغفرة والصلاة، إلى أنسي واسكندر في مفهومهما للحبّ وللعالم المعيش، إذ يبدوان قطبين متضادّين. الأول -أنسي- متطرّف في بحثه عن المطلق المجرّد، ولم يعثر عليه في أيّ من المُثل الثلاثة: الله والحبّ والعقيدة السياسيّة. والثاني -اسكندر- شكّاك لا يؤمن بأيّ ارتباط وبأيّ التزام، وبأي شيء يشبه التفتيش عن نسيان الذات بالكلمة أو بالإيمان أو بالمطلق. مقدّمات تفضي إلى نهايات تؤشّر بالخسران لإمكانية الاندماج مع الواقع فتنقلب هذه الشخصيات على أيّ مطلق، لا سيما الله.
أنسي الكئيب، يعيش في حالة تذبذُب في بحثه عمّا شاءه أو تصوّره خلاصًا في أمور ثلاثة: النضال، والربّ، والحبّ؛ “إلى الثلاثة كان يعود ومنهم يهرب، ثم يعود ويهرب” (الظل والصدى، ص 51). لم يتصوّر أنسي أن تكون مونا إنسانًا من لحم ودمّ، فرفض علاقة جسديّة معها تُنزل مثاله هذا -أي الحبّ المجرّد- إلى درجة الحسّية؛ فيقول: “أريدها أن تقول نعم وتفعل لا، وأحوم حولها كالفراشة، وأتلهّى وآخذ من رفضها سببًا لوجودي… كنت أريدها كالكنيسة.” (لا تنبت جذور في السماء، ص ص 298 و301). تحوّل أنسي، بمثاليّته، فكرة. فيعبّر اسكندر عن إعجابه به بالقول: إنّ “في كلّ واحد فينا أنسي عميق، محبَّب إلينا”(لا تنبت جذور في السماء، 414)؛ ذلك في البحث عن المطلق المجرّد -المثال- وما يشرح وجوده.
أما اسكندر فمعركته الدائمة والأبديّة قائمة مع الخوف والخيبة. لا ينطق بكلمات الحبّ، ولا يجرؤ على قولها لمارت. يخشى خلاصًا متوهّمًا لا يأتي عن طريق الحب. هذا تعليله للعيش بصيغة مساكنة لصديقين يتحابّان؛ علاقة تدوم طويلا ولا تشيخ، علاقة لا تؤدي إلى القمة، ولكنها أيضًا لا ترجع إلى القعر. “منذ فقد أيام الله وعى العزلة” (الظلّ والصدى، ص 468). وهو، على العكس من أنسي، عاش مُغرِقًا في مادّيّته وحبّه للتملّك؛ فاستحال الحب لديه علاقة جنسية فحسب، إلى أن اكتشف ألمه من أن يبقى فعل الجنس وحده ما يفسّر وجوده، وعرف أنّ مقتنياته لا يمكن أن تكون جذوره ولا سماءه. فانتهى بهما كليهما -أنسي واسكندر- الأمر بالقبض على خواء المعنى.
يوسف وأنسي واسكندر، الثلاثة فكّروا في الانتحار، وحاولوا أن يلجوا هذا الباب الذي ظنّوه بابًا من أبواب الخلاص، لكنّهم عدلوا عن ذلك. يعلّل اسكندر لا جدوى القيام بفعل كهذا -وهو خير تعبير عما يعتمل في دخيلة الشخصيتين الأخريين- بالقول: “قد يكون العطل فيّ أنا، عطل التزمّت في التفتيش عن الحقيقة… الانتحار ليس حلّي، لأنّه لن يكون مجّانيًّا” (الظل والصدى، ص ص 37 و39). ويعترف أنّ وجوده عارٍ، فيعيش في حالة المراوحة والتنازع بين البقاء ووضع حدّ لهذا الوجود: “لن أنتحر لا ثورةً، ولا سأمًا، ولا انتقامًا، بل لمعادلة فكريّة تقول: لا ضرورة للوجود العاري، وأنا وجودي عارِ” (ص 44)(13). لكنه سرعان ما فكّر بوالديه، وباللوعة التي سيتركها لهما انتحاره متسائلًا عن حجم ما سيقدّمه لهما.
هي شخصيّات “بين بين” محيّرة في إمكان وضعها في مقام يناسبها من التصنيف لفهمها: أهي شخصيات وجوديةّ تبحث عن المعنى والقيمة في عالم دائم التشكّل يعتوره العطب؟ أم أنّها شخصيات عبثيّة؛ بوصف العبثيّة(14) مثال التصادم بين الإنسان العقلاني والكون المضطرب، وباتّصاف الوجود بالأمر السخيف، في موقف وجودي أكثر تشاؤمًا يعبّر عنه بالقول إنّ كل صدام مع الدنيا اغتراب(15). سؤال يعيدنا إلى السؤال الذي طُرح في البداية عن العلاقة الجدليّة بين الشخصيّة والقدر في تحديد الخيارات، لنسقطه عليها مجتمعة. فهل الشخصيّة أم الظروف مجتمعة أبقتها في طريق بَينيّ قَلِق مشكّلة هويّتها الفريدة؟ قد لا يكون مسار الأشياء منطقيًّا، أو ربما للأحداث منطقها الخاص. وللموت ميعاد غير مفهوم. هل يأتي الموت حين نشتهيه؟ هكذا جاء حين طلبه يوسف، وهكذا ذهب إليه اسكندر ليلقاه حين حاصره. إنما يذهب تأويل الموت -وإن لم يكن انتحارًا أو اختيارًا- باتجاه الدلالة على عجز الشخصيّة أمام أزمتها.
نهاية جيل يوسف الخروبي واسكندر وأنسي وخليل نهاية العادلين، شحّادي الأمل، فاقدي التوازن، الباحثين عن حقيقة ضاعت(16)، كما يعبّر اسكندر: فـ”الويل لمن سيبقى منّا ممّن هم مثلنا” (الظل والصدى، ص 430). نهاية تُرهص(17) بمجيء جيل يوسف ابن خليل ورفاقه ميشال وشربل ومصطفى، أي جيل ينتمي إلى عالم محجوب المعنى، مشوّش، جيل من شارك في التحرّكات الطلابيّة الواعية وفي صناعة الحرب على حدّ سواء.
يسبغ القول الروائي على هذا الجيل -الثالث- صفات الفوضويّة والارتهان والعنف المجّاني في سبيل بحثه عن معاني الوجود والوطن والهويّة وفي زمنٍ، دمُ الغير فيه حلال؛ زمن “الإنسان الجديد” الذي يصفه جرجي والد اسكندر بأنه لا حرارة فيه ولا حياة، “الإنسان الجديد لن يحيا، سيعيش فقط ولا يعرف أنّه يعيش، وبالخطيئة يعيش، خطيئة الانغراز بالدنيا والحرمان من الحياة” (الظل والصدى، ص72). لكنّه -في الواقع- جيل نجده غيرَ منفصل عن جيل الآباء، إنما يتبدّى امتدادًا لما بدأه بعضهم وأنبأ به، أمثال أسمر وأسد، أو أنّه جاء نتيجة رفض لقيم الجيل السابق الذي امتاز بقلق وجودي بَيِّن.
المرأة، والخروج من الظّل
بالحديث عن نماذج العلاقات الحميمة وموقع المرأة منها في الثلاثيّة؛ فلم يُبرِز الخطاب الروائيّ المرأة موضوعَ رغبة فحسب، أو ضحيّة كما هو السائد في النماذج الروائيّة العربيّة، بل أظهرها ذاتًا فاعلة، راغبة، مبادرة، مقتدرة، مؤثّرة كما هي متأثّرة بالزمن والأمكنة، تختار مصيرها(18). كما يبتغي القول الروائي في النماذج المختارة من العلاقة المِثليّة بين مها وجانين، والتعدّدية لدى ميرا الدنجوانيّة، والحب الأوديبي بين مارت ويوسف، أن يظهّرَ المكبوت والمسكوت عنه، ويجعل الهامش يتمدّد ليحتلّ المتن.
مها وجانين:
تنازع الشخصيّات بين خطابَي الإيمان الديني من ناحية، والنوازع الفطريّة والضرورة من ناحية أخرى، يتظهّر في نماذج حدَثيّة (موتيفات) ثلاثة لكلّ من يوسف ومها وجانين أمام الصليب؛ إمّا في غرفة خاصّة في مناجاة الإله، وإما في كنيسة على كرسي الاعتراف. تحدّد مها علاقتها بيوسف على أنّها علاقة حبّ باختيار، وبجانين على أنّها علاقة مسؤولية وضرورة؛ تبدو مأزومة بين القلب والواجب. هي الجريئة في مُبادَءتها الحب مع يوسف، وهو الذي يحبّ منطقيًّا، ولا يعرف إن كان يحبّها حقّاً؛ ليفصح: “قد أكون لا أحبّ سوى ذاتي”(أربعة أفراس حمر، ص 88 ). وربما لم يحبّ فيها نفسه وحسب، بل الإنسان الذي يحبّه ويحتاجه. لكلٍّ منهما إذًا، مفهومه واشتراطاته للحبّ. أحبّها يوسف بلا خيال إنسان في ضميرها، قبل أن يعلم بسرّها؛ فلا يستطيع تاليًا أن يغفر لها. أما هي، فتجد أنّ الحبّ عنده حاجة عقليّة تحيط بها التعليلات، ويريدها تمثالاً يتحرّك وفق رغباته.
كيف بدأت العلاقة بين مها وجانين؟
باختصار، فقد جمعهما الخوف من الرجل إلى حدّ الكراهية. والحاجة إلى الأمان والنسيان في مدرسة الدَّير. جانين المدرّسة مثال الصلابة والقدرة على التحدّي والمواجهة بالنسبة إلى مها اليافعة. وهذه الأخيرة بعد اشتداد عودها، أخرجت جانين من عزلتها ورغبتها في الانتحار. يُسبغ الراوي صفات القسوة والتزمّت والعدل على جانين، وأنّها قدوة لبنات المدرسة بثوبها المكوي والنظيف، وتديّنها بغير التظاهر بالتقوى والتديّن. “ينبعث من مجمل شخصها سحر غريب” (ص 116)؛ وبالرغم من صرامتها فهي محبوبة. لكن، لجانين سرّها، لها ما تُظهر وما تُبطن؛ فتكتشفه مها. أمام عينيها يتكشّف مشهد “العواء الصامت” المتكرّر كلّ ليلة في حديقة الدّير. تسير على غير هدى بين الأشجار ليلاً، تدور حول نفسها، وهاربة منها في الوقت نفسه. لتعود نهارًا، تلك المرأة المقفَلة، المغلقة، الهادئة. هذه الصلة الخفيّة، صلة التفاهم والعزلة وارتداء الأقنعة، هي تمامًا ما انعقد بين الاثنتين؛ ذلك قبل أيّ حوار أو تقارب جسدي بينهما.
هكذا، بقيت مها في علاقة بَينيّة مرفوضة اجتماعيًا، ومحرّمة دينيًا (في مجتمع الرواية)؛ ولا يقبلها -بطبيعة الحال- مُحِبّ يستنكر علاقة مثلّثة الأطراف، ويطالب بالوضوح. والحال إنّ مها خطّطت لقتل جانين، وعجزت عنه. لم يحسم هذه البينيّة سوى موت يوسف. وإن دلّ هذا الخيار الرّوائي على شيء، فهو يدلّ على عجز الشخصيّة أمام أزمتها لتخطّي ما يعيق تقدّمَها. مهما يكن من شأن النهايات، فإنّ رؤية الروائي التي تتبّعت الشخصيات، وجعلتها تتحدث عن نفسها، لا تدين ولا تتعاطف.
ميرا الشخصيّة الدونجوانيّة
في كتابه “في الحب والحبّ العذري”، ينقل صادق جلال العظم عن الجاحظ، في “رسالة القيان”، وصفه للمرأة الدونجوانية (والصفة الكنائيّة للمسرحي الفرنسي موليير Molière)، بأنّها لا تخالص في عشقها، ولا تناصح في ودّها، لأنّها مجبولة على نصب الحِبالة والشَّرَك للمتربّطين ليقعوا في أنشوطتها. فإذا أحسّت أنّ سحرها قد تقلّب فيه، تزيّدت(19). إذًا، كلّما ارتفع عدد فرائسها، ابتهجت. هكذا نتصوّر حال ميرا؛ لكن خلف هذه البهجة معاناة وجوديّة. فعلاقتها فاترة بالله، وهي المطلّقة، لا تريد حبًّا يجرف ثم يعفّن ويموت. فانتقلت من جرح إلى جرح، وفي كلّ رجل تحاول أن تجد شيئًا من حبّها الأوّل. لم تستطع أن تنال اسكندر الذي تراه “أمنيتها السرّية المفقودة” (لا تنبت جذور في السماء، ص 170)، فتحوّلت إلى أنسي، معلّلة ذلك بأنّه قد يكون الأقرب والأسهل، وبقي هذا الأخير بعيد المنال أيضًا. وما يجمعها مع الصديقين، كما تفصح، هو حالة التفسّخ وعدم التصالح مع الذات، والتفتيش عنها خارجًا.
كيف نظرت ميرا إلى معنى وجودها؟ ومتى اكتشفت خواء المعنى في طريق اختارته؟
تعترف ميرا أنّ ما تعيشه وظنّت أنّه حريّة لم يكن سوى عبوديّةٍ للضجر؛ فوجدت في الرجل تعزية، وفي اللذة شرحًا لوجودها: “هناك أمر واحد يلهيني عن نفسي، وينسيني أنّ الوجود بحدّ ذاته عطل … هذا الأمر هو الرجل، حب الرجل، خصوصًا جسد الرجل” (لا تنبت جذور في السماء، ص 280). وتصف وضعها المتراوح بين أن تكون مرّة ذاتًا والرجل موضوع رغبتها، ومرّة أخرى تقبل بأن تكون موضعَ رغبة الرجل، بوصفه مسافرًا يرتاح عندها ثم يغادر، في قولها: “أنا هكذا، هنا يرتاح المسافرون… وعندما يرتاحون يذهبون.. وأكون أنا قد أخذت منهم التعب والعرق”(ص 176).
والحال، فإنّ الفقد في الحب أفضى بها إلى البحث عن البدائل بوصفها “تغطيات من كل جهة لحقيقة هي حيث لا ننظر” (لا تنبت جذور في السماء، ص 98). تعبّر عن مأساتها بالقول الآتي: “كل من أحبّوني أحبّوني ليهربوا من نفوسهم أو يشفقوا عليّ، أو لأنهم لم يجدوا غيري… عندما وجدوا غيري تجاهلوني” (ص 214). لذا كانت تجد لذّة بأن تكذب عليهم وتخونهم الواحد مع الآخر، وتحتقر ما تأخذ منهم. فلعلّها أرادت بذلك أن تعكس الوضع فيكون الرجل سلواها وتعزيتها، بمعنى آخر أن يكون هو موضوع رغبتها لا هي؛ ذلك تفتيشًا عن معناها، عن لذّتها: “لذّة التعرّي أمام الرجل، هكذا، مجّانًا، لذّة أخذ الرجل.. كاللذة في الشراب والأكل” (ص 174). كأنّنا بها تتأمل عالم الخراب، في جبل النهايات.
والإجابة التي تتبدّى لنا عن السؤال الملحّ نفسه عن اغتراب ميرا، وعن جدل علاقة قدرها بشخصيّتها، مماثلة حيال الشخصيّات الأخرى، في أنّ عالمها المعيش ما هو إلا انجدال لما فُطرت عليه من حبّ الإغواء، ومن ظروف أفضت إلى مصير، بل اختيار كهذا، بحثًا عن معنى وجودها، وفق ما تفصح.
مارت: المرأة المرآة، والنموذج الأوديبي في الحبّ
يطالعنا السؤال عن توقيت اختيار النموذج الأوديبي(20) في العلاقة في الجزء الأخير؛ وقد نشأ بين مارت ويوسف الذي لم يتجاوز العشرين من عمره في أقصى حدّ، وسرعان ما تتكشّف الإجابة. تعليلات هذه العلاقة متعدّدة؛ فقد تكون من جهة مارت الأربعينيّة مرورَها بأزمة منتصف العمر، ومحاولتَها تكوينَ شخصيّتها من جديد، وإعادة النظر في تقييم علاقتها باسكندر وقد أصابها الجمود لطول الانتظار. حاجتها إلى يوسف حاجة للرفقة، ولكسر الرتابة والعزلة، إلى أن شعرت بالحب تُجاهَه عارمًا؛ فعرفت أنّ ما تشعر به هو الحبّ. اختلطت لديها عاطفة الأم المحرومة من الأمومة بشعور الأنثى تُجاه الشاب. وبتقييم علاقة مارت باسكندر فقد أحبّته حبًا مجّانيًا مؤمنةً بأنّ الحبّ يطهّر كلَّ شيء ويغفر كلّ شيء. والواقع، أنّ لله حضورًا دائمًا في قلبها على عكس اسكندر. وعندما لم يعد يمثّل اسكندر لها الحماية التي تحتاجها، شعرت بحالة خجل من الخيانة فيما لو بقيت معه. وبتفسير آخر، مارت -بوصفها نهرًا يجري- قد تكون لم تلحق إلا بالمغامرة مع الرّجلَين.
من جهته، يرى يوسف في مارت عالماً مدهشاً يتخلّق، كان كافيًا لإبعاد أيّ حاجة أخرى به. وتمنى لو قيّض له الاختيار لاختار مارت أمًّا له بديلاً عن أمّه سامية. مارت كانت أمًّا بدون ولد، كان هو ابنها. هكذا كانت البداية للعلاقة المشوّشة، علاقة حاجة ونقص ينشُد الامتلاء. ما لبثت أن تحوّلت إلى اشتهاء رزقٍ سمّاه سائبًا وكان يظنّه مملوكًا، حالما اكتشف صيغة المساكنة بين مارت واسكندر. هذا الطفل الذي كانه، والباحث عن حضن أمّ، كبُر فجأة، كبّرته الحرب، ظهرت في ملامحه خشونة، وقساوة طفل من دون براءته. تعضد هذا النزوعَ جملةُ أسباب، أبرزُها: حائط الفقر الذي نشأ بينه وبين أبيه، وحائط الجهل بينه وبين أمه، وحائط البغض والحسد بينه وبين اسكندر. أراد أن يقاتل من أجل الحصول على امرأة. لكنّه مع انغراسه أكثر فأكثر في ما سمّاه حربًا، تفرّغ من الداخل، وبدأ يسرق ليشعر بقوّة التملّك، وباتت “مارت سلعة، ومتعة عند الاقتضاء”، أي أنه تشيّأ وجعل حبيبته كما الشيء (الظل والصدى، ص 509).
ليس من العبث أن يُرمز إلى المرأة بالمرآة كما هي حال مارت، لِما للمرآة من دلالة روحيّة في قدرتها على أن تعكس صورة الداخل(21). فحبّ الآخر هو حبّ الذات من خلاله وليس حبًّا لأجل الآخر، كما يفسّر الكاهن حالة مارت العاطفية؛ أي أنّه انعكاس لحاجة وتجسيد لها في الحب. ويتابع بأن علاقتها باسكندر أطالت علاقتها بالله، حيث كانت ترى الله من خلاله. وإذ يراها اسكندر مرآته، فلأنها بعضٌ منه، لأنها أملُه. ولا بد للمرآة أن تتهشّم يومًا: مرآة اسكندر مع فقدان الإمكانية الوحيدة لتوازنه، وعجزه عن أن يكون بمستوى الصورة التي رسمها عن نفسه، ومرآة يوسف بعد أن كان يرى وجودًا حارًا وبعضًا من الأمان في ذلك الانعكاس. لكنّ وجه يوسف كان يعكس حقيقته(22)، فرأت مارت إمكانية الهدم المخيفة التي حلّت فيه، رأت أنّه لم يحبّها، بل كان يريد أن يسرق اسكندر فحسب. فهل صدق حدس اسكندر في وصف معاناة الحبّ في أنّ “مأساة كلّ حب لا يقبض فيها الإنسان إلا على الظلّ” (الظل والصدى، ص 425)؟
لعلّ هذا التبادل للمواقع بين المتن والهامش، لا يحقّق المصالحة المنشودة للذات الأنثويّة مع عالمها، بل يجعلها في موقع بَينيّ مأزوم، تمامًا كما هي الحال مع الشخصيّات الذكوريّة، وبإمكاننا إسقاط السؤال نفسه عن جدل العلاقة بين الشخصية والقدر ، والاضطرار والاختيار في تحديد المصير.
جيل الحرب: علاقات حبّ سائلة(23)
وجهات النظر الغالبة للجيل الثالث، جيل الحرب، إزاء الحبّ تذهب في مغالاتها باعتبار أنّ النساء يحببن الثوب المرقّط والسلاح والشِّعر والبطولة. وترى أنّ السلاح مجد واكتمال كأنه حاجة غريزية من أجل الذات أولًا، ثم من أجل الوطن، الطائفة، المرأة. وترى أنّ المشاركة في الحرب تشبه الحبّ، كأنها شرح لكل شيء. ولم تظهر نماذج التفكّك، إن على مستوى العلاقة الزوجيّة، كما هي علاقة خليل وسامية، وإن على مستوى المساكنة كعلاقة اسكندر بمارت، بمنأى عن صعود العلاقات العابرة، أو العلاقات السائلة إذا صحّ التعبير، كعلاقة شربل بزوجة أسمر، أو يوسف بمارت، أو أسد بسامية.
قد أنبأ الخطاب الروائي في الجزء الثاني بظهور هذا النمط من العلاقات العابرة والمختلفة عمّا عهده جيل الآباء والأجداد، ومنبئًا تاليًا، بتشكّل عالم “الإنسان الجديد”. ويحدس اسكندر بتوقعاته، معربًا عن أنّ “زمن العلاقات الفرديّة ولّى… اليوم هو زمن العلاقات الجماعيّة… الجنس الفردي ولّى أيضًا. الجنس الجماعي وحده الباقي” (لا تنبت جذور في السماء، ص 413). إنما، والحقّ يقال، فإنّ -في الجزء الأول- ثمة رفضًا لمؤسسة الزواج بتسريب موقف الشخصيّات منها في وصفها الجمود الذي يصيب العلاقة: “يجد المتزوّج في الزواج صيغته النهائيّة… ويتجمّد في تلك الصيغة” (أربعة أفراس حمر، ص 41). وهذا ما حدث بالفعل في علاقة خليل بسامية التي أضحت علاقة تعامل: “يكاد الحوار يقتصر بينهما على شغل الأشياء وتناولها… حوار التعامل” (الظل والصدى، ص 318). غدت مؤسسة زواج غير مُرضية: “عاشت لأنهالم تمت… بالرغم من الحقائب والبقج الكثيرة” (ص 155).
أما القول الفصل في مسألة انجدال خطابي الحرب والإيمان، فيسرّبه المنظور الروائي في القول إنّ المؤمن لا يحارب. فمن حارب، منذ وُجد الإيمان ووجدت الحرب، لم يفعل لأنه مؤمن، بل حارب باسم الإيمان تغطية لقذارة الحرب، ولغريزة الربح.
في الخلاصة، لم يأتِ انهزام الشخصيات في المستوى العاطفي معزولًا عن انهزامها في مستوى علاقتها بالله والإيمان، ولم تتبدّل القيم بمعزلٍ عن تحوّلات الأمكنة وتلاشيها، فتشيّأ -تاليًا- إنسان المكان ليس بعيدًا عن عالم معيش يتفكّك ويعاد تشكّلُه على نحو عنيف مفرّغ من معناه. فخطاب الغفران المتقدّم في “أربعة أفراس حمر”، يترك المجال لصعود الأحلام والتفكّرات الوجوديّة وصوغ معانيها في “لا تنبت جذور في السماء”، لتترك خطاب الحرب يتقدّم بمعجميّته لجيل عشرينيّ ثالث له الكلمة الفصل في “الظلّ والصدى” بغير أن يتوارى سؤال المعنى والاختيار، لكنه بات أكثر تشاؤميّة.
ولا بدّ من قول أخير حول توالُد الأسئلة عمّا إذا كان الروائي يبتغي مساءلة الإيديولوجيات اليقينيّة، والدينيّة على وجه الخصوص، أم أنّها أزمة مجتمع وعصر؟! لكنّ الجليّ أنّ يوسف حبشي الأشقر أراد لثلاثيّته أن تكون كما الفلسفة، تطرح الأسئلة ولا تجيب عنها، متّبعًا منطقَ الاستنطاق؛ وهو استناج لا يبتعد عمّا أفصح عنه بقوله على لسان شخصية اسكندر: “أحبّ الروايات فقط لأنّها لا تحاول أن تشرح، لا تجرّب أن تقنع” (الظل والصدى، ص231). قول يلخّص رؤية الروائي؛ وعلى كلّ منّا تاليًا، أن يجيب بنفسه -مستحضرًا تاريخه وثقافته- عن سؤال الروائي وعن الأسئلة التي تولّدها تجربة القراءة؛ والمعاني -وهي تتصارع وتتفاعل وتتحايد- تمرّ ويبقى السؤال.
الهوامش
- يوسف حبشي الأشقر، أربعة أفراس حمر، بيروت، المكتبة العصرية، ط 1، 1964.
- كمال الحاج في: الموسوعة الفلسفيّة، تنسيق فيصل عباس، الجزء 10، بيروت، مركز الشرق الأوسط الثقافي، 2011، ص 60.
- يوسف حبشي الأشقر، لا تنبت جذور في السماء، بيروت، دار النهار، ط 2، 1983. (الطبعة الأولى صدرت عام 1971).
- ——-، الظلّ والصدى، بيروت، دار النهار، ط 1، 1989.
- هيرقليطس، جدل الحب والحرب، ترجمة وتقديم وتعليق مجاهد عبد المنعم مجاهد، بيروت، دار التّنوير، ط 2، 1983.
التشيّؤ Chosification: هو العلاقة الاجتماعيّة بين الناس تتّخذ شكلًا خياليًّا من العلاقة فتصبح وكأنّها علاقة بين الأشياء، ومن ثمّ يعامل الناس كالأشياء. إنّ المتشيّئ متعته مباشرة محدودة بالرّغبات الجسديّة لا الرغبات الروحيّة. النائمون بحكم انحصارهم في عالمهم الخاص، ومصالحهم الذاتيّة، ينظرون إلى البشر على أنّهم كالأشياء. وأوّل مطالب هيرقليطس هي ألّا يكون فعلنا فعلًا جزئيًّا، لأنّ هذا من شأنه أن يحوّل العلاقات الإنسانيّة بين البشر إلى علاقات بين أشياء. كأنّهم “حاضرون ولكنّهم غائبون”. إنّ النائمين المتشيّئين يسقطون تشيّؤهم على العالم، ويقيّمون العالم على أساس أنّ الجميع سلع تُباع وتُشرى. إنّ المتشيّئ متعته مباشرة محدودة بالرغبات الجسديّة لا الرغبات الروحيّة. يقول أرسطو: إن رفع الإنسان رأسه إلى السماء معناه أن تُكتب له الحريّة؛ لأنّه تحرّر من الأرض، وما هو جزئيّ ومباشر، راجع الصفحات: 41 و43 و 45 و52.
- هيرقليطس، نفسه.
يرى أنّ نسيج الإنسان في ازدواج الدلالة؛ إنه مغترب، والاغتراب نسيجه. والاغتراب هو حالة جدليّة تصاحب الإنسان بفقدان النفس والتنازل عنها. يأتي الفقدان في اتّجاهين: إمّا أن تفقد النفس ذاتها الأصيلة وتتشتّت في الموجود الجزئيّ، وتصبح كالمناضد ويطرأ عليها التشيّؤ، وإمّا أن تفقد النفس ذاتها الزائفة المتجزّئة، وتكتسب ذاتًا أصيلة متكاملة وتصبح في مصاف الآلهة؛ في الحالة الأولى يصبح الإنسان سجين عالمه الجزئيّ، يحيا وحده، ويدخل عالم النيام، وفي الحالة الثانية يعيش تجربة مشتركة مع الجميع ويدخل عالم الأيقاظ الكاملين، ص ص 35- 36.
- Paul Ricoeur Le Conflit des Interprétations. Essais d’hermeneutique. Paris,p 11et 15, seuil,p 1968.
يفترض التأويل أن “كيف نفهم؟” هو الوجود على نحو ما. والفهم هو نمط وجود للذات المتسائلة والموجودة في حالة فهم.
انظر أيضًا: سميّة عزّام، البَينيّة في التخييل السردي، القاهرة، الهيئة المصريّة العامّة للكتاب، ط 1، 2020. ص ص 7-8 و18-22.
- مارتن هيدغر، الكينونة والزمان، ترجمة وتقديم وتعليق فتحي المسكيني. بيروت، دار الكتاب الجديد. ط 2، 2013. ص ص 57 و 62.
تبنّى هيدغر مفهوم “الدازين”، حيث يقدّم في تأويله معنى للموضع البينيّ.
انظر أيضًا: محمد عناني، مصطلحات الفلسفة الوجوديّة عند مارتن هايديجر (معجم ودراسة)، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط 1، 2017.
يذكر أنّ هيدغر يفهم الوجود حالة زمنيّة، بحيث يمتزج فيه الماضي بالمستقبل عبر الحاضر، وهو ما يعني أنّنا حين نذكر اليوم شخصًا عاش في الماضي، فإنّنا نستحضره بحيث يوجد الآن معنا؛ وحين نتأمّل إمكانيّة ما في المستقبل، فإنّنا نكاد نراها مرأى العين. وبذلك، يصبح هذا وذاك حضورًا بشريًّا. هذا المعنى الأول لزمنيّة الوجود، أمّا المعنى الثاني فهو إنّ الزمن حركة مستمرّة يتجسّد فيها وجودنا المستمرّ، ص 232 .
- أندريه لالاند، موسوعة لالاند الفلسفيّة، تعريب خليل أحمد خليل، بيروت، منشورات عويدات، ط 1، 1996، المجلد 2.
L’Ontologie الأيسيّة : هي علم الكون بوصفه كونًا… هذا العلم كان موجودًا لدى المدرسيين، والاسم وحده هو الجديد؛ فكان يطلق اسم Transcendentia على تلك التعيينات المشتركة بين الكائنات كافّة… للكائنات الروحيّة والماديّة بعض الخواصّ العامّة مثل الوجود، والإمكان والديمومة. وهكذا، الأيسيّة مذهب أو نزعة فكريّة تبحث عن سمات الكائن بذاته والكائنات بذاتها. ص ص911 و913.
انظر أيضًا: خليل أحمد خليل. مفتاح العلوم الإنسانيّة. المصدر السابق، الوجود Existence: يقابل الجوهر، ويدلّ على واقعة الكون الفعلي، واقعة امتلاك وجود ملحوظ. (لا يؤدي جوهر الشيء إلى وجوده بالضرورة). يقول كانط I.Kant لا يمكن للوجود أن يكون محمولًا، لأنّ المحمول أو الصّفة هما خاصّة لجوهر مقرّر. إنّنا لا نكسب شيئًا حين نقول إنّ هذا الشيء موجود؛ وعليه فلا بدّ من الاجتهاد للتفكّر في كون الوجود؛ وهذا ما فعله هيدجر حين عارض الوجود والموجود ( Etant – Etre)، ص 450.
(الجدير ذكره أنّ الوجوديّة وصفت بأنّها فلسفة النفي والعبث إزاء فلسفة الإثبات والقيمة).
- كمال الحاج، المرجع السابق نفسه، الصفحة نفسها.
- زيجمونت باومن، الأزمنة السائلة، ترجمة حجاج أبو جبر، بيروت، الشبكة العربيّة للأبحاث والنشر، ط1،
يضع لكتابه عنوانًا فرعيًّا “العيش في زمن اللايقين”. وهو زمن تفكيك متواصل للمراكز الصّلبة. والأبنية الاجتماعيّة تتحلّل وتنصهر بسرعة تفوق الزمن اللازم لتشكّلها. (وقد أنبأ الروائي بتغيّر شكل المجتمع حين قال إنه زمن الإنسان الجديد). ص 8 و25.
- هيرقليطس، المرجع السابق نفسه، حيث يقول: إنّ الإنسان يشكّل العالم بقدر ما أنّ العالم يشكّله. ص 37.
- مارتن هيدجر، ما الفلسفة؟ ما الميتافيزيقا؟ هيلدرلن وماهية الشعر، ترجمة فؤاد كامل ومحمود رجب، مراجعة وتقديم عبد الرحمن بدوي، القاهرة، دار الثقافة، ط2، 1974.
عندما يرى الإنسان الوجود يفلت منه لا بدّ من أن يتوقّف قليلًا عن السّعي وراءه. في هذه الوقفة يكون الإنسان نهبًا لحركتين. وجود هاتين الحركتين في نفس الإنسان يؤدّي إلى انقسام نفسه. الذبذبة تخلق فراغًا وتجعله يتمثّل العدم أمامه، ص 31.
- نبيل راغب، موسوعة النظريّات الأدبيّة، بيروت، مكتبة لبنان ناشرون، ط 1، 2003.
العبثيّة Absurdité كلّ شخصيّة تعيش في شرنقة من الوهم والضياع والعبث والعزلة… فمعنى العمل الأدبي يتركّز في إبراز اللامعنى بهدف استخراج الدلالات والمعاني الحقيقيّة الكامنة في أغواره المعتمة. وأدب العبث هو مرآة فاضحة، تعكس وتكبّر ما يعانيه الإنسان المعاصر، سواء أكان يعاني التفكّك أم التفتّت أم التشتّت، او امتزاج الأفكار غير المتجانسة، أم فقدان وضوح الرؤية. لقد انقضى الوقت الذي يحمل فيه العمل الأدبي السؤال والجواب في آن واحد. الهدف الذي يسعى أدباء العبث إلى تحقيقه في وجدان المتلقّين وعقلهم، وهو أنّه من الصحّي أن يواجهوا العبث في حياتهم بكل مصداقيّة، وأن يتعرّفوا على أسبابه حتى يمكن تجنّبها أو التخلّص منها. ذلك أنّ رسالة الأدب الأصيل تكمن في مواجهة الإنسان بكل حقائق حياته، مهما كانت مرّة أو شاذّة. (وهذا ما نستنتجه في ما يذهب إليه الروائي، وسنخلص إليه). راجع الصفحات: 437 -444.
- ألبير كامو، أسطورة سيزيف، ترجمة أنيس زكي حسن، بيروت، منشورات دار مكتبة الحياة، لا ط، 1983.
الإنسان يحسّ بالغربة في كون يتجرّد فجأة من الأوهام.. فالطلاق بين الإنسان وحياته، هو بالضبط الشّعور باللاجدوى. لكن الحياة تستحق ان تعاش. لذا تتناول أسطورة سيزيف العلاقة بين التفكير الفردي والانتحار. فموضوعها يتركّز على العلاقة بين الانتحار واللاجدوى. ومن ضمن الأسئلة المطروحة: هل ان لا جدوى الوجود تتطلّب من المرء أن يفرّ منه عبر الأمل أو الانتحار؟ (نجد تأثّرًا جليًّا للكاتب بمقولات العبثيّة، لا سيّما ما ورد في هذا الكتاب من تصوّرات وجوديّة). انظر الصفحات: 11 -17.
- ميشال فوكو، “تاريخ الأفكار والعقل المنعكس“، ترجمة وتحقيق محمد شوقي الزّين، بَلوَر سبينوزا Spinoza نظريّته حول وحدة الوجود العقليّة بناءً على رمزيّة المرآة. ويختصر فوكو ذلك بالقول: إنّ الحقيقة ليست خارج الإنسان، وهذا الأخير ليس خارج الحقيقة. كل واحد منهما ينطوي على الآخر.
- لطيف زيتوني، معجم مصطلحات نقد الرواية، بيروت، مكتبة لبنان،ط 1، 2002.
الإرهاص: Amorce هو إشارة لا يكتمل معناها إلا لاحقًا في النص؛ بحيث عرف الأدب الإرهاص منذ زمن طويل، واستخدمه عنصرًا من عناصر التقديم. والإرهاص بذرة لا تلفت النظر غالبًا إلا بعد أن تنمو وتنضج. وإنّ روح كل وظيفة روائيّية هي بذرتها، وهي العنصر الذي يبذره السرد لينضج فيما بعد، ص 15.
- جان بول سارتر، الكينونة والعدم، ترجمة نقولا متيني، مراجعة عبد العزيز العيادي، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ط1، 2009.
الاختيار ليس انتقاءً إنما هو عمليّة إيجاد للذات… والحريّة الإنسانيّة تأتي إلى المرء من الشعور بأنّه غريب عن العالم اللامعقول هذا. كما أنّ اكتسابه لذاته بعدًا تاريخيًّا هو تأكيد دائم لحريّته. ص 637.
- صادق جلال العظم، في الحبّ والحبّ العذري، بيروت، دار المدى، 2004. ص ص 39-40.
- جان لابلانش وجان برتراند بونتاليس، معجم مصطلحات التحليل النفسي، ترجمة مصطفى حجازي، بيروت، المنظمة العربية للترجمة، ط 1، 2011.
عقدة أوديب: Complexe d’OEdipe هي الجملة المنظّمة من رغبات الحب والعداء التي يشعر بها الطفل تجاه والديه. تظهر هذه العقدة في شكلها المسمّى إيجابيًّا كما في قصّة اوديب- الملك، أي: رغبة في موت المنافس، وهو الشخص من الجنس نفسه، ورغبة جنسية في الشخص من الجنس المقابل. أما في شكلها السلبي، فتأخذ منحى مقلوبًا، أي: حبّ للوالد من الجنس نفسه وحقد حسود على الوالد من الجنس المقابل. وفي الواقع يوجد هذان الشكلان بمقادير متفاوتة في الشكل الكامل لعقدة أوديب.. وما يتمّ استدخاله وما يكتب له البقاء في انبناء الشخصية يتكوّن من مختلف أنماط العلاقات القائمة بين مختلف أركان المثلث (الطفل والوالدين) بقدر تكوّنه من هذه أو تلك من الصور الوالديّة. ص ص 583-584 و 591.
في نموذج يوسف ابن خليل وسامية، نلحظ الجانب الإيجابي من العقدة بارزًا، في حبّه لمارت وكراهيته لاسكندر، والشكل السلبي يظهر أيضًا في استيائه من أمه (وجود حائط الجهل بينهما، ومعرفته بعلاقتها بأسد) وإشفاقه على أبيه بغير حقد عليه (نشوء حائط الفقر بينهما، لكنّه استحال مقاتلًا بوحشية وجنون في الحرب حالما قُتل والده).
- محمود رجب، فلسفة المرآة، القاهرة، دار المعارف، ط1، 1994.
تجربة المرآة حينما نفهمها بالمعنى الواسع – أو بالمعنى الماهَوي لمفهوم المرآة – هي وعي بمعنى الهوية والاختلاف معًا: إدراك الأنا أو الوعي بالذاتية من خلال إدراك الصورة باعتبارها أنا آخر، أي تعمق الوعي بالذاتية أو الهوية من خلال إدراك الاختلاف، حينما يعي الانسان صورته “الأخرى” التي “تظهر” له أو تتحقق في الخارج وتصبح مرئية.. هذا الفعل المزدوج لمفهوم الانعكاس هو أصل مفهوم “الهوية والاختلاف” في إدراك الانسان لصورته المرآوية (فهي صورة الإنسان نفسه، ولكنها في نفس والوقت ليست هو نفسه.. إنها مجرد صورة للأصل). راجع الصفحات: 119- 121 و191.
- المرجع نفسه. يذكر أنّ حاجة الإنسان إلى أن يرى ذاته أو صورته المرآوية (بالمعنى الحقيقي والمجازي للمرآة) تشتدّ في فترات التفكّك النفسي، لا في فترات الانسجام مع العالم أو التوحد به. تكنيك المرآة يصاحبه مخاطبة المرآة لوصف شخصيات تعاني من أحوال نفسية مرضيّة، مثل حال ازدواجية الباطن والظاهر، والحقيقة والمظهر. هذه مسألة عرض لها هيجل بطريقة أنطولوجية، وهي ضياع الأنا في الآخر، بمعنى أنّ الإنسان وهو يسعى إلى إيجاد ذاته عبر الآخر، يتعرّض لفقدان ذاته في ذلك الآخر. هذه الحالة دعاها هيجل “بالوعي الشقي“، أو الوعي المغترب عن ذاته، راجع الصفحات: 206- 215.
- زيجمونت باومن، الحبّ السائل، ترجمة حجاج أبو جبر، بيروت، الشبكة العربية للأبحاث والنشر. ط 1، 2016. وفي عنوان فرعي، يشير إلى تناول الكتاب هشاشة الروابط الإنسانيّة. “فالعلاقات في ظلّ الحياة الحديثة السائلة أكثر صور الاضطراب شيوعًا وأشدّها إزعاجًا.. فلا بدّ لهذه العلاقات من أن تكون فضفاضة، بحيث يمكن فكّها مرّة أخرى بسهولة من دون تردّد عندما تتغيّر الظروف”. كما أنّه يصفها بأنّها “علاقات الجيب العلوي”. ص27-28 و56.