“الخطيئة والغفران” في رواية «أربعة أفراس حمر» ليوسف حبشي الأشقر – أ.د. لطيف زيتوني
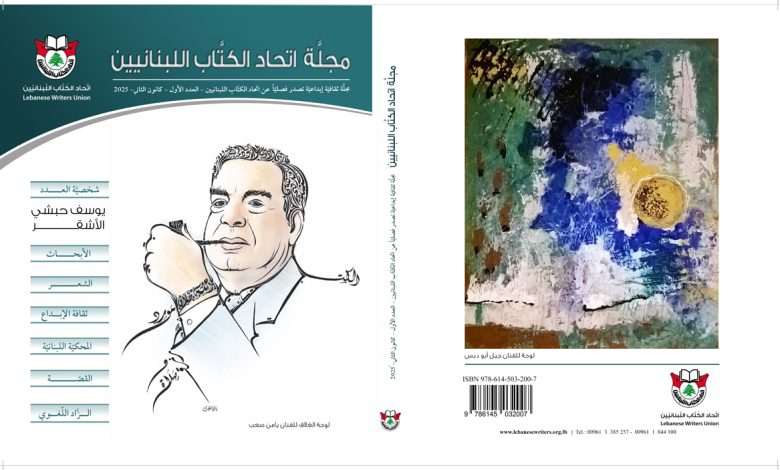
“الخطيئة والغفران”
في رواية «أربعة أفراس حمر» ليوسف حبشي الأشقر
أ.د. لطيف زيتوني
يوسف حبشي الأشقر روائي كبير، بل هو أب الرواية اللبنانية في اعتراف الروائيين اللبنانيين الكبار. وككل روائي كبير تتطّلب دراسته العودة إلى مجموع مؤلفاته، ففي كل كتاب منها شيءٌ كثير من نفسه. في الثلاثية القصصية «طعم الرماد» و«ليل الشتاء» و« شق الفجر» شخصية مركزية تبحث عن ذاتها فلا تجدها، وعن الصفاء فلا تبلغه، وعن الله فلا تجدُ في قلبها غيرَ الفراغ. وفي الثلاثية الريفية «الأرض القديمة» و«وجوه من الأرض القديمة» و«آخر القدماء» شخصية تقاوم السقوط في الفراغ، ولكنها تهوي في النهاية إلى قاعه. وفي الثلاثية الروائية «أربعة أفراس حمر» و«لا تنبت جذور في السماء» و«الظل والصدى» سيرة جيل مختَصرة في سيرة شخصية. وفي هذه الثلاثية يبلغ بناء الشخصية صورته الأكمل، ويتشكل البناء الروائي بكل أبعاده، ويتضح تصوّر الكاتب لفن الرواية. هذه الثلاثيات المثلثة تجمعها حلقة منفردة لا تنتمي إلى أي منها، حلقة عصية على التصنيف، علامة فارقة في نتاج الكاتب أسلوباً ومضموناً، هي كتاب «المظلة والملك وهاجس الموت»، وهو آخر كتبه.
روايته الأولى «أربعة أفراس حمر» صدرت في طبعة وحيدة عام 1964، وصار الوصول اليها اليوم متعذراً. وفي هذه الرواية مساحة واسعة للأفكار جعَلَت الناقدة خالدة السعيد تعتبرها مفتتح مرحلة جديدة في الرواية الفكرية[1]. وليس هذا التصنيف ببعيد عن مفهوم الأشقر لمتطلبات الخلق القصصي. فهو أجاب عن سؤال مجلة الطريق، بأنه «دون فكرةٍ فلسفية واضحة لا يمكن لإرادةٍ أن تخلق وترى، وترى وتخلق؛ والوضوحُ يستلزم المعرفة، والمعرفة تستلزم رصيدَ ثقافةٍ كلما تعمّق وهُضم جعل العمل كبيراً … عند الروائي الكبير[2]».
الفلسفة الواضحة عند الأشقر تقف في خلفية العمل لا أمامه، فهو مع تخصصه في الفلسفة والحقوق لا يُسقط الأفكار على الأحداث، ولا يميل الى ايدولوجية سياسية، ولا ينتمي الى حزب أيديولوجي. كما أن الأفكار لا تتكشّف عنده عبر تدخلات الكاتب، ولا عبر تدخلات الراوي الغائب أصلاً، بل تظهر ضمن نسيج السرد أو الحوار وعلى لسان الشخصيات لا على لسان الشخصية الرئيسية وحدها، وإن بدا لنا أن هذه الشخصية تحمل بعضا من فكر صاحبها وأحلامه، وأوهامه وخيباته، ونظرته إلى الله والوجود.
ويغلِّب الأشقر المشهدَ الحواري على الملخَّص، لأنه يتوجّه إلى عقل القارئ لا إلى ذاكرته، ولأن الحوار يجسّد في ذهن القارئ شخصية شفافة لا يُرى منها سوى أعماقِها.
أما أسلوب يوسف حبشي الأشقر السلس البسيط الذي يحاكي أحيانا الأسلوب الصحافي سواء باختيار الشائع من المفردات أو باعتماد البسيط من التراكيب، فهو مَعِين القارئ أثناء مرافقته الشخصية الروائية في رحلتها الداخلية الى أغوار النفس.
الفكرةُ الفلسفية التي يحملها الكاتب ويعبّر عنها “بطله”، منغرزة في الواقع. ولكن الأشقر لا يصف الواقع كما يصفه الواقعيون، بل يحلّل الآلية التي تسيِّر العالم كما يفعل الوجوديون. شخصياته باحثة عن الذات إلى حد القلق واليأس، متمرّدة على الله والعالم. لذلك لا تظهر في الرواية مكتملةَ الصفات ومحددة التصرفات، بل تتكوّن تدريجاً عبر الحوار. ولا شك في أن الأشقر يمتلك موهبة روائية رفيعة كي يستطيع أن يمسك بالقارئ وهو يسير به عبر “مشاهد” ذهنية ونفسية تطول عشرات الصفحات دون أن يلجأ إلى أدنى حدث درامي[3].
وما يساعد هذه الموهبة أن الكاتب حين يعرّي ما في داخل الشخصية يلجأ إلى حبكة المرايا. ففي لعبة المرايا يتكسّر وجه الشخصية الرئيسية الى وجوه حية يعكس كلٌّ منها، على طريقته وفي مكانه ومجاله، وجه الشخصية الرئيسية. هكذا هي الحال في “أربعة أفراس حمر” حيث الأم والحبيبة تعكسان معا الأغوار العاطفية لشخصية يوسف من خلال فعلتهما التي صنعت أزمته، وحيث الكاهن يعكس طريقة التفكير التي تتحكم بيوسف من خلال مواجهته برأي مناقض لرأيه في حل أزمته. وهكذا هي الحال في “الظل والصدى” حيث كان أنسي هو الوجه الآخر النقيض لإسكندر، ويوم قرّر أنسي الهجرة، قرّر إسكندر أن يسلم نفسه للقتل. ففي لعبة المرايا يؤدي سقوط وجه الى سقوط الوجه الآخر، وبالتالي الى نهاية الحبكة الروائية.
غير أن رواية «أربعة أفراس حمر» ليست حكاية شخصيات ومرايا، بل حكاية قضية هي «الخطيئة والغفران». وهي قضية عصرية بامتياز بعدما تجاوزت الدين إلى الفلسفة وعلم السياسة. وقد يكون الأشقر من المبادرين في طرح هذه المسألة في الرواية العربية. وقد يكون من المبكرين في طرحها بمفهوم جديد في الرواية العالمية. فقد ابتعد عن مفهوم العقاب الذاتي الذي تكررت صورُه في التراث العالمي بتأثير الأدب الروسي، وتجلى بأوضح صورِه في رواية دوستويفسكي “الجريمة والعقاب”. ونقل الخطيئة والغفران من المعجم الديني الى المعجم الوجودي.
تنطلق الرواية من صورة الساعة المتوقفة في برج الساحة. وسرعان ما ندرك أنّ الساعة ليست قائمة في الساحة، بل ممتدة على مساحة الجسد، ومتغلغلةٌ في صدر الشخصية وعقله. وقبل أن يكشف الراوي اسم هذه الشخصية قدّمها الينا بطلا بلا بطولة، بطل الانتظار المقيّد الى زمن لا تتحرك عقاربه.
ثم تكشّف الانتظار عن أسبابه.
بدأت أزمة يوسف الخروبي، وهذا هو اسم الشخصية الرئيسية، بعدما سافر أبوه تاركاً زوجة شابة وطفلا صغيرا، ثم انقطعت أخباره. فاشتغلت الأم خادمة عند رجل كانت تناديه بــ “الخواجه”. ثم انتقلت مع طفلها الى منزله. ثم صارت سيدة بيته وسيدة قلبه. فعاشا في مساكنة هادئة. هدوء علاقتهما قابله لاحقا اضطراب في علاقة الولد بأمه، صار شاهداً على خطيئتها، فتحوّل الى صليب لها، وتحوّلت الى صليب له. ثم تعرّف الى مها وتحابّا قبل أن يكتشف أن لها علاقة مثلية. ردّ فعل يوسف على علاقة مها بجانين كانت شبيهة بردّ فعله على علاقة أمه بـــ “الخواجه”.
«أنا أو هي»، كرّر يوسف هذه العبارة على مها. فهو لا يقبل أن يشاركه أحد في مَن يحبّ. ولكنّ مها لم تقل له إنها اختارته، بل إنها تحبّه.
- «وإن قلتُ أنتَ. أيمكن لكَ أن تنسى ما حدث؟
- نعم. وأحبك أكثر..
- كالابنة الشاطرة؟
- كالابنة التي تحبني ومن أجلي تضحي حتى بضميرها، هكذا أريد الحب».
ولكن مها لم تقل له إنها اختارته، بل إنها تحبه.
كذلك أمه؛ ففي الحوار الوحيد الذي جرى بينهما، قالت إنها تحبّه، ولكنها رفضت الجدل في صواب أفعالها، وأكدت أنها مسؤولة عن خياراتها، وأن قيمة الفعل في نظرها ليست مطلقة، بل نسبية وظرفية، فما تعيشه مرتبط بظروفها، بل ذهبت الى هذا الاستنتاج: «لذلك كان عليك أن تقتلني».
لكن يوسف لا يستطيع أن يقتل أمه، لأنه لا يستطيع أن يبغضها. لهذا لم يجد أمامه سبيلاً سوى أن ينتظرها لتترك الرجل لتتحرّر نفسه. ولكن هل يستطيع أن يغفر لها إن هي فعلت؟ هل يستطيع أن يغفر لمها خطيئتها لو تركت عشيقتها وأفرغت قلبها من كل مَن عداه؟ أمّه لم تشأ في حوارها معه أن تناقشه، بل اكتفت بالتعبير عن موقفها كشخص حرّ. بينما مها وضعت نفسها في موضع المذنبة، وقرّرت أن تترك عشيقتها وطلبت منه الغفران، فلم يَعِدْها إلا بالنسيان.
وقت الانتظار ملأه يوسف بتأدية دور الديّان، يحاكم أمه من دون استجواب، وينفذ الحكم من خلال صمته المتواصل وتجاهله المقصود. وهذا هو الحكم الذي أصدره على مها أيضاً. ولكنه حين حكم عليهما، حكم على نفسه أيضاً. قال يوسف لمها: «أنت الآن محكومة بالإعدام أتعرفين؟ حكم مع وقف التنفيذ، لا عفو ولا تنفيذ». وهذا العقاب الذي وصفه فيكتور هيغو بالعقاب الفائق[4]، حوّل يوسف إلى شخصية شبيهة بجان باتيست في رواية “السقوط” لألبير كامو حيث لا إدانة ولا غفران يُخرجان الشخصية من الدوامة القاتلة.
يوسف سجين مفهومه للحب. فالحبّ عنده يكون كاملاً أو لا يكون. «أحبكِ تعني أريد ان أتملككِ، أريد أن تكون لي وحدي، أن أسجنك في نفسي، أن أكون أنا حريتك ومشتهاك». مفهومه للحب يشبه مفهوم شخصيات دوستويفسكي التي تحبّ بجنون وتكره بجنون، وتتصادى عندها الكراهيةُ والحب فيصعب التمييز بين الصوت وصداه، ويتسربل عقلُ العاشق بالضياع ويعجز عن القرار.
قاس يوسف موقفه من الغفران على موقف الله الذي «لا يغفر الخطايا إلا إذا قصد الانسان قصداً ثابتاً ألا يعود الى ارتكابها. فهل أنا أوسع صدراً من الله؟». فلماذا إذن لم يغفر لمها حين أتته تائبة؟ الجواب: لأنها ليست سوى الوجه الآخر لأمه. ألم يقل نيتشه، قبل فرويد: «كلٌ منّا يحمل في داخله صورة للمرأة منتزعة من أمه»[5]؟
hg
لم يستطع يوسف أن يغفر لمها، رغم اقتناعه بتطرف عدالته. حكم على علاقتهما بالصمت كما حكم على علاقته بأمه: «لا محاورة بيني وبينكِ. أنا أكرهكِ ليس الا..» فهو يحبّها ولا يريد أن يحبَّها، لأنه لا يستطيع أن يغفر لها.
ذات يوم كان عائداً من حلب الى بيروت، ففاجأته في الطريق المؤدي الى طرابلس عاصفة وضعته بين أمواج البحر المتصاعدة الى الطريق والسيول المتدفقة اليها من الجبال. صلّى كي لا يموت فيَفجَعَ أمَّه. نذر أن يذهب الى الكنيسة إن وصل الى بيروت سالماً. ولكي يفي بنذره تحاور مع الكاهن في كرسي الاعتراف. أخبره عن أمه، وعن شرطه للغفران، ففاجأه الكاهن بالقول: «ما فضلك إذا غفرت بعد محو الخطيئة». وعندما أبلغ يوسف الكاهن أنه ليس نادماً على ما يفعل، قال الكاهن:
«- أواثق أنت أنك غير غافر لأمك؟
- نعم.
- إسأل نفسك.»
ثم غفر له الكاهن بعدما أوضح له أنه لا يحتاج إلى الشعور بالندم، ما دام هناك ما هو أقوى: «تمزقك يغفر لك، حاجتك الى الغفران تغفر لك».
هزّ الكاهن تفكير يوسف، هزّ المسلمات التي بنى عليها موقفه. ظهر له الفرق بين الغفران والعقاب، غير أنه بقي على موقفه. فموقفه من الأساس ليس دينياً، بل وجودي.
ما هو الشعور الذي يحسّه يوسف حقاً؟
هل هو الخيانة؟ هل هو الخجل؟ هل هو الكراهية؟ هل هو تدنيس صورة الحبيب؟ هل هو الصدمة المزدوجة؟ هل هو الضياع؟ إنه كل ذلك معا، وهو التمزّق أيضا بين صورة الأم المخلصة المتفانية وصورة الخائنة الزانية، وبين صورة الحبيبة المغرمة التي يملأ الحبيب قلبها وعقلها وصورة المثلية الخائنة.
«أمي لي، أحبها وتحبني، لا أخطئ معها ولا تخطئ معي. ولقد أخطأتْ حين ساكنت رجلا غريباً بينما زوجها، أبي، على قيد الحياة. ومها أيضاً أخطأت. فقد تعاهدنا على الحب، على أن يكون كل منا للآخر، فإذا هي متنكرة لهذا التعاهد. إنها الخيانة في الحالين. ولا يخون سوى الحبيب، سوى الزوج، سوى من يجمعك به عهد».
اعتبر يوسف نفسه عادلاً وطبق عدالته على أمه. ولكنه، حين أشرفت على الموت، ضعف وقرر أن يغفر لها، ولكنها ماتت قبل أن يمنحها غفرانه. موت أمه أشعره أنه متطرّف في عدالته. «العدالة المتطرفة ليست حباً ولا عدم اكتراث. انها بغض. العدالة من ثمار العقل، والعقل لا يحب. من يتعلق بقانون للحياة لا يمكن له ان يحب، حتى الحياة.» لذا قرّر أن يتنازل، أن يغفر لمها. ولكنه حين التقاها وجد نفسه عاجزاً عن ذلك.
ما الذي يمنع يوسف من الغفران؟ إنه مفهومه الوجودي للعدالة. فالفرد في الوجودية يحقق نفسه بالأفعال، فهو محكوم بالاختيار، ومسؤول عن خياراته. وما دام الفعل قد وقع، فالعقاب لا الغفران هو ما يستحقه.
اعتبر يوسف الصمت عقابا، ثم اكتشف أنه يمكن أن يكون حوارا أيضا كذاك الذي شهِده ذات يوم في المقهى بين حبيبين. «هي تنظر الى عينيه كأنها تسبح في حلم، وهو كأنه غائب عما حواليه، ينظر اليها، ولا يتحرّك لساناهما. قمة الحوار عندما لا يشعر الانسان أنه بحاجة الى اللفظة ليعبر.»
ولكن الحوار يحتاج الى كلام حين تتجاوز العلاقة حدود المشاعر. وهذا الكلام هو ما كان ينقص يوسف في ذاك الحلم الذي رأى فيه أمه بعد موتها. وحين حاول التحدّث اليها وجد صوته عالقاً في حلقه، وحين أعاد المحاولة، وضع يده على كتفها، فالتفتت، فإذا الوجه وجه مها. ولم يتحرّر صوته عند محاولته التحدث إلى مها مع أنه أراد أن «يفرغ لها ما تكدس في أعماقه منذ قرون».
hg
هذا التناوب بين وجه الأم ووجه مها يجعلهما وجهين لحقيقة واحدة. ورغبة يوسف في أن يفرغ ما تكدس في أعماقه منذ قرون دليل على أن الأنا، كما الآخر، ليست فردا، بل جماعة تحمل ذاكرة تاريخية. وهكذا حوّل الأشقر الأزمة من مستوى الأفراد إلى مستوى الجماعات، ونقلَ القارئ من الغفران الفردي الى الغفران السياسي.
فهل الغفران مفهوم سياسي أيضا؟
hghg
لم ينتقل مفهوم الغفران من الدين الى السياسة مباشرة، بل عبر الفلسفة السياسية ممثلة بأربعة من مشاهيرها: حنة أرندت، وفلاديمير جانكِلِفيتش، وبول ريكور، وجاك دريدا. فالغفران في نظر حنّة أرندت حاجة بشرية تقتضيها هشاشة العلاقات بين الناس المبنية على الكلام والفعل. فالكلام يتهدّدها بالشكّ، والأفعال تتهدّدها بضرورة ربط الفعل الحاضر بالفعل الماضي[6].
والواقع أن الفلسفة السياسية لم تحرّر الغفران من المصلحة، وهي تجنيب المجتمعات التطرّف والحروب، وخصوصاً الحروب الدينية، من جهة، ومن جهة ثانية، تمكين الشعوب من مراجعة تاريخها وتصحيح ذاكرتها ومواجهة خطايا الماضي والتصالح مع نفسها ومع غيرها. ولكن انتشار فكرة المصالحة ارتبطت بالندم والاعتذار؛ وانتشار العولمة محا حدود المفاهيم، وخلط معنى الغفران بالمفاهيم السياسية القريبة مثل الاعتذار، والأسف، والعفو، والتسامح، مع أن الغفران، وإن أصبح اليوم مصطلحا سياسيا فهو مختلف عن هذه المفاهيم لأنه ينتمي، في مشهديته ولغته وصورته، الى التراث الديني لا السياسي ولا الفلسفي.
سأل دريدا: هل يوجد ما لا يمكن غفرانه؟ أجابه المجتمع الدولي: نعم، هناك ما لا يغتفر، وهي الجرائم ضد الإنسانية. قال دريدا: إن كنا لا نغفر إلا ما يمكن غفرانه، فإن فكرة الغفران نفسها لا تعود لها قيمة. فإن كان من شيء ينبغي غفرانه فهو ما لا يغتفر. ثم صاغ هذا الرأي صياغة إشكالية: الغفران يغفر فقط ما لا يُغتفَر[7].
مواقف دريدا من الغفران تشبه الكثير من الطروحات التي عبّر عنها الأشقر قبله بأربع وأربعين عاما. فالأشقر ميّز بين الغفران والنسيان، أَمَا وعَدَ يوسفُ مها بأن ينسى لا أنْ يغفر. كذلك اعتبر الأشقر الغفران عطاء مجانياً. ولو عدنا إلى حوار يوسف مع الكاهن لتبين لنا معنى هذه المجانية. قال له الكاهن: «لا يحق لك أن تحاكم نفسك، فكيف تحاكم شخصاً آخر؟ لا حق لك بألّا تغفر، أغفر وقد يؤدّي غفرانك لها الى رجوعها عن خطيئتها». لذلك قال يوسف في حواره مع المسيح: «أنت تعرف أن وسائلي مثل وسائلك، أنا أكره الدماء، أكره القوة، أكره الإكراه، ولكن الفرق بيني وبينك هو أني أنتظر حيث أنا لا حيث أنت، أنتظر بحقد حلول العدالة، وانت تنتظر بمحبة زوال الخطيئة».
هكذا وضع يوسف حبشي الأشقر القارئ أمام مفهومين للعدالة، واحدة روحية تواجه سوء الفعل بالمحبة، وأخرى مادية تواجه سوء الفعل بالعقوبة أو الثأر أو الانتقام؛ الأولى يمثلها الكاهن، والثانية يمثلها يوسف. وعلى امتداد صفحات الرواية تتبّع الأشقر نتائج العدالة المادية على صاحبها وعلى الآخرين فوجدها لا تنصف الضحية ولا الجلاد، ولا تُخرج النفس المتألمة من السجن الذي تعيش فيه.
موت يوسف في خاتمة الرواية إعلان عن إخفاق عدالته المادية: قفز الى الماء لينقز رجلا من الغرق وهو يعرف انه لا يحسن السباحة. لم يكن موته تضحية، بل انتحار فرضه عجزه عن الخروج من أزمته. لقد عرف ما معنى الجرح في القلب، واختبر الألم، ومارس العقاب، فلا الجرح اندمل، ولا الألم زال، أما العقاب الطويل فكان عقابا له أيضا لأنه أمدّ في عذابه. إخفاق عدالته المادية لم يدفعه الى نقيضها، الى العدالة الروحية. فهذه تفرض تجاوز الذات صوب المطلق وصوب الآخر معاً، فهي نوع الفداء حيث لا ممكن ولا مستحيل، بل ولادة جديدة.
hg
قد يكون الغفران الحقيقي أقرب إلى المستحيل، كما رأى دريدا وقبله سبينوزا وكانط. وقد يكون صعباً لا مستحيلاً، كما قال بول ريكور وحنة أرندت. ولكنّ في النظرتين تسليما بحاجة الضحية إلى تجاوز مشاعرها وذاكرتها ولو بصعوبة بالغة.
أما الذات الجماعية فيتطلّب منها الغفران أكثر من الارتقاء صوب المستحيل. فمآسي النزاعات بين الجماعات تتجذّر في اللاوعي الجماعي، ويصبح تجاوزها مستحيلاً، ويصبح النسيان عند طرفٍ خطيئة عند الطرف المقابل، فكيف لو أنكر المخطئ حصول الخطيئة أصلا. فالإنكار الذي بنت عليه تركيا الحديثة تاريخها ليس سوى الخطيئة/الإبادة في ذاكرة الأرمن والسريان وأهل جبل لبنان. ومثلها المجازر التي ارتكبتها إسرائيل في فلسطين، والابادة التي تمارسها في غزة اليوم. أما المجازر التي ارتكبتها اليابان في الصين وكوريا في الحرب العالمية الثانية، فقد سعت اليابان في السنوات الماضية الى الاعتذار عنها وطلب الغفران من أصحابها.
الغفران الجماعي يتطلب إخراج الماضي من النسيان، والاعتراف بالخطيئة، سواءٌ أكانت خياناتٍ أو مجازر، وسواءٌ أكان تعويضها ممكناً أم مستحيلاً. وهذا الاعتراف يؤدي حتماً إلى تغيير صورة كل طرف عن نفسه، وإلى تعديل الأسس التي بنى عليها ذاكرته وتاريخه.
قالت حنة أرندت إن الأعجوبة التي تنقذ العالم باستمرار هي الولادة، فهي تبدِّل الأجيال. فمع أن كلّ جيل يحمل دَيناً لمن سبقه، إلا أنه يحمل أيضاً دَيناً للجيل اللاحق، أي للحياة.
ما الدَّين الذي حمله جيلُ أجدادنا وآبائنا للحياة، أي لنا، وماذا نحمل نحن لأبنائنا غير تكرار الحروب الأهلية والتقوقع داخل طوائفنا وتغذية الخوف من الطوائف الأخرى؟ هل نبشنا يوما ماضينا بشجاعة وموضوعية وبسطناه أمام أنفسنا وأمام كل الآخرين لنفهم جميعا – بل لنتفق جميعا على كيفية الخروج من دوامة الخوف من الآخر والشك بنواياه تجاهنا والشعور بأننا محتاجون دائما الى قوى خارجية تحمينا ولو سلبتنا كرامتنا وحريتنا؟
تبدّل الأجيال، من دون فحص ماضينا والاعتراف بخطايانا، يساعد على نسيان الماضي، ولكنه لا يمنعه من أن يعود ويحتلّ الحاضر عند كلّ خلاف. نعم، لقد كان الأشقر على حقّ حين صوّرَنا عاجزين عن الغفران، مسجونين في دوامة نستمد منها أحكامنا على غيرنا، واعتبر أن أقصى ما يمكن هو النسيان، لا بفعل الإرادة، بل بفعل مرور الزمن.
[1] خالدة السعيد: مواقف، عدد 28، ص 83 ؛ و«حركية الابداع» ص 2.4؛ وأنظر رد نبيل سليمان عليها في «مساهمة في نقد النقد الأدبي»، ص 51
[2] الطريق، مجلد 1981، عدد ¾، ص 264
[3] خالدة السعيد: المرجع نفسه، الصفحة نفسها.
[4] « Lorsque la trahison, sa complice livide,
Vient et frappe à sa porte, il fait signe d’ouvrir ;
Il est le fratricide ! il est le parricide !
Peuples, c’est pour cela qu’il ne doit pas mourir !
Gardons l’homme vivant. Oh ! châtiment superbe !
Oh ! S’il pouvait un jour passer par le chemin,
Nu, courbé, frissonnant, comme au vent tremble l’herbe,
Sous l’exécration de tout le genre humain ! »
(Victor Hugo, Les Châtiments, livre IV)
[5] Humain, trop humain, t.1, aporie no 380
[6] Hannah Arendt, The Human Condition § 33, University of Chicago Press, 1958.
[7] Jacques Derrida, Foi et savoir, «Le siècle et le pardon», éd. du Seuil, 2000, pp. 103-133
